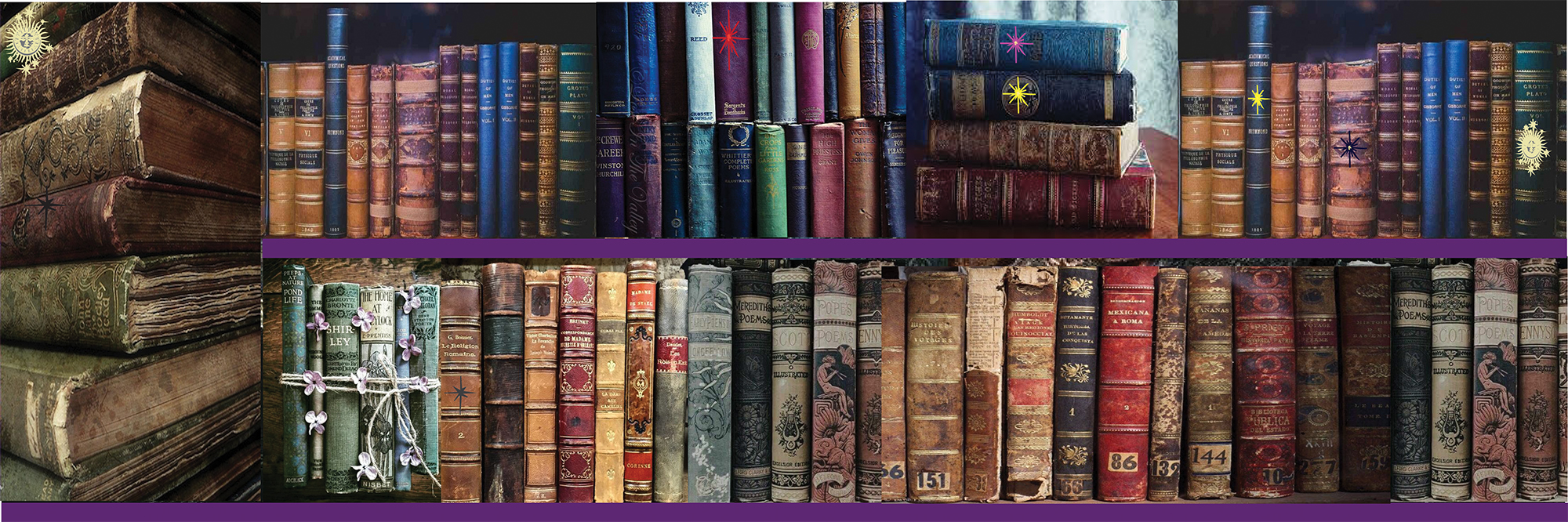غلاف وتعريف ومقدمة كتاب “الهندوسية وأثرها في الفكر: دراسة في فكر ميخائيل نعيمه”/ تأليف لويس صليبا
المؤلّف/Author : أ د. لويس صليبا Pr Lwiis Saliba
مستهند وأستاذ في الدراسات الإسلامية والأديان المقارنة
عنـوان الكتاب : الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني
دراسة في فكر ميخائيل نعيمه.
السلسلة : أديان الهند وأثرها في المشرق وأرض الإسلام3
Hinduism and its impact on the Lebaneese thought: Title
study on the thought of Mikhail Naimy
عدد الصفحات : 440ص
سنة النشر : طبعة ثانية2018 ، ط1: 2018
الـنـاشــــــر : دار ومكتبة بيبليون
طريق الفرير – حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس ، لبنان
ت: 540256/09-خليوي: 03/847633 ف: 546736/09
Byblion1@gmail.com www.DarByblion.com
2018©- جميع الحقوق محفوظة. يمنع تصوير هذا الكتاب، كما يمنع وضعه للتحميل على الإنترنت تحت طائلة الملاحقة القانونية
ديباجة الكتاب
مدخل إلى بحوثه وطروحاته
ما كان مقدّراً لهذه الدراسة أن يستغرق العمل فيها ويطول ، فيحجب ظهورها إلى هذا الحدّ. فقد عمل الباحث، أي كاتب هذه السطور، عليها بالتزامن ومباشرة بعد انتهائه من كتابه عن جبران. ([1]) ولكن انشغالاته الجامعية وانكبابه على بحوث أخرى اضطّرته إلى كتابتها على دفعات ثلاث، وفي حقبة زمنية تخطّت السنوات الثلاث. أياً يكن، فالمهمّ أنها جهزت اليوم، وبعد طول عمل وانتظار، وباتت تستحقّ أن تقدّم إلى القارئ، وعساها تلقى بعضاً من اهتمامه.
ولا تدّعي هذه الدراسة أنها أطروحة متكاملة في الأثر الهندوسي في الفكر اللبناني، ولا سيما في فكر ناسك الشخروب والأديب المسكوني ميخائيل نعيمه، بيد أنها مدخل إلى بحث أكاديمي معمّق في الموضوع. فهي تشير إشارات واضحة، وتقدّم أمثلة مقارنة وبيّنات على المصادر الهندية لنتاج مؤلف مرداد ومنظومته الفكرية عموماً.
ورغم تعدّد البحوث النعيمية، فهذا الجانب، أي الأثر الهندوي الحاسم والواضح، بقي مغفلاً، كما كان شأنه في الدراسات الجبرانية، أما السبب فإيّاه: فما من كاتب واحد متخصّص في الفلسفة الهندية واليوغا تطوّع لخوض غمار هذا البحث. وبحث كهذا يتطلّب أقلّه تخصّصاً في حقلين مختلفين ومتباينين: 1-أديان الهند، و 2-أدب المهجر. وأين تجد مستهنداً ملمّاً بأدب المهجر؟! والمستهندون أساساً بضاعة نادرة في العالمين العربي والإسلامي!
كلّ هذه العوامل، وغيرها، دفعت الباحث إلى الغوص في هذا الموضوع. وبديهيّ أن يكون بين بنية هذه الدراسة، وتلك التي تناولت الأثر الهندوي في جبران وجه شبه واضح، فهي مثلها مقسّمة إلى ثلاثة أبواب سيلي الحديث عنها. والأثر الهندوي في الفكر اللبناني يجسّده ثلاثة، أو بالحري أربعة مفكّرين: جبران خليل جبران (1883-1931)، ميخائيل نعيمه (1889-1988)، كمال جنبلاط (1917-1977)، والمستهند المرجع روبير كفوري مؤسّس حلقة الدراسات الهندية. الأول خُصّ بكتاب، والرابع دُرست مساهماته في عدد من المؤلّفات المذكورة في الهامش([2])([3])([4]) والثالث سيكون مدار دراسة تصدر قريباً.([5]) أما الثاني، فهو موضوع هذا المصنّف، ومن هنا العنوان: “الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني”، فليس القصد التعميم انطلاقاً من حالة خاصّة، أي الفكر النعيميّ، وإنما الإشارة إلى أنه بدراسة هذه الحالة يستكمل الباحث تقصّي الأثر الهندوسي في مجمل الفكر اللبناني عبر المفكّرين اللبنانيين الأربعة الذين تجلّى فيهم هذا الأثر بأبهى صوره.
ماذا الآن في أبواب هذه الدراسة وفصولها؟
الباب الأول (ب1): “نعيمه في سيرته وتأثراته الهندوسية” يأتي بمثابة مدخل إلى عالم المفكّر، وإلى موضوع البحث: كيف عرف ناسك الشخروب الهندوسية واليوغا، والفكر الهندي عموماً، وكيف جسّد تأثير كلّ ذلك في سيرته وأدبه؟
وفي الفصل الأول ب1/ف1: “نعيمه طريقاً إلى بوذا” يروي الباحث تجربته الأولى والمبكرة مع النعيميّة، وما جسّدت من أثر هندويّ. كيف كان نشيد “وجه بوذا” لناسك الشخروب طريقاً له لاكتشاف بوذا والبوذية! وهذا الاكتشاف هو الذي دفعه في النهاية للمضي قدماً في هذه الدراسة. النشيد كان الباحث، ولا يزال، يعتبره من أجمل ما كُتب في العربية. أما قصة تفاعله مع هذا النصّ فيتبسّط في سردها في هذا الفصل بتفاصيلها. “العلم في الصغر كالنقش في الحجر” يقول المثل العربي، لذا بقي النشيد النعيمي الذي يسبّح بفضائل بوذا ومناقبه راسخاً في وجدانه، ودفعه لاكتشاف سيرة المغبوط وتعاليمه، وكذلك للإبحار في عالم صاحب الأرقش ونتاجه، وما الدراسة هذه سوى محصّلة لهذين العاملين. نقطة البداية إذاً علاقة ودّ بين الباحث والأديب المسكوني الذي يدرس نتاجه. ولكن ذلك لا يعني بتاتاً أن تكون الدراسة قصيدة مدح لهذا الأخير. فالبحث الأكاديمي ليس تقريظاً، وعبارات الثناء والتبخير غير مقبولة في أطروحة جامعية. ولكن هذا البحث ليس بالمقابل ذمّاً ولا هجاءً ولا تهشيماً وتفنيداً كيدياً ينقّب عن صغائر النقائص ويكبّرها كاريكاتورياً ويضعها في الواجهة. والودّ أمرٌ ضروري، وخير معدّ للحياد الإيجابي طبقاً لتعبير جواهر لال نهرو الوارد في آخر فصل من هذه الدراسة (ب3/ف3). ولعلّ في الحياد الإيجابي يكمن سرّ نجاح أيّ بحث أو دراسة. والباحث، من ناحيته، وفي سريرته، يقف موقفاً إيجابياً من موضوع بحثه، ولا سيما من الشخصية التي يبحث في نتاجها. إنه يقدّر المفكّر موضوع البحث، من دون أن يفرط في التقدير أو يغالي. وهذا الموقف الداخلي يتيح له أن يبصر ويستبصر في كلّ جميل ومبتكر ومرهف عنده، من دون أن يغفل أو يعمى عن رؤية التقليد والاتّباعية والمحاكاة والتناصّ حيث يجب.
والفصل الثاني ب1/ف2: “نعيمه حياةٌ بين الأدب والعزوبية”، قد يجده القارئ تقليدياً، فمن المألوف عرض سيرة أي مفكّر أو أديب قبل المباشرة بدراسة نتاجه. بيد أن الباحث تحاشى سرداً كلاسيكياً تقليدياً للسيرة. واكتفى بالتوقّف عند مشاهد وأحداث محورية منها كان لها أثر مباشر في ناسك الشخروب وفكره، ولا سيما في موضوع الدراسة. فموقفه من المرأة وعلاقاته النسائية، مثلاً، كلّ ذلك يستوحي نذر العفّة براهماشاريا Brahmacharia في اليوغا. ([6]) لكأنه يوغيّ نذر العزوبية بل البتولية، وهو يؤكّد ذلك بطريقة أو بأخرى. فإلى أي مدى كان صادقاً في عفّته هذه؟ شكّك عدد من الباحثين في سيرته في زعمه هذا! لا سيما وأن مؤلف مرداد حاسب زميله جبران على كلّ شاردة وواردة في علاقاته النسائية. ولكن ليست الدراسة بحثاً مقارناً بين سيرتين، ولا يتّسع مجالها لمحاسبة الأديب المسكوني على ما كتبه في زميله. أما زعمه عن عفّته في علاقاته ابتداءً من الأربعين، فيصعب عدم الأخذ به، لا سيما وأن ما من أمر كان يجبره على الالتزام بهذه العفّة. لقد وعى ناسك الشخروب ببساطة أهمّية نذر العفة في اليوغا، ودوره الأساسي في الحفاظ على الطاقة الروحيّة والفكرية للإنسان بما يتيح له تشغيلها واستخدامها في أمور أخرى، وبالأخصّ بما نذر نعيمه نفسه وحياته له: أي الكلمة.
أما مهرجان تكريم نعيمه، فكان حدثاً ثقافياً استثنائياً، بل هو أبرز حدث ثقافي في تاريخ لبنان المعاصر، ومن هنا تسليط بعض الأضواء عليه.
ومشهد نعيمه في الحرب اللبنانية يكشف جوانب مهمّة من شخصيّته وثوابت فكره: مثل جدلية علاقته بمفكّر هندويّ آخر هو كمال جنبلاط، وهو موضوع سيكون مدار بحث في مؤلّف مستقلّ أشيرَ إليه. أما عزيمته ورباطة جأشه أيام القصف، ورفضه النزول إلى الملجأ، فأمور لا تُستغرب من يوغيّ لاعنفي من طرازه.
ويتوقّف ب1/ف2 عند نعيمه في حياته اليومية والروتينية. ماذا كان يحلو له أن يفعل كلّ يوم؟ «كان يتأمّل في الطبيعة ويتنفّس كلّ صباح» تقول ابنة أخيه ميّ. أي أن للممارسات اليوغيّة حيّزاً مهمّاً في روتينه اليوميّ. والتأمّل وطرق التنفّس وتقنيّاته من أبرز ما تعلّمه اليوغا وتشدّد على ممارسته.
وتشير هذه الفقرة من ب1/ف2 أيضاً إلى طول أناة ناسك الشخروب…وإلى عصبيّته كذلك.
أمّا الوقفة الطويلة عند اليوم الأخير من حياته، فلها ما يبرّرها: كيفيّة وفاة المرء تعكس طريقة حياته. هذا ما تعلّمه اليوغا. فغالباً ما يكرّر الإنسان في آخر يوم له ما كان يفعله دوماً في حياته، أو أقرب أفعاله إلى قلبه: إنها حال نعيمه مؤلّف “اليوم الأخير”، صلّى وتأمّل وقرأ وكتب في يومه الأخير، وشكر ابنة أخيه على عنايتها، كما كان يفعل كلّ يوم. عاش بهدوء، ورحل بهدوء. أدب الحياة هو أدب الوفاة، يقولون([7])([8])، أي أن عمرنا بأسره استعداد للحظة الوفاة، فهي تحدّد المسار. ووفاة الأديب المسكوني نعيمه من منظور يوغيّ تعني أنه عموماً أحسن أدب الحياة، فجاءت وفاته سلامية هادئة تعكس ما عاش في حياته من هدوء وسكون، وترمز إلى السكون الذي رحل إليه.
وينتهي ب1/ف2 بجدول مفصّل لأبرز أحداث حياة ناسك الشخروب وفق تسلسلها الزمني سنة بعد سنة، مع لحظ تواريخ صدور الطبعات الأولى من كلّ كتبه، وكذلك ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.
والفصل الثالث ب1/ف3: “التيوزوفية والتلفيقة الهندوسية-البوذية”. سبق للباحث أن عرض في دراسته عن جبران([9]) مبادئ هذه الجمعية، وتاريخها وعقائدها. أما هنا فهو يقتصر على ما لم يُعرض هناك، لا سيما ما كان له أثر مباشر في أدب نعيمه ومنظومته الفكرية العامّة. ويعرّف ب1/ف3 عموماً بالتيّارات الباطنية Esotériques والإخفائية Occultistes، والأرواحية Spiritistes. ويتوقّف عند التلفيقة التي نسجتها التيوزوفية من العقائد الهندوسية والبوذية ممّا كان له أثر حاسم في فكر نعيمه. فبوذا التيوزوفية هو بوذا الهندوسية التي قامت بحركة التفاف على المغبوط وإصلاحه أفرغت تعليمه من أبرز ميّزاته: أي إنكاره لوجود الروح والخالق. وهذا ما سيكرّره نعيمه عن بوذا. والمفهوم الشخروبي للنيرفانا مفهوم هندوسي/تيوزوفي بعيد عن نيرفانا بوذا والبوذية، إن لم يكن نقيضاً لها.
والفصل الرابع: ب1/ف4: “نعيمه والتيوزوفية”، يورد نصّ نعيمه في حكاية عمره “سبعون”، والذي روى فيه كيف تعرّف إلى التيوزوفية وعقائدها، ويقرأه قراءة نقدية، ويفنّده، ويبيّن التمويه الذي أحاط بالكثير من تفاصيله. ثمّ يورد نصّاً آخر متأخّر لنعيمه يروي الحادثة عينها مع اختلاف بيّن في التفاصيل، ويقارن بين الروايتين النعيميّتين ويستخلص. فيُظهر أن هدف ناسك الشخروب من روايته الأولى والتي أخذ بها دارسوه على علّاتها، ومن دون أي نقد ولا تفنيد، هو فصل عقيدته التقمّصية عن أي تأثير جبرانيّ، وهو أمر يجانب الواقع التاريخيّ والصواب.
والباب الثاني: “أديان الهند في فكر نعيمه وبحوث دارسيه” يدخل في صلب الموضوع.
والفصل الأول ب2/ف1: “الأثر الهندوسي في بحوث الدارسين”، يُجري مسحاً شاملاً للدراسات النعيمية، لا سيما ما تناول منها التأثير الهندوسي، أو بالحري أشار إليه.
وأول من ذكر هذا التأثير كان الأديب الناقد توفيق يوسف عوّاد، وإشارته كانت واضحة، بيد أنها عابرة. ومثلها إشارة ثريا ملحس. ويتوقّف الفصل عند تقييم حكماء الهند لمرداد، ولا سيما منهم أوشو راجنيش وسوامي شيدانندا.
أما عيسى الناعوري، فأهمّية مساهمته في هذا المجال تعود إلى ربط التقمّص النعيميّ حكماً بالتقمّص الجبراني، وأخذ الأول عن الثاني. ولا يبدو أنه قد جانب الصواب في طرحه هذا.
ويبقى أن أول من درس الأثر الهندويّ في النعيميّة دراسة نصّية هو الأديب والشاعر المهجري وديع الخوري. فقد أخذ قصائد ومقطوعات من “همس الجفون” لنعيمه، وقارنها بأناشيد من الأوبانيشاد، وأظهر التناصّ والتأثر المباشر. ويستعيد ب2/ف1 كل مقارنات الخوري، ويقيّمها. فهي عموماً دقيقة تقرن الفرضية بالبيّنة من النصوص المقارنة. وهي الأولى، وشبه الوحيدة، السابقة لهذه الدراسة. وحديث الخوري عن المصادر الجاينية لمرداد في محلّه. ولكنه مقتضب ويحتاج إلى المزيد من التوضيح والتحليل، لذا يتبسّط ب2/ف1 في تعريف الجاينية: تاريخاً وعقائد وميّزات لتسهيل المقارنة بينها وبين تعاليم مرداد.
أما كعدي فرهود كعدي فلم يفعل، في هذا المجال، سوى أنه استعاد حرفياً فرضيات الخوري ومقارناته. والبحث يفنّد العديد من نقداته، ويُظهر أن نقده المزعوم يحرّكه الحسد والخلافات العائلية بين آل نعيمه وآل كعدي.
ويتوقّف البحث عند دراسة د. محمد شيّا، ويفنّد عدداً من طروحاتها، ويُظهر ما شابها من نواقص في مجال الأثر الهندوي في النعيميّة وخلطها بين الفلسفتين الهندية والصينية.
ثم يتناول ب2/ف1 من انتقد التقمّص النعيميّ. فبعضهم فعل ذلك من منطلق إيديولوجي قومي مثل سليمان كتاني القومي السوري. والبعض الآخر استناداً إلى عقيدته الإسلامية كالبالحث المصري صابر عبدالدايم. وثالث من منطلق عقيدته المسيحية كالراهبة ريموند قبعين. وكلّها منطلقات ذاتيّة غير محايدة، تشوّه الطابع الأكاديمي لأي دراسة. أفلا يمكن لباحث أن يدرس عقيدة مفكّر ومنظومته الفكرية من دون أن يحشر عقيدته الشخصية في الموضوع ويتبسّط في الدفاع عنها وتفضيلها على عقيدة الكاتب موضوع دراسته؟! إنه تحدّ ورهان قلّما نجح الباحثون العرب في مجابهته.
ويخلص ب2/ف1 إلى أن المؤثرات الهندوية في النعيمية لما تزل غابة عذراء. فنعيمه أشار مرة واحدة إلى مصدر من مصادر فكره: إدموند هولمز. والغريب أن أحداً من الدارسين لم يلتقط هذه الإشارة، ولم ينتبه إليها، رغم أن الأديب المسكوني لا يفعل سوى أنه يكرّر آراء هولمز التيوزوفية في المسيح وفي وبوذا وفي وحدة الوجود والحلولية Pantheism وغير ذلك!!
والفصل الثاني ب2/ف2: “العقائد الهندية في نصوص نعيمه”، يبيّن بمجمله أن المنظومة الفكرية النعيمية استمدّت أكثر حجارتها، إن لم يكن كلّها، من المقلع الهنديّ. فأركان الفكر النعيميّ: التقمّص والقانون الكارميّ والنظام الكونيّ، والذات الفردية والذات العليا كلّها مفاهيم هندية صرفة. ويتحاشى هذا الفصل دراسة التقمّص الشخروبي، إذ سبق ودُرس مراراً. فيبدأ من المفهوم الثاني: القانون الكارميّ. وطريقة الدراسة، ومنهجها واحد: نصوص نعيمية تقارَن بنصوص من المصادر الهندية الأساسية: الأوبانيشاد، وحكماء الهند… الكارما في النعيمية وفي النصوص الهندية. ثم الأحدية عند نعيمه وعند شانكارا. وكذلك الوهم: مايا عند هذين المفكّرين: وإلى أي مدى طابقت الطروحات النعيمية فكر الفيلسوف والمتصوّف الهندي شانكارا. ونظرية نعيمه في الدين، يلقي ب2/ف2 نظرة فاحصة متأنية عليها، فيجدها مستوحاة من الفكر الهندي ومطابقة له. فهذا الفكر نقيض للإقصائية، ومفردات خطيرة مثل “كافر” و”هرطوقي” لا ترد في قاموسه، وهو ما يتبنّاه نعيمه. ولا يميّز الأديب المسكوني كذلك بين أديان سماوية وأخرى وضعية، وهذه هي الأخرى مقولة هندوية. أما بشأن الذات الفردية والذات العليا فالمصطلحات والتشابيه والصور المستخدمة واحدة: نقلها نعيمه عن الأوبانيشاد وغيرها وعبّر عنها بأسلوبه، كما يتبيّن من مقارنة النصوص. والعين الثالثة، والتي يتكرّر ذكرها وشرحها مراراً في النصوص النعيمية، مفهوم يوغيّ هندوسي محض، ولا يخفي ناسك الشخروب مصدره الهندي في الحديث عنها. ويتوقّف ب2/ف2 عند يوغا مؤلف مرداد: إنها اليوغا الفكرية، أو الراجا يوغا، كما يوضح هو نفسه. وتنفي اليوغا أي وجود للشيطان، وتعتبره مجرّد مخلوق ذهني افتراضي، وهو ما يكرّره صاحب الأرقش مراراً في مؤلّفاته. وناسك الشخروب نباتيّ يرفض قتل الحيوان واستهلاك لحمه، وهذا مبدأ هندي أساسي، وركن فلسفة اللاعنف الغاندية. والخلاصة فالنعيمية فلسفة هندوية الطابع والطروحات والمفاهيم والمصطلحات، وحتى الصور والتشابيه، ولا يمكن فقهها بمعزل عن مصدرها الرئيس هذا.
ويواصل الباب الثالث والأخير من الدراسة: “وجوه هندية طبعت النعيمية” الدراسة والمقارنة بين نصوص الأديب المسكوني والنصوص الهندوية. ولكن من زاوية معيّنة، إذ اختار شخصيات هندية قديمة ومعاصرة وسمت فكر مؤلف مرداد بطابعها. إنها وجوه ثلاثة كان لها أثر حاسم في نتاج نعيمه وفكره وفلسفته في الحياة.
والفصل الأول: ب3/ف1، يدرس وجه بوذا في النعيمية ومدى مطابقته واختلافه عن بوذا الذي عرفته البوذية. فيرى أن صاحب الأرقش تتلمذ على المغبوط، ولكنّه ألبس غوتاما ثوباً هندوسياً خلعه سيدهارتا مذ بدأ بشارته. بوذا كاتب سبعون هو بوذا التيوزوفية في تلفيقها بين الهندوسية والبوذية. ويشرح هذا الفصل في المتن، ولا سيما في الحواشي، أبرز المفاهيم والعقائد البوذية، ويبيّن الفروقات بينها وبين ما نسبته الهندوسية والتيوزوفية ومن بعدهما وعلى طريقتهما النعيمية إلى بوذا. أياً يكن، فأثر المغبوط واضح في الأديب المسكوني، وفي شخصيات رواياته. فسكوت الأرقش مثلاً، نسخة عن صمت بوذا.
والفصل الثاني، ب3/ف2: “غاندي معلّم ثانٍ لنعيمه”. بين غاندي والأديب المسكوني نقاط مشتركة عديدة وعميقة. فكلاهما تتلمذ على بوذا وتولستوي. وفي لاعنف ناسك الشخروب ونباتيّته وكرهه للحروب نفحة غاندية واضحة. ويدرس هذا الفصل نصّاً نعيميّاً في رسول اللاعنف، ويقرأه قراءة نقدية تفنيدية: أين أصاب مؤلف مرداد في تحليله لشخصية الماهاتما، وأين طاش سهمه؟ والأهمّ من ذلك ما هي المعالم الغاندية في فكره؟ وأين نجدها؟ فزعيم الهند معلّم ثانٍ لناسك الشخروب في مدرسته تلقّن مبادئ اللاعنف، وأيقن أن تحرير الشعوب والأوطان لا يستلزم كفاحاً عنيفاً، بل هو ممكن ومتاح بوسائل محض سلمية، وهنا يكمن سرّ المعجزة التي اجترحها هذا الفقير النصف عارٍ، كما لُقّب غاندي. والمعجزة الغاندية التي يتوقّف مؤلف مرداد مراراً عندها، من شأنها أن تتكرّر لو حسن استلهامها، وعلى الشعوب العربية وغيرها أن نستوحي من مسيرة غاندي إذا شاءت تحرّراً راقياً وسلمياً من ربقة الاستعمار والاستعباد.
والفصل الثالث والأخير ب3/ف3: “نهرو الحاكم الحكيم”. ترك لنا صاحب الأرقش نصّاً عن رئيس الوزراء الهندي نهرو حوى أركان المنظومة الفكرية النعيمية. فنهرو والأديب المسكوني كلاهما تتلمذا على بوذا وغاندي. وما التشابه في أفكارهما، والتطابق في نظراتهما لأكثر الأمور سوى دليل على وحدة المصادر التي نهلا منها. ونهرو حاكم مثالي و مفضال لم يجد مؤلف الأرقش مثيلاً له بين أشباهه ومعاصريه. وهو رائد الحياد الإيجابي الذي يدعو كاتب سبعون بدوره إليه. ويقارن هذا الفصل بين نصوص نعيمية وأخرى لنهرو، فيجد أوجه شبه وتوافقاً في الآراء والمواقف من قضايا العصر، ومن مسائل الحياة والموت. ولا غروى من ذلك، فالمدرسة واحدة، وكلاهما تتلمذا فيها. وحتى الصور والتشابيه المستخدمة هي إيّاها أحياناً عند المفكّريَن: مثل تشبيه البشرية بالجسد الواحد، وهي صورة ترد مراراً في الكتابات الهندية المقدّسة، وعنها أخذ كلا المفكّرين. وأوجه الشبه العديدة هذه بين الكاتبين هي لوحدها بالغة الدلالة على عمق الأثر الهندي في النعيمية.
أما خاتمة الدراسة، فاختارت نصّاً نعيمياً ختم به ناسك الشخروب مسيرته الأدبية والفكرية، وكان من أواخر ما دبّجت يراعه. إنه خطابه في القصر الجمهوري في بعبدا في ختام مهرجانه التكريمي. وفي هذا الخطاب لخّص الأديب المسكوني فلسفته ونظرته إلى الحياة، فإذا هي، وكما يبيّن تحليل هذه الخطبة، فلسفة هندية بمفاهيما ومصطلحاتها وعقائدها. إنها خطبة قُدّت أكثر حجارتها من المقلع الهندي. وكما كانت خاتمة حياة فكرية وأدبية حافلة شغلت الأوساط المثقفة ردحاً طويلاً من الزمن، فقد اختيرت خاتمة لهذه الدراسة لأنها تؤكّد مقولتها الأساسية: النعيمية فلسفة هندية بامتياز: مفاهيماً، ومصطلحات وعقائد ورؤى، وليس في هذا الأمر ما يضيرها، فهي بذلك أثبتت أنها فلسفة الإنسان، كلّ إنسان وكلّ الإنسان في هذا العصر وفي كلّ عصر.
ولا بدّ من كلمة في الهوامش والحواشي العديدة، وبعضها يسهب في الشرح. والباحث يجتهد دوماً أن يتجنّب فيها الإفراط والتفريط في آن. ومثل على ذلك الحاشية الطويلة التي تعرّف بالجانيّة (ب2/ف1). فهذه الديانة الهندية مصدر أساسي من مصادر النعيمية، وكان لها أثر واضح في كتاب مرداد. بيد أن ما هو متوفّر عنها في المكتبة العربية ضحل وملتبس أو غير محايد، وهذا ما حدا بالباحث إلى التعريف عنها بشيء من التبسّط والإسهاب. فمن دون تعريف مستوفٍ كهذا يُشكل، بل يصعب، على القارئ إدراك ما كان لها من أثر في فكر ناسك الشخروب. وما قيل عن هذه الحاشية هنا ينسحب على أكثر الحواشي الأخرى، فمصطلحات ومفاهيم مثل التانترا والبرهمن والأتمن والسمسارا، والعناصر الخمسة: سكندها تحتاج إلى تعريف وافٍ لفهمها، لا سيما وأن تعريفاً كهذا لن يجده القارئ، في الغالب، في المكتبة العربية. وقد نُقلت هذه التعريفات عن مراجع أجنبية متخصّصة في الدراسات الهندية وعلوم الأديان، مثل قاموس الأديان بإشراف الكاردينال Poupard، المذكور في المراجع، وغيره.
أما الباحثون النعيميّون، فلم يميّز الكاتب بينهم من ناحية التعريف، بل عامل الكلّ على قدم المساواة، ولم يفرّق بين من قيّم مساهمته في الدراسات النعيميّة وبين من فنّدها وانتقدها.
وقد يستغرب البعض نقداته لبعض أفكار ناسك الشخروب ومواقفه وأسلوبه. والردّ البسيط والمفحم على ذلك، هو القاعدة التي طرحها نعيمه نفسه في رسالة ونصيحة لابن أخيه ودارسه نديم، إذ قال له:«لا يخطر لك في بال أنك تسيء إليّ بقليل، أو بكثير، إذا خالفتني في رأي. ولا أتمنّى، ولا أرضى، أن تتنازل إكراماً لي، أو لغيري، عن أي رأي تحسبه صواباً»([10])
وصداقة الحقّ، طبقاً للقاعدة الأرسطية المعروفة، خير صداقة وأبقاها.
Q.J.C.S.T.B. ([11])
باريس في 29/06/2017
[1] -صليبا، د. لويس، أديان الهند وأثرها في جبران قراءة جديدة لأدب نابغة المهجر، تقديم د. بيتسا استيفانو، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2015.
[2] -صليبا، د. لويس، أقدم كتاب في العالم ريك ڤيدا دراسة ترجمة وتعليقات، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط4، 2016، ب4/ف4: إسهامات حلقة الدراسات الهندية، ص252-253.
[3] -صليبا، د. لويس، اليوغا في المسيحية دراسة مقارنة بين تصوّفين، تقديم د. بيتسا استيفانو، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2016، كفوري ودراسته لتصوّف يوحنا الصليبي، ص89-91.
[4] -صليبا، د. لويس، اليوغا في الإسلام مع دراسة وتحقيق وشرح لكتاب باتنجل الهندي للبيروني، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2016، كفوري وترجمة اليوغا سوترا، ص17-19.
[5] -صليبا، أ. د. لويس، حوار الهندوسية والمسيحية والإسلام في لقاء جنبلاط ونعيمه والأب الحايك، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2018.
[6] -صليبا، لويس، أديان الهند، م. س، ص201-205.
[7] -صليبا، د. لويس، مقامات الصمت محاولات وأبحاث في الصمت والتصوّف واليوغا، تقديم المستشرق بيير لوري، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2016، ب1، أدب الحياة أدب الوفاة، ص79-86.
[8] -صليبا، د. لويس، جدلية الحضور والغياب بحوث ومحاولات في التجربة الصوفية والحضرة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2014، ب1/ف2: أدب الوفاة ورحيل المتوفّين، ص29-37.
[9] -صليبا، لويس، أديان الهند، م. س، ب1/ف2: التيوزوفية مألفة هندوسية-بوذية، ص85-106.
[10] -نعيمه، م. ك، م. س، ج8، الرسائل، ص453.
[11] –
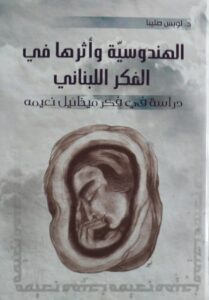
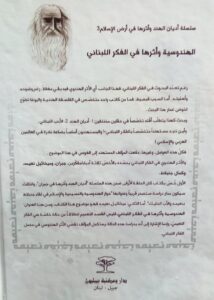
نعيمه/غلاف خلفي
سلسلة أديان الهند وأثرها في أرض الإسلام3
الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني
رغم تعدّد البحوث في الفكر اللبناني، فهذا الجانب، أي الأثر الهندوي فيه بقي مغفلاً، رغم وضوحه وأهمّيته. أما السبب فبسيط: فما من كاتب واحد متخصّص في الفلسفة الهندية واليوغا تطوّع لخوض غمار هذا البحث. وبحث كهذا يتطلّب أقّله تخصّصاً في حقلين مختلفين: 1-أديان الهند. 2-الأدب اللبناني. وأين تجد مستهنداً متخصّصاً بالفكر اللبناني؟! والمستهندون أساساً بضاعة نادرة في العالمين العربي والإسلامي!
فكلّ هذه العوامل، وغيرها، دفعت المؤلف المستهند إلى الغوص في هذا الموضوع. والأثر الهندوي في الفكر اللبناني يجسّده بالأخصّ ثلاثة أدباء/مفكّرين: جبران، وميخائيل نعيمه، وكمال جنبلاط.
الأول خُصّ بكتاب كان الحلقة الأولى ضمن هذه السلسلة “أديان الهند وأثرها في جبران”، والثالث سيكون مدار دراسة ستصدر قريباً وعنوانها “حوار الهندوسية والمسيحية والإسلام في لقاء جنبلاط بنعيمه والأب الحايك”. أما الثاني: ميخائيل نعيمه فهو موضوع هذا الكتاب، ومن هنا العنوان: الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني فليس القصد التعميم انطلاقاً من حالة خاصّة هي الفكر النعيميّ، وإنما الإشارة إلى أنه بدراسة هذه الحالة يستكمل المؤلف تقصّي الأثر الهندوسي في مجمل الفكر اللبناني.
ديباجة الكتاب
مدخل إلى بحوثه وطروحاته
ما كان مقدّراً لهذه الدراسة أن يستغرق العمل فيها ويطول ، فيحجب ظهورها إلى هذا الحدّ. فقد عمل الباحث، أي كاتب هذه السطور، عليها بالتزامن ومباشرة بعد انتهائه من كتابه عن جبران. ([1]) ولكن انشغالاته الجامعية وانكبابه على بحوث أخرى اضطّرته إلى كتابتها على دفعات ثلاث، وفي حقبة زمنية تخطّت السنوات الثلاث. أياً يكن، فالمهمّ أنها جهزت اليوم، وبعد طول عمل وانتظار، وباتت تستحقّ أن تقدّم إلى القارئ، وعساها تلقى بعضاً من اهتمامه.
ولا تدّعي هذه الدراسة أنها أطروحة متكاملة في الأثر الهندوسي في الفكر اللبناني، ولا سيما في فكر ناسك الشخروب والأديب المسكوني ميخائيل نعيمه، بيد أنها مدخل إلى بحث أكاديمي معمّق في الموضوع. فهي تشير إشارات واضحة، وتقدّم أمثلة مقارنة وبيّنات على المصادر الهندية لنتاج مؤلف مرداد ومنظومته الفكرية عموماً.
ورغم تعدّد البحوث النعيمية، فهذا الجانب، أي الأثر الهندوي الحاسم والواضح، بقي مغفلاً، كما كان شأنه في الدراسات الجبرانية، أما السبب فإيّاه: فما من كاتب واحد متخصّص في الفلسفة الهندية واليوغا تطوّع لخوض غمار هذا البحث. وبحث كهذا يتطلّب أقلّه تخصّصاً في حقلين مختلفين ومتباينين: 1-أديان الهند، و 2-أدب المهجر. وأين تجد مستهنداً ملمّاً بأدب المهجر؟! والمستهندون أساساً بضاعة نادرة في العالمين العربي والإسلامي!
كلّ هذه العوامل، وغيرها، دفعت الباحث إلى الغوص في هذا الموضوع. وبديهيّ أن يكون بين بنية هذه الدراسة، وتلك التي تناولت الأثر الهندوي في جبران وجه شبه واضح، فهي مثلها مقسّمة إلى ثلاثة أبواب سيلي الحديث عنها. والأثر الهندوي في الفكر اللبناني يجسّده ثلاثة، أو بالحري أربعة مفكّرين: جبران خليل جبران (1883-1931)، ميخائيل نعيمه (1889-1988)، كمال جنبلاط (1917-1977)، والمستهند المرجع روبير كفوري مؤسّس حلقة الدراسات الهندية. الأول خُصّ بكتاب، والرابع دُرست مساهماته في عدد من المؤلّفات المذكورة في الهامش([2])([3])([4]) والثالث سيكون مدار دراسة تصدر قريباً.([5]) أما الثاني، فهو موضوع هذا المصنّف، ومن هنا العنوان: “الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني”، فليس القصد التعميم انطلاقاً من حالة خاصّة، أي الفكر النعيميّ، وإنما الإشارة إلى أنه بدراسة هذه الحالة يستكمل الباحث تقصّي الأثر الهندوسي في مجمل الفكر اللبناني عبر المفكّرين اللبنانيين الأربعة الذين تجلّى فيهم هذا الأثر بأبهى صوره.
ماذا الآن في أبواب هذه الدراسة وفصولها؟
الباب الأول (ب1): “نعيمه في سيرته وتأثراته الهندوسية” يأتي بمثابة مدخل إلى عالم المفكّر، وإلى موضوع البحث: كيف عرف ناسك الشخروب الهندوسية واليوغا، والفكر الهندي عموماً، وكيف جسّد تأثير كلّ ذلك في سيرته وأدبه؟
وفي الفصل الأول ب1/ف1: “نعيمه طريقاً إلى بوذا” يروي الباحث تجربته الأولى والمبكرة مع النعيميّة، وما جسّدت من أثر هندويّ. كيف كان نشيد “وجه بوذا” لناسك الشخروب طريقاً له لاكتشاف بوذا والبوذية! وهذا الاكتشاف هو الذي دفعه في النهاية للمضي قدماً في هذه الدراسة. النشيد كان الباحث، ولا يزال، يعتبره من أجمل ما كُتب في العربية. أما قصة تفاعله مع هذا النصّ فيتبسّط في سردها في هذا الفصل بتفاصيلها. “العلم في الصغر كالنقش في الحجر” يقول المثل العربي، لذا بقي النشيد النعيمي الذي يسبّح بفضائل بوذا ومناقبه راسخاً في وجدانه، ودفعه لاكتشاف سيرة المغبوط وتعاليمه، وكذلك للإبحار في عالم صاحب الأرقش ونتاجه، وما الدراسة هذه سوى محصّلة لهذين العاملين. نقطة البداية إذاً علاقة ودّ بين الباحث والأديب المسكوني الذي يدرس نتاجه. ولكن ذلك لا يعني بتاتاً أن تكون الدراسة قصيدة مدح لهذا الأخير. فالبحث الأكاديمي ليس تقريظاً، وعبارات الثناء والتبخير غير مقبولة في أطروحة جامعية. ولكن هذا البحث ليس بالمقابل ذمّاً ولا هجاءً ولا تهشيماً وتفنيداً كيدياً ينقّب عن صغائر النقائص ويكبّرها كاريكاتورياً ويضعها في الواجهة. والودّ أمرٌ ضروري، وخير معدّ للحياد الإيجابي طبقاً لتعبير جواهر لال نهرو الوارد في آخر فصل من هذه الدراسة (ب3/ف3). ولعلّ في الحياد الإيجابي يكمن سرّ نجاح أيّ بحث أو دراسة. والباحث، من ناحيته، وفي سريرته، يقف موقفاً إيجابياً من موضوع بحثه، ولا سيما من الشخصية التي يبحث في نتاجها. إنه يقدّر المفكّر موضوع البحث، من دون أن يفرط في التقدير أو يغالي. وهذا الموقف الداخلي يتيح له أن يبصر ويستبصر في كلّ جميل ومبتكر ومرهف عنده، من دون أن يغفل أو يعمى عن رؤية التقليد والاتّباعية والمحاكاة والتناصّ حيث يجب.
والفصل الثاني ب1/ف2: “نعيمه حياةٌ بين الأدب والعزوبية”، قد يجده القارئ تقليدياً، فمن المألوف عرض سيرة أي مفكّر أو أديب قبل المباشرة بدراسة نتاجه. بيد أن الباحث تحاشى سرداً كلاسيكياً تقليدياً للسيرة. واكتفى بالتوقّف عند مشاهد وأحداث محورية منها كان لها أثر مباشر في ناسك الشخروب وفكره، ولا سيما في موضوع الدراسة. فموقفه من المرأة وعلاقاته النسائية، مثلاً، كلّ ذلك يستوحي نذر العفّة براهماشاريا Brahmacharia في اليوغا. ([6]) لكأنه يوغيّ نذر العزوبية بل البتولية، وهو يؤكّد ذلك بطريقة أو بأخرى. فإلى أي مدى كان صادقاً في عفّته هذه؟ شكّك عدد من الباحثين في سيرته في زعمه هذا! لا سيما وأن مؤلف مرداد حاسب زميله جبران على كلّ شاردة وواردة في علاقاته النسائية. ولكن ليست الدراسة بحثاً مقارناً بين سيرتين، ولا يتّسع مجالها لمحاسبة الأديب المسكوني على ما كتبه في زميله. أما زعمه عن عفّته في علاقاته ابتداءً من الأربعين، فيصعب عدم الأخذ به، لا سيما وأن ما من أمر كان يجبره على الالتزام بهذه العفّة. لقد وعى ناسك الشخروب ببساطة أهمّية نذر العفة في اليوغا، ودوره الأساسي في الحفاظ على الطاقة الروحيّة والفكرية للإنسان بما يتيح له تشغيلها واستخدامها في أمور أخرى، وبالأخصّ بما نذر نعيمه نفسه وحياته له: أي الكلمة.
أما مهرجان تكريم نعيمه، فكان حدثاً ثقافياً استثنائياً، بل هو أبرز حدث ثقافي في تاريخ لبنان المعاصر، ومن هنا تسليط بعض الأضواء عليه.
ومشهد نعيمه في الحرب اللبنانية يكشف جوانب مهمّة من شخصيّته وثوابت فكره: مثل جدلية علاقته بمفكّر هندويّ آخر هو كمال جنبلاط، وهو موضوع سيكون مدار بحث في مؤلّف مستقلّ أشيرَ إليه. أما عزيمته ورباطة جأشه أيام القصف، ورفضه النزول إلى الملجأ، فأمور لا تُستغرب من يوغيّ لاعنفي من طرازه.
ويتوقّف ب1/ف2 عند نعيمه في حياته اليومية والروتينية. ماذا كان يحلو له أن يفعل كلّ يوم؟ «كان يتأمّل في الطبيعة ويتنفّس كلّ صباح» تقول ابنة أخيه ميّ. أي أن للممارسات اليوغيّة حيّزاً مهمّاً في روتينه اليوميّ. والتأمّل وطرق التنفّس وتقنيّاته من أبرز ما تعلّمه اليوغا وتشدّد على ممارسته.
وتشير هذه الفقرة من ب1/ف2 أيضاً إلى طول أناة ناسك الشخروب…وإلى عصبيّته كذلك.
أمّا الوقفة الطويلة عند اليوم الأخير من حياته، فلها ما يبرّرها: كيفيّة وفاة المرء تعكس طريقة حياته. هذا ما تعلّمه اليوغا. فغالباً ما يكرّر الإنسان في آخر يوم له ما كان يفعله دوماً في حياته، أو أقرب أفعاله إلى قلبه: إنها حال نعيمه مؤلّف “اليوم الأخير”، صلّى وتأمّل وقرأ وكتب في يومه الأخير، وشكر ابنة أخيه على عنايتها، كما كان يفعل كلّ يوم. عاش بهدوء، ورحل بهدوء. أدب الحياة هو أدب الوفاة، يقولون([7])([8])، أي أن عمرنا بأسره استعداد للحظة الوفاة، فهي تحدّد المسار. ووفاة الأديب المسكوني نعيمه من منظور يوغيّ تعني أنه عموماً أحسن أدب الحياة، فجاءت وفاته سلامية هادئة تعكس ما عاش في حياته من هدوء وسكون، وترمز إلى السكون الذي رحل إليه.
وينتهي ب1/ف2 بجدول مفصّل لأبرز أحداث حياة ناسك الشخروب وفق تسلسلها الزمني سنة بعد سنة، مع لحظ تواريخ صدور الطبعات الأولى من كلّ كتبه، وكذلك ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.
والفصل الثالث ب1/ف3: “التيوزوفية والتلفيقة الهندوسية-البوذية”. سبق للباحث أن عرض في دراسته عن جبران([9]) مبادئ هذه الجمعية، وتاريخها وعقائدها. أما هنا فهو يقتصر على ما لم يُعرض هناك، لا سيما ما كان له أثر مباشر في أدب نعيمه ومنظومته الفكرية العامّة. ويعرّف ب1/ف3 عموماً بالتيّارات الباطنية Esotériques والإخفائية Occultistes، والأرواحية Spiritistes. ويتوقّف عند التلفيقة التي نسجتها التيوزوفية من العقائد الهندوسية والبوذية ممّا كان له أثر حاسم في فكر نعيمه. فبوذا التيوزوفية هو بوذا الهندوسية التي قامت بحركة التفاف على المغبوط وإصلاحه أفرغت تعليمه من أبرز ميّزاته: أي إنكاره لوجود الروح والخالق. وهذا ما سيكرّره نعيمه عن بوذا. والمفهوم الشخروبي للنيرفانا مفهوم هندوسي/تيوزوفي بعيد عن نيرفانا بوذا والبوذية، إن لم يكن نقيضاً لها.
والفصل الرابع: ب1/ف4: “نعيمه والتيوزوفية”، يورد نصّ نعيمه في حكاية عمره “سبعون”، والذي روى فيه كيف تعرّف إلى التيوزوفية وعقائدها، ويقرأه قراءة نقدية، ويفنّده، ويبيّن التمويه الذي أحاط بالكثير من تفاصيله. ثمّ يورد نصّاً آخر متأخّر لنعيمه يروي الحادثة عينها مع اختلاف بيّن في التفاصيل، ويقارن بين الروايتين النعيميّتين ويستخلص. فيُظهر أن هدف ناسك الشخروب من روايته الأولى والتي أخذ بها دارسوه على علّاتها، ومن دون أي نقد ولا تفنيد، هو فصل عقيدته التقمّصية عن أي تأثير جبرانيّ، وهو أمر يجانب الواقع التاريخيّ والصواب.
والباب الثاني: “أديان الهند في فكر نعيمه وبحوث دارسيه” يدخل في صلب الموضوع.
والفصل الأول ب2/ف1: “الأثر الهندوسي في بحوث الدارسين”، يُجري مسحاً شاملاً للدراسات النعيمية، لا سيما ما تناول منها التأثير الهندوسي، أو بالحري أشار إليه.
وأول من ذكر هذا التأثير كان الأديب الناقد توفيق يوسف عوّاد، وإشارته كانت واضحة، بيد أنها عابرة. ومثلها إشارة ثريا ملحس. ويتوقّف الفصل عند تقييم حكماء الهند لمرداد، ولا سيما منهم أوشو راجنيش وسوامي شيدانندا.
أما عيسى الناعوري، فأهمّية مساهمته في هذا المجال تعود إلى ربط التقمّص النعيميّ حكماً بالتقمّص الجبراني، وأخذ الأول عن الثاني. ولا يبدو أنه قد جانب الصواب في طرحه هذا.
ويبقى أن أول من درس الأثر الهندويّ في النعيميّة دراسة نصّية هو الأديب والشاعر المهجري وديع الخوري. فقد أخذ قصائد ومقطوعات من “همس الجفون” لنعيمه، وقارنها بأناشيد من الأوبانيشاد، وأظهر التناصّ والتأثر المباشر. ويستعيد ب2/ف1 كل مقارنات الخوري، ويقيّمها. فهي عموماً دقيقة تقرن الفرضية بالبيّنة من النصوص المقارنة. وهي الأولى، وشبه الوحيدة، السابقة لهذه الدراسة. وحديث الخوري عن المصادر الجاينية لمرداد في محلّه. ولكنه مقتضب ويحتاج إلى المزيد من التوضيح والتحليل، لذا يتبسّط ب2/ف1 في تعريف الجاينية: تاريخاً وعقائد وميّزات لتسهيل المقارنة بينها وبين تعاليم مرداد.
أما كعدي فرهود كعدي فلم يفعل، في هذا المجال، سوى أنه استعاد حرفياً فرضيات الخوري ومقارناته. والبحث يفنّد العديد من نقداته، ويُظهر أن نقده المزعوم يحرّكه الحسد والخلافات العائلية بين آل نعيمه وآل كعدي.
ويتوقّف البحث عند دراسة د. محمد شيّا، ويفنّد عدداً من طروحاتها، ويُظهر ما شابها من نواقص في مجال الأثر الهندوي في النعيميّة وخلطها بين الفلسفتين الهندية والصينية.
ثم يتناول ب2/ف1 من انتقد التقمّص النعيميّ. فبعضهم فعل ذلك من منطلق إيديولوجي قومي مثل سليمان كتاني القومي السوري. والبعض الآخر استناداً إلى عقيدته الإسلامية كالبالحث المصري صابر عبدالدايم. وثالث من منطلق عقيدته المسيحية كالراهبة ريموند قبعين. وكلّها منطلقات ذاتيّة غير محايدة، تشوّه الطابع الأكاديمي لأي دراسة. أفلا يمكن لباحث أن يدرس عقيدة مفكّر ومنظومته الفكرية من دون أن يحشر عقيدته الشخصية في الموضوع ويتبسّط في الدفاع عنها وتفضيلها على عقيدة الكاتب موضوع دراسته؟! إنه تحدّ ورهان قلّما نجح الباحثون العرب في مجابهته.
ويخلص ب2/ف1 إلى أن المؤثرات الهندوية في النعيمية لما تزل غابة عذراء. فنعيمه أشار مرة واحدة إلى مصدر من مصادر فكره: إدموند هولمز. والغريب أن أحداً من الدارسين لم يلتقط هذه الإشارة، ولم ينتبه إليها، رغم أن الأديب المسكوني لا يفعل سوى أنه يكرّر آراء هولمز التيوزوفية في المسيح وفي وبوذا وفي وحدة الوجود والحلولية Pantheism وغير ذلك!!
والفصل الثاني ب2/ف2: “العقائد الهندية في نصوص نعيمه”، يبيّن بمجمله أن المنظومة الفكرية النعيمية استمدّت أكثر حجارتها، إن لم يكن كلّها، من المقلع الهنديّ. فأركان الفكر النعيميّ: التقمّص والقانون الكارميّ والنظام الكونيّ، والذات الفردية والذات العليا كلّها مفاهيم هندية صرفة. ويتحاشى هذا الفصل دراسة التقمّص الشخروبي، إذ سبق ودُرس مراراً. فيبدأ من المفهوم الثاني: القانون الكارميّ. وطريقة الدراسة، ومنهجها واحد: نصوص نعيمية تقارَن بنصوص من المصادر الهندية الأساسية: الأوبانيشاد، وحكماء الهند… الكارما في النعيمية وفي النصوص الهندية. ثم الأحدية عند نعيمه وعند شانكارا. وكذلك الوهم: مايا عند هذين المفكّرين: وإلى أي مدى طابقت الطروحات النعيمية فكر الفيلسوف والمتصوّف الهندي شانكارا. ونظرية نعيمه في الدين، يلقي ب2/ف2 نظرة فاحصة متأنية عليها، فيجدها مستوحاة من الفكر الهندي ومطابقة له. فهذا الفكر نقيض للإقصائية، ومفردات خطيرة مثل “كافر” و”هرطوقي” لا ترد في قاموسه، وهو ما يتبنّاه نعيمه. ولا يميّز الأديب المسكوني كذلك بين أديان سماوية وأخرى وضعية، وهذه هي الأخرى مقولة هندوية. أما بشأن الذات الفردية والذات العليا فالمصطلحات والتشابيه والصور المستخدمة واحدة: نقلها نعيمه عن الأوبانيشاد وغيرها وعبّر عنها بأسلوبه، كما يتبيّن من مقارنة النصوص. والعين الثالثة، والتي يتكرّر ذكرها وشرحها مراراً في النصوص النعيمية، مفهوم يوغيّ هندوسي محض، ولا يخفي ناسك الشخروب مصدره الهندي في الحديث عنها. ويتوقّف ب2/ف2 عند يوغا مؤلف مرداد: إنها اليوغا الفكرية، أو الراجا يوغا، كما يوضح هو نفسه. وتنفي اليوغا أي وجود للشيطان، وتعتبره مجرّد مخلوق ذهني افتراضي، وهو ما يكرّره صاحب الأرقش مراراً في مؤلّفاته. وناسك الشخروب نباتيّ يرفض قتل الحيوان واستهلاك لحمه، وهذا مبدأ هندي أساسي، وركن فلسفة اللاعنف الغاندية. والخلاصة فالنعيمية فلسفة هندوية الطابع والطروحات والمفاهيم والمصطلحات، وحتى الصور والتشابيه، ولا يمكن فقهها بمعزل عن مصدرها الرئيس هذا.
ويواصل الباب الثالث والأخير من الدراسة: “وجوه هندية طبعت النعيمية” الدراسة والمقارنة بين نصوص الأديب المسكوني والنصوص الهندوية. ولكن من زاوية معيّنة، إذ اختار شخصيات هندية قديمة ومعاصرة وسمت فكر مؤلف مرداد بطابعها. إنها وجوه ثلاثة كان لها أثر حاسم في نتاج نعيمه وفكره وفلسفته في الحياة.
والفصل الأول: ب3/ف1، يدرس وجه بوذا في النعيمية ومدى مطابقته واختلافه عن بوذا الذي عرفته البوذية. فيرى أن صاحب الأرقش تتلمذ على المغبوط، ولكنّه ألبس غوتاما ثوباً هندوسياً خلعه سيدهارتا مذ بدأ بشارته. بوذا كاتب سبعون هو بوذا التيوزوفية في تلفيقها بين الهندوسية والبوذية. ويشرح هذا الفصل في المتن، ولا سيما في الحواشي، أبرز المفاهيم والعقائد البوذية، ويبيّن الفروقات بينها وبين ما نسبته الهندوسية والتيوزوفية ومن بعدهما وعلى طريقتهما النعيمية إلى بوذا. أياً يكن، فأثر المغبوط واضح في الأديب المسكوني، وفي شخصيات رواياته. فسكوت الأرقش مثلاً، نسخة عن صمت بوذا.
والفصل الثاني، ب3/ف2: “غاندي معلّم ثانٍ لنعيمه”. بين غاندي والأديب المسكوني نقاط مشتركة عديدة وعميقة. فكلاهما تتلمذ على بوذا وتولستوي. وفي لاعنف ناسك الشخروب ونباتيّته وكرهه للحروب نفحة غاندية واضحة. ويدرس هذا الفصل نصّاً نعيميّاً في رسول اللاعنف، ويقرأه قراءة نقدية تفنيدية: أين أصاب مؤلف مرداد في تحليله لشخصية الماهاتما، وأين طاش سهمه؟ والأهمّ من ذلك ما هي المعالم الغاندية في فكره؟ وأين نجدها؟ فزعيم الهند معلّم ثانٍ لناسك الشخروب في مدرسته تلقّن مبادئ اللاعنف، وأيقن أن تحرير الشعوب والأوطان لا يستلزم كفاحاً عنيفاً، بل هو ممكن ومتاح بوسائل محض سلمية، وهنا يكمن سرّ المعجزة التي اجترحها هذا الفقير النصف عارٍ، كما لُقّب غاندي. والمعجزة الغاندية التي يتوقّف مؤلف مرداد مراراً عندها، من شأنها أن تتكرّر لو حسن استلهامها، وعلى الشعوب العربية وغيرها أن نستوحي من مسيرة غاندي إذا شاءت تحرّراً راقياً وسلمياً من ربقة الاستعمار والاستعباد.
والفصل الثالث والأخير ب3/ف3: “نهرو الحاكم الحكيم”. ترك لنا صاحب الأرقش نصّاً عن رئيس الوزراء الهندي نهرو حوى أركان المنظومة الفكرية النعيمية. فنهرو والأديب المسكوني كلاهما تتلمذا على بوذا وغاندي. وما التشابه في أفكارهما، والتطابق في نظراتهما لأكثر الأمور سوى دليل على وحدة المصادر التي نهلا منها. ونهرو حاكم مثالي و مفضال لم يجد مؤلف الأرقش مثيلاً له بين أشباهه ومعاصريه. وهو رائد الحياد الإيجابي الذي يدعو كاتب سبعون بدوره إليه. ويقارن هذا الفصل بين نصوص نعيمية وأخرى لنهرو، فيجد أوجه شبه وتوافقاً في الآراء والمواقف من قضايا العصر، ومن مسائل الحياة والموت. ولا غروى من ذلك، فالمدرسة واحدة، وكلاهما تتلمذا فيها. وحتى الصور والتشابيه المستخدمة هي إيّاها أحياناً عند المفكّريَن: مثل تشبيه البشرية بالجسد الواحد، وهي صورة ترد مراراً في الكتابات الهندية المقدّسة، وعنها أخذ كلا المفكّرين. وأوجه الشبه العديدة هذه بين الكاتبين هي لوحدها بالغة الدلالة على عمق الأثر الهندي في النعيمية.
أما خاتمة الدراسة، فاختارت نصّاً نعيمياً ختم به ناسك الشخروب مسيرته الأدبية والفكرية، وكان من أواخر ما دبّجت يراعه. إنه خطابه في القصر الجمهوري في بعبدا في ختام مهرجانه التكريمي. وفي هذا الخطاب لخّص الأديب المسكوني فلسفته ونظرته إلى الحياة، فإذا هي، وكما يبيّن تحليل هذه الخطبة، فلسفة هندية بمفاهيما ومصطلحاتها وعقائدها. إنها خطبة قُدّت أكثر حجارتها من المقلع الهندي. وكما كانت خاتمة حياة فكرية وأدبية حافلة شغلت الأوساط المثقفة ردحاً طويلاً من الزمن، فقد اختيرت خاتمة لهذه الدراسة لأنها تؤكّد مقولتها الأساسية: النعيمية فلسفة هندية بامتياز: مفاهيماً، ومصطلحات وعقائد ورؤى، وليس في هذا الأمر ما يضيرها، فهي بذلك أثبتت أنها فلسفة الإنسان، كلّ إنسان وكلّ الإنسان في هذا العصر وفي كلّ عصر.
ولا بدّ من كلمة في الهوامش والحواشي العديدة، وبعضها يسهب في الشرح. والباحث يجتهد دوماً أن يتجنّب فيها الإفراط والتفريط في آن. ومثل على ذلك الحاشية الطويلة التي تعرّف بالجانيّة (ب2/ف1). فهذه الديانة الهندية مصدر أساسي من مصادر النعيمية، وكان لها أثر واضح في كتاب مرداد. بيد أن ما هو متوفّر عنها في المكتبة العربية ضحل وملتبس أو غير محايد، وهذا ما حدا بالباحث إلى التعريف عنها بشيء من التبسّط والإسهاب. فمن دون تعريف مستوفٍ كهذا يُشكل، بل يصعب، على القارئ إدراك ما كان لها من أثر في فكر ناسك الشخروب. وما قيل عن هذه الحاشية هنا ينسحب على أكثر الحواشي الأخرى، فمصطلحات ومفاهيم مثل التانترا والبرهمن والأتمن والسمسارا، والعناصر الخمسة: سكندها تحتاج إلى تعريف وافٍ لفهمها، لا سيما وأن تعريفاً كهذا لن يجده القارئ، في الغالب، في المكتبة العربية. وقد نُقلت هذه التعريفات عن مراجع أجنبية متخصّصة في الدراسات الهندية وعلوم الأديان، مثل قاموس الأديان بإشراف الكاردينال Poupard، المذكور في المراجع، وغيره.
أما الباحثون النعيميّون، فلم يميّز الكاتب بينهم من ناحية التعريف، بل عامل الكلّ على قدم المساواة، ولم يفرّق بين من قيّم مساهمته في الدراسات النعيميّة وبين من فنّدها وانتقدها.
وقد يستغرب البعض نقداته لبعض أفكار ناسك الشخروب ومواقفه وأسلوبه. والردّ البسيط والمفحم على ذلك، هو القاعدة التي طرحها نعيمه نفسه في رسالة ونصيحة لابن أخيه ودارسه نديم، إذ قال له:«لا يخطر لك في بال أنك تسيء إليّ بقليل، أو بكثير، إذا خالفتني في رأي. ولا أتمنّى، ولا أرضى، أن تتنازل إكراماً لي، أو لغيري، عن أي رأي تحسبه صواباً»([10])
وصداقة الحقّ، طبقاً للقاعدة الأرسطية المعروفة، خير صداقة وأبقاها.
Q.J.C.S.T.B. ([11])
باريس في 29/06/2017
[1] -صليبا، د. لويس، أديان الهند وأثرها في جبران قراءة جديدة لأدب نابغة المهجر، تقديم د. بيتسا استيفانو، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2015.
[2] -صليبا، د. لويس، أقدم كتاب في العالم ريك ڤيدا دراسة ترجمة وتعليقات، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط4، 2016، ب4/ف4: إسهامات حلقة الدراسات الهندية، ص252-253.
[3] -صليبا، د. لويس، اليوغا في المسيحية دراسة مقارنة بين تصوّفين، تقديم د. بيتسا استيفانو، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2016، كفوري ودراسته لتصوّف يوحنا الصليبي، ص89-91.
[4] -صليبا، د. لويس، اليوغا في الإسلام مع دراسة وتحقيق وشرح لكتاب باتنجل الهندي للبيروني، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2016، كفوري وترجمة اليوغا سوترا، ص17-19.
[5] -صليبا، أ. د. لويس، حوار الهندوسية والمسيحية والإسلام في لقاء جنبلاط ونعيمه والأب الحايك، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2018.
[6] -صليبا، لويس، أديان الهند، م. س، ص201-205.
[7] -صليبا، د. لويس، مقامات الصمت محاولات وأبحاث في الصمت والتصوّف واليوغا، تقديم المستشرق بيير لوري، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2016، ب1، أدب الحياة أدب الوفاة، ص79-86.
[8] -صليبا، د. لويس، جدلية الحضور والغياب بحوث ومحاولات في التجربة الصوفية والحضرة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2014، ب1/ف2: أدب الوفاة ورحيل المتوفّين، ص29-37.
[9] -صليبا، لويس، أديان الهند، م. س، ب1/ف2: التيوزوفية مألفة هندوسية-بوذية، ص85-106.
[10] -نعيمه، م. ك، م. س، ج8، الرسائل، ص453.
 دار بيبليون
دار بيبليون