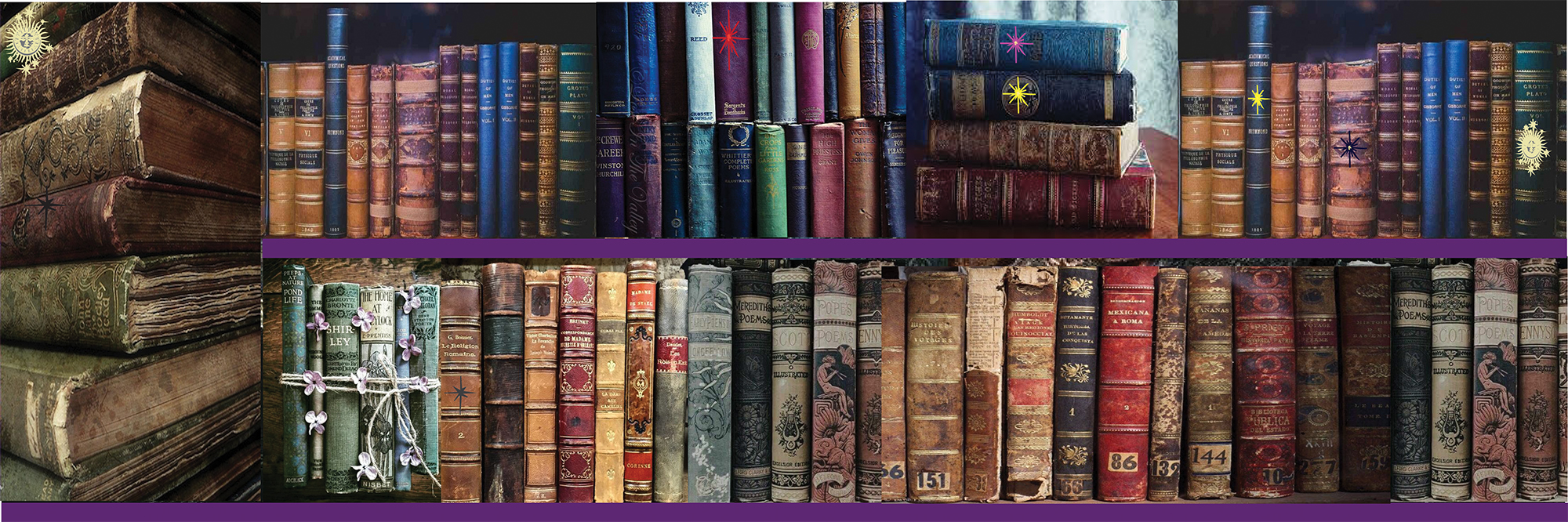مقالة للعميد الركن علي أبي ناصيف في تقييم كتاب “لبنان الكبير أم لبنان خطأ تاريخي” تأليف لويس صليبا

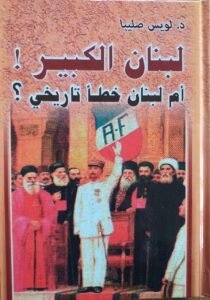
عزيزي د. لويس صليبا:
بدأتُ قراءة كتابك عن لبنان الكبير….
تعجبني المعلومات التاريخية الموثّقة التي ذكرتها في كتابك خاصّة عن المفكر يوسف السودا ومواقفه وعن البطريرك الحويك ومساعده المطران مبارك ..
وعن الصراع بين الروم وبين الموارنة…
والروم الأرثوذكس في مرجعيون وموقفهم المعارض للانضمام إلى جزّين وكلمة نصار علمية الشهيرة: رب ثلاثين ولا جزّين……
فعلاً تشوّقت أكثر لمتابعة القراءة لأني وجدت ما هو يشدّني لذلك الفيض من التفاصيل المهمّة والمعبّرة عن حقبة تاريخية حافلة بالمواقف والاستحقاقات والمحطّات السياسية والاجتماعية في لبنان ومحيطه العربي ومواقف الدول العربية المتصارعة مع تركيا آنذاك ..
جميل جداً وساتابع مطالعتي للكتاب ولمقالاتك في مجلّة الدراسات الأمنية التابعة لقوى الأمن الداخلي ….
وأعتقد أنك من المطّلعين البارزين على المرحلة الشهابية وما رافقها من محطّات لبنانياً وعربياً خاصة بعد كتابك الأخير “فؤاد شهاب ما له وما عليه”.
وفّقك الله، وبعد انتهائي من قراءة كتابك سادوّن كل انطباعاتي وأرسلها إليك بموضوعية مع تقديري سلفاً لكل ما تكتبه لأنّك واضح وصريح في تقييم أو تقويم أي مرحلة تاريخية….
واستكمالاً لما أرسلته سابقاً خطّياً عن كتابك “لبنان الكبير”
إن عنوان الكتاب يحمل السؤال/الإشكالية بحدّ ذاته فهل لبنان الكبير كان خطأً تاريخياً؟ وهل هذا الخطأ شمل كل الطوائف اللبنانية آنذاك؟ وبالتالي كان تاريخ لبنان المعاصر عبارة عن نزاعات طائفية ومذهبية انتجت توتّرات وحروب بين سكّان غير متجانسين دينياً وخصوصيات ثقافية وتجارب متنافرة (القومية اللبنانية والعروبة) في حيّز جغرافي أُطلق عليه اسم لبنان؟؟
من هنا تبدأ الحكاية، حكاية التأسيس وما سبقه من تباين في الآراء ضمن الصفّ المسيحي وضمن الصف الإسلامي كذلك، ثم ما تلاه من محاولات للتصحيح أو للتخفيف من الخسائر الناجمة عن الديمغرافيا المتغيّرة والتي وصفها المؤرّخ د.كمال الصليبي بالديمغرافيا المشاغبة…
ما لاحظته بعد قراءتي للكتاب أن الكاتب د. صليبا لم ينحاز إلى جانب موقف طائفي هنا أو موقف آخر هناك، بل تعمّق وغاص في حقيقة الظروف والخلفيّات السياسية التي رافقت مراحل تأسيس لبنان الكبير عام 1920 ثم مرحلة الاستقلال وما بعدها من تحوّلات ومتغيّرات ومطالب سياسية جديدة من هذا المكوِّن اللبناني أو من ذاك دونما أيّ جنوح أو انحياز إلى أحد من هذه المكوّنات اللبنانية….
وهذا دليل على اتباع الكاتب د. صليبا للمنهج التاريخي والموثّق للمراجع والمصادر الرسمية أو المستندة إلى وقائع، وبالتالي كان موضوعياً في مقاربة الإشكالية المطروحة وفي نتائج بحثه.
كذلك كان جريئاً في تحليلاته واستنتاجاته وصريحاً في التعبير عن آرائه دون أيّ تحفّظ. كما أنّه عمل على الاستعانة بأي وثيقة تاريخية ذات صلة، والكشف عنها بالتالي، وإبرازها لخدمة بحثه .
لذلك يمكن القول إنه انطلق كباحث وكاتب من رحم معاناة من جهة ومن خلال تأمّل طويل.
أقصد بالمعاناة أنه عاش معاناة الحرب الأهلية الطاحنة فتأمل مفكّراً في أسبابها ودواعيها وتداعياتها.
كذلك لفتني قول مهم له وأعتبره مفصلياً وهوالتالي:
لأننا فشلنا في القيام بمراجعة ذاتية وتطهير الضمير عام 1841 و1860 و1958 اشتعلت الحرب عام 1975، ويجب أن نمنع ذلك من أن يحدث مرة جديدة.
لقد لاحظتُ أيضاً أن الكاتب د. صليبا لم يسعَ في كتابه ليبيّن من كان مصيباً أو من كان مخطئاً في موقفه أو مشروعه السياسي آنذاك أي عام 1920، بل ما يهمّه هو إظهار واقعة مفادها أن جوّ التنافس والتخاصم الذي ساد أوّلاً بين الجماعتين الكاثوليكية من جهة والأرثوذكسية من جهة أخرى على مدى قرونٍ عديدة قد تراجع تراجعاً ملحوظاً منذ انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني بين الأعوام 1960…..1965، كذلك لاحظت أن د. صليبا كان متتبّعاً جيداً للأحداث التاريخية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، فربط ربطاً جيداً بين عناصر هذه الأحداث بتسلسل ممنهج ساعد في توصّله إلى نتائج بحثية موثّقة ومطابقة لواقع الأمور بدقّة وكأني به يقول إن كتابة التاريخ ليست عملاً روائياً بل هي بالأحرى تتبّعٌ دقيق ووفق أصول البحث التاريخي للوقائع والأحداث. وبالتالي اكتشاف الخيط الرفيع الذي يربط بين هذه العناصر والمحطّات التاريخية .
ولاحظتُ أيضاً أن الكاتب تجنّب باستمرار الوقوع في خطأ منهجي حرصاً منه على احترام قواعد ومناهج علم التاريخ وعلى الأمانة العلمية.
وإيماناً منه بأن التاريخ هو علم قائم بذاته في خدمة الإنسان والمجتمع والحقيقة وليس الأهواء الشخصية، وبالتالي فإن أهمّية التاريخ كعلم تبقى في ما يقدّمه هذا العلم الواسع للإنسان المعاصر من عِبر ودروس وفوائد، لأن تطوّرَ المجتمعات مرتبطٌ إرتباطاً وثيقاً بتراكم التجارب وخبرات الحياة وهنا أتذكّر قول أحد المفكّرين (كارل ماركس): التراكم الكمّي يؤدّي إلى تغيير نوعي….طبعاً إذا صحّت وصدقت عملية نقل وتجميع التجارب والوقائع والبناء عليها…
أما ما قرأتُه وتوقّفتُ عنده ملياً في الكتاب، فكان الفصل الأخير المنفصل عن موضوع لبنان الكبير حيث أضاف د. صليبا للكتاب في الصفحات الأخيرة مضامين محاضرة له في ندوة العيش المشترك في جبيل عنوانها:
” جبيل مدينة السلم الأهلي والتنوّع الثقافي والديني”
أوّل ما توقّفتُ عنده في هذه المحاضرة ما لخّصه د.صليبا من رأي سليم في جبيل عبارة واحدة وهي:
أنا ابنها المولود فيها، وفيها يعيش: أقول: جبيل مدينة السلم الأهلي والتنوّع الثقافي والديني. ومستعرضاً عناوين الأزمنة الثلاثة:
1-الزمن القديم الفينيقي والأغريقي والروماني
2-العصر الوسيط لا سيما في الحروب الصليبية
3-الزمن الحديث والمعاصر
لقد استعان الكاتب بالمستشرق المؤرخ الأب هنري لامنس الذي قال: كانت جبيل مدينة الفينيقيين المقدّسة التي يحجّون إليها كما يحجّ إلى المزارات الشهيرة…ويقول المؤرّخ جواد بولس: كانت جبيل والمنطقة المجاورة لها من أكبر مراكز العبادة في الشرق جميعاً…
هنا أشار الكاتب إلى أن غايته من تبيان هذا الطابع الديني المقدس هي إظهار حقيقة تاريخية وهي أنه منذ البدء ساهم هذا الطابع الديني في إرساء سلام فعلي نعِمَت به المدينة زمناً طويلاً مضيفاً هذا التوصيف الجميل: “المدينة المقدّسة حرم وفق التقاليد الساميّة” أي أن لها حرمة والحرب فيها حرام “….
ما أجمل وأدقّ هذه العبارة الحاسمة والحازمة : الحرب فيها حرام….الحرب فيها حرام….إنها أحدى أهمّ الثوابت الجبيلية والتي نحن بها ملتزمون..نحن الجبيليين … …مسلمين ومسيحيين …
وختاماً لا بدّ لي أن أتوقّف باهتمام واحترام أمام هذه الوصية الأساس من وصايا أجدادنا التى أوردها د. صليبا في سياق مداخلته عن جبيل وعيشها الواحد الكريم .
كذلك أنوّه بهذه التقاليد المسيحية والإسلامية التي يتوارثها أهل جبيل جيلاً بعد جيل، مؤمنين أنها أمانة الأجداد وإرثهم الغالي والكنز النفيس الذي اختصره ب:
تعدّدية وسلام….في حضن الدولة الضامنة وحدها لهذا العيش الحضاري…..
عسانا نعمل جميعاً على صونها ونقلها إلى الأبناء والأحفاد.
العميد الركن علي أبي ناصيف
بيروت في 25 أذار 2025
 دار بيبليون
دار بيبليون