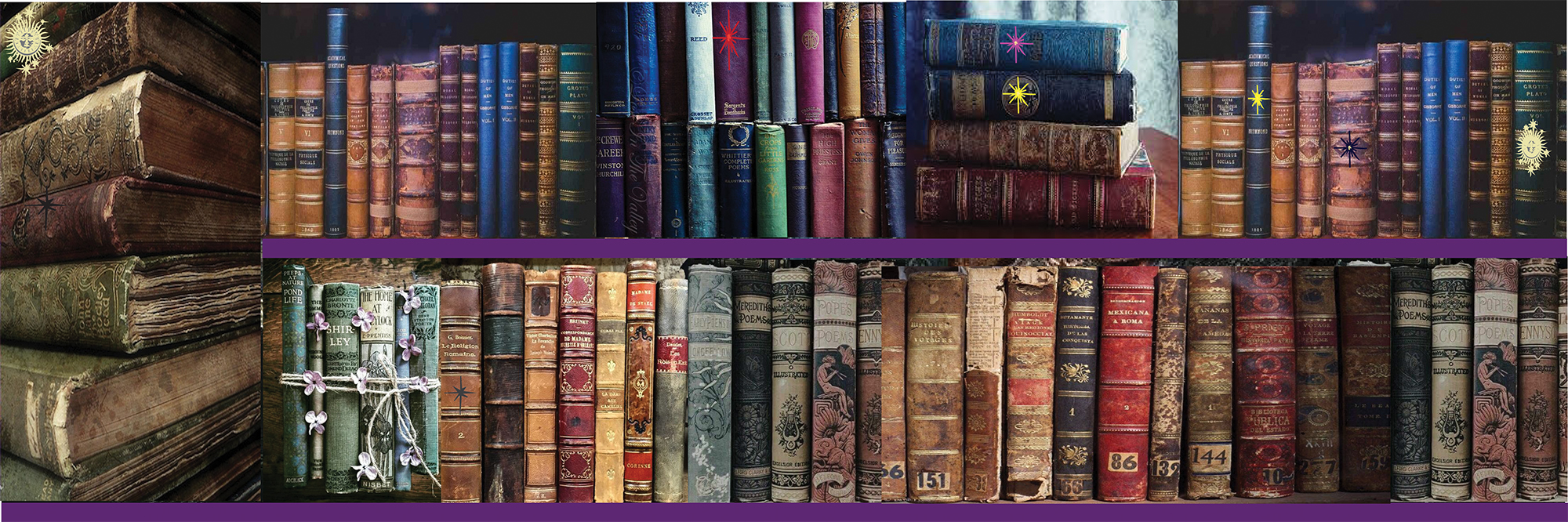تعريف وغلاف ومقدمة وفهارس كتاب “تنقيح الأبحاث للملل الثلاث”/ تأليف ابن كمّونة (ت 683هـ)، تحقيق ودراسة لويس صليبا
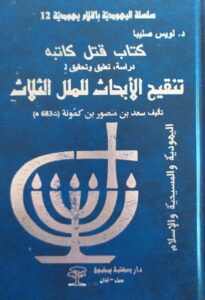
المؤلّف/Author : سعد بن منصور بن كمّونة Ibn Kammuna
عنـوان الكتاب : تنقيح الأبحاث للملل الثلاث
Tanqih al-Abhâth
Examination of the Three Faiths
كاتب الدراسة Editor/ : د. لويس صليبا Dr. Lwiis Saliba
باحث في الدراسات الإسلامية والأديان المقارنة/السوربون – باريس
عنوان الدراسة : كتاب قَتَل كاتبه
عنوان السلسلة : اليهوديّة بأقلام يهوديّة 12
عدد الصفحات : 584 ص
سنة النشر : 2016 طبعة رابعة/2013 ط3/ط2: 2010/ ط1: 2009.
الطباعـة : مطابع دار ومكتبة بيبليون
الناشر : دار ومكتبة بيبليون
طريق المريميين – حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس ، لبنان
ت: 540256/09 – 03/847633 ف: 546736/09
www.DarByblion.com
Byblion1@gmail.com
2016 ©- جميع الحقوق محفوظة
سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة
1 – صدر منها
- م. حاي بن شمعون، كتاب الأحكام الشرعيّة في الأحوال الشخصيّة للملّة اليهوديّة.
- الدكتور هلال فارحـي، كتاب أساس الدين: تعاليم الديانة اليهوديّة وقواعـد إيمانها، ويليـه كتاب أصداء التوراة للحبر ولش.
- ماكس مارجوليز وألكسندر ماركس، تاريخ الشعب اليهودي في العصور الوسطى، أو كيف يروي اليهود تاريخهم.
- إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهليّة وصدر الإسلام، قدّم له د. طه حسين، مع دراسة مدخل: صراع اليهوديّة والإسلام من منظور يهودي، للدكتور لويس صليبا.
- إسرائيل ولفنسون، موسى بن ميمون: حياته ومصنّفاته، تقديم مصطفى عبدالرازق.
- جوزف هرتس، خلاصة الفكر اليهودي عبر العصور، نصوص أساسية من التلمود وأحبار اليهود وفلاسفتهم، تحوي زبدة العقائد اليهودية في الدين والمجتمع، مع دراسة تحليلية للدكتور لويس صليبا: الفكر اليهودي بين الخصوصية والشمولية.
- د. سليم شعشوع، تاريخ الفلسفة والعلوم اليهودية في أرض الإسلام: دراسة في تراث اليهود في الدولة الإسلامية وخصوصاً في الأندلس. مع دراسة وتكملة لِزد. لويس صليبا: الفلسفة والعلوم اليهودية جسر تواصل بين العرب والغرب.
- إيلي ليفي أبو عسل، يقظة العالم اليهودي، ويسبقه كتاب: من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام: دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه لِزد. لويس صليبا.
- تاريخ يوسيفوس اليهودي (ت 100م)، نشره نقولا مدوّر. مقدمة ودراسة لشاهين مكاريوس.
- شاهين مكاريوس، تاريخ الإسرائيليين: اليهود قديماً وحديثاً مع تراجم مشاهيرهم شرقاً وغرباً. خاتمة لِزروفائيل بن شمعون حاخام مصر الأكبر.
- رحلة الرابّي بنيامين التطيلي (1160 – 1173)، وفيها وصف لأوضاع اليهود في مختلف البلدان ولِفِرَق الدروز والحشّاشين وغيرها. ترجمة، دراسة وتعليق عزرا حدّاد.
- عزّ الدولة بن كمّونة، تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام، قدّم له بدراسة وعلّق عليه: د. لويس صليبا.
- – العلاّمة دي بفلي، المعاملات والحدود في شرع اليهود طبقاً لأحكام التوراة والتلمود مع مقارنة بالشريعة الإسلامية. تعريب القاضي محمد حافظ صبري.
- – موسى بن مَيْمون (ت 601 ﻫ)، شرح أحكام التوارة والتلمود، دراسة وتقديم د. عباس زرياب.
- – د. إسرائيل ولفنسون (أبو ذؤيب)، كعب الأحبار وتسبقه دراسة للأثر اليهودي في الحديث النبوي والتفسير، للدكتور لويس صليبا.
سلسلة اليهودية بأقلام يهودية
2 – تعريف
لا يصعب علينا إدراج هذه السلسلة تحت شعار “إعرف عدوّك”. ولكن الهدف منها يتخطّى هذا الطرح الأيديولوجي الديماغوجي، ليتناغم مع مبدأ غدا اليوم من أبرز أسس علم الأديان المقارنة وركائزه. ألا وهو دراسة الأديان من الداخل.
فالظاهرة الدينيّة، كموضوع للدّراسة والبحث، تختلف عن الظواهر الطبيعيّة في العلوم البحتة. ولا يمكن بالتالي فقهها بمجرّد الملاحظة الخارجيّة. إذ تبقى هذه الطريقة مجتزأة وغير كافية.
كيف يفهم اليهودي دينه؟ كيف يشرحه، ويعبّر عنه؟ كيف يعيشه ويطبّق شرائعه ونواميسه؟ كيف يعي، هو نفسه، تاريخه ويرويه؟ كيف يقونن شرائعه لتتجاوب مع العصر؟ كيف يعلّم مبادئ دينه لأبنائه؟
إنّها المقاربة الداخليّة للأديان. وأولى شروطها أن نصغي للآخر كآخر ومختلف. وأن نجتهد لندعه يتكلم، لا بل حتى أن نفرض الصمت، لحين، على وجهات نظرنا. وذلك كي نفهم هذا الآخر كما يفهم هو نفسه, وليس كما كنّا نتخيّل، أو نتمنّى فهمه قبل أن يتكلّم.
ليس الغرض من هذه السلسلة الدفاع عن اليهوديّة بأيّ شكل من الأشكال. وإلاّ لغدت هي الأخرى عملاً دعائيّاً، ديماغوجيّاً. وإنّما التعريف عن النفس. فحتّى في المحاكم، يُطلب من المُتّهم أن يعرّف هو عن نفسه في البدء، وقبل الشروع بمحاكمته. كيف الأمر إذاً في العلوم الإنسانيّة والأبحاث. ففي إطار التعريف عن النفس، تندرج هذه السلسلة. وهي ستضمّ إن شاء الله فئتين من المؤلّفات:
1 – المؤلّفات الحديثة: ممّا كتبه اليهود في الزمن المعاصر، لا سيّما باللّغة العربيّة. وقد عرفت مصر خاصّة نهضة في بداية القرن العشرين، على هذا الصعيد. فصُنّفت، ونشر فيها العديد من الكتب، لمؤلّفين وباحثين يهود: أمثال إسرائيل ولفنسون، فارحي، وغيرهما.
والكتب هذه لا تزال تتميّز بشيء من العصرنة.
2 – الكتب التراثيّة: شارك اليهود في النشاط الأدبي الفلسفي في الدولة الإسلامية. ولكن المكتبة العربيّة تفتقد اليوم إلى كثير من كتب ابن كمونة، ابن ملكا البغدادي، أبو الحسن اللاّوي (يهودا هاليڤي)، موسى بن ميمون وغيرهم. وهذه الكتب جزء من التراث العربي– الاسلامي.
لذا ستفسح هذه السلسلة المجال لنشر عدد من مصنّفات هؤلاء، في طبعات محقّقة.
ولأيّ من الفئتين، انتمى الكتاب، فسلسلة “اليهوديّة بأقلام يهوديّة” تلتزم نشر نصّه الكامل، مع إمكانيّة التقديم له، أو التعقيب عليه، بدراسة نقديّة. كما هو الحال في كتاب ولفنسون “تاريخ اليهود في بلاد العرب” مثلاً.
أملنا أن تؤدّي هذه السلسلة خدمة، إلى القارئ، طمحت إليها. وتشغل بالتالي حيّزاً لها في المكتبة العربيّة.
دار ومكتبة بيبليون
جبيل – لبنان
مدخل إلى أبحاث الكتاب وأقسامه
أيُعقل أن يقتل كتاب كاتبه؟ قد يجد القارئ في عنوان دراستنا بعضاً من مغالاة أو أثر أسلوب ترويجي يهدف إلى لفت الانتباه. والتسويق بالتالي.
ولكن هل إتلاف الكتب، واغتيال كُتّابها حدث نادر في تراثنا وتاريخنا؟! إن فيه من الأحداث المماثلة ما يكفي مادّة دسمة لكتاب في هذا الموضوع. وهاك واحدة منها أرّخ لها الطبري وكثيرون غيره:«سنة 163 ﻫ انتهى المهدي (الخليفة العبّاسي) إلى حلب وبعث وهو بها عبدالجبّار المحتسب لجلب مَن بتلك الناحية من الزنادقة. ففعل، وأتاه بهم وهو بدابق، فقتل جماعة منهم وصلبهم، وأتى بكتب من كتبهم فقطّعت بالسكاكين»([1])، ومَن أراد معرفة المزيد فعليه بكتاب جرد هذه الأحداث عبرعصور التاريخ العربي([2]).
ولكن حرق الكتُب وقتل الكُتّاب ظاهرة لم يستأثر بها تاريخنا وحده. فأزمنة القرون الوسطى في الغرب حافلة “بمآثر” من هذا النوع. محاكم التفتيش، حرق التلمود وكُتُب الهراطقة، لا بل وأيضاً حرق مئات وألوف الكتار Cathares زنادقة الغرب وأتباع ماني أحياء شاهد على أن الكل شرقاً وغرباً لم يقصّر في هذا المجال. ولكن الفرق بين الغرب وشرقنا، أن الأوّل تجاوز هذه المسألة/العُقدة، وباتت مجرّد ظاهرة عبرت، وإن كانت نقطة سوداء في تاريخه، أمّا نحن فلا زلنا نعاني من عوارض كثيرة لمرض عدم التساهل Intolérance ورفض الآخر والمختلف في بيئات ومجتمعات غالباً ما تنحو لتكون توتاليتاريّة الفكر وأحآديته.
تعرض دراستنا هذه لأفكار ملاحدة في التاريخ الإسلامي أمثال ابن الريوندي (ت245ﻫ)، ومحمد بن زكريا الرازي (ت320ﻫ) وأبو العلاء المعرّي (ت449ﻫ). وقد عاشوا في مجتمعات إسلاميّة، وعبّروا، وبحرّية أحياناً كثيرة، عن رفضهم لمعتقدات هذه المجتمعات وبل وسخريتهم منها، وذلك دون أن يُؤذوا أو يُقمعوا أو يُضطهدوا. فهل كانت مجتمعاتنا الإسلاميّة أكثر تسامحاً وتساهلاً ممّا هي عليه اليوم؟!.
هذا ما طرحناه وبحثنا فيه في خاتمة كتابنا “ديانة السيخ”([3]).
ولكن لنعُد الآن إلى موضوعنا الأساسي. فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما الفائدة من إعادة نشر كتاب أثار كل هذه الضجّة في زمنه وكان وبالاً على صاحبه؟!.
حادثة ابن كمّونة وكتابه التنقيح (683ﻫ)، كما بيّنا في دراستنا، لم يكُن الكتاب سوى ذريعة لها. أما الأسباب والخلفيات فسياسيّة، وصراعات على الحُكم وغير ذلك مما هو مفصّل في مكانه. ولكن هذا ليس بجواب شافٍ وإن كان جزءاً منه.
لِمَ نشر كتاب كهذا في زمن عدم التسامح، بل التعصّب البغيض هذا؟!.
بِبساطة نجيب: لأنه يأتي في وقته تماماً. فهو يحمل في طيّاته رسالة قديمة متجدّدة لا تَعتَق: الحوار مع الآخر. الإصغاء إليه عارضاً معتقداته من منظوره ورؤيته هو. نقل الصراع من الشارع وساحات الوغى حيث تفتك الأسلحة بالبشر والحجر إلى مجالس الفكر وصفحات الكتب وحصره فيها.
عِلم الأديان المقارنة الذي يشهد اليوم قفزات نوعيّة في الغرب واهتماماً متزايداً في العالمَين العربي والإسلامي، هل ننسى أن بعض عُلماء المسلمين والعرب كان من روّاده والسبّاقين إليه؟! سبق لنا أن تناولنا بالبحث مساهمات البيروني في هذا المجال([4])([5]). وها نحن اليوم نقدّم مساهمة أخرى لا تقلّ عنها أهمّية، تنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمّونة. هذا الأثر، شئنا أم أبَيْنا نتاج الحضارة العربية/الإسلاميّة أيّاً يكُن دين كاتبه أو موقفه من الإسلام. فهو سِفْر صُنّف بالعربيّة وكان له أثر في زمنه حفز الكثيرين للردّ عليه كما سيرد في الدراسة. فعزّ الدولة سعد بن منصور بن كمّونة الإسرائيلي اليهودي والبغدادي هو ابن الثقافة العربية/الإسلاميّة. نشأ وترعرع في أجوائها. قرأ كتُب ابن سينا وشيخ الإشراق السهروردي منذ شبابه، وخلّف شروحات ضافية ومهمّة لبعض منها. ومَن يقرأ كتابه “الجديد في الحِكمة” مثلاً، يظنّ أنه يقرأ أثراً لفيلسوف إسلامي من مدرسة ابن سينا والإشراق. لقد تشبّع ابن كمّونة بالفلسفة الإسلاميّة وتمثّلها، وشرح آثار عدد من كبارها لدرجة تخاله واحداً من أساطينها. وقد كانت لنا وقفة عند “الصمت وحفظ الحواس في فلسفة ابن كمّونة”([6]) بيّنا فيها مدى تأثّره بالتصوّف الإسلامي، حتى أنه في مقاربته لهذا الموضوع كان متصوّفاً يحكي. آن لنا في هذا الشرق أن نفهَم تراثنا بمعناه الواسع الرحب، فنكفّ عن ممارسات هي أشبه بما عرف في حرب لبنان بِز“الحواجز على الهويّة” أي أن ندقّق بهويّة الكاتب، فاستناداً إلى أي دين أو طائفة ينتسب مولداً نحدّد مذهبه وفكره ونحدّه به.
نشر هذا السِفر وفي زمن التطرّف والإرهاب ذا، يأتي في وقته قلنا. فبالإضافة إلى أنه أثر محوري في تاريخ علم الأديان المقارنة وتطوّره فهو يعود ليعلّمنا، من جديد، بعضاً من أصول أدب حوار نسَيْناه أو تناسَيْناه: احترام مقدّسات الآخر وعقائده من ناحية، ولكن دون أن يعني ذلك محاباته أو مسايرته في عرض رأينا فيها. لقد بذل ابن كمّونة، والحق يُقال، مجهوداً لافتاً في هذا المجال. فعرض عقائد المسيحيّة والإسلام بكثير من الموضوعيّة والحياد. وأبدى تجاه مقدّساتهما ما يبديه أهلها لها من إجلال وتبجيل. فلم يذكر نبي المسلمين ولا مسيح النصارى إلا وألحق الذِكر بما يجب من عبارات الاحترام. فهل كان احترامه هذا مصطنعاً ومجرّد محاباة ومداهاة؟!.
أبحاثنا في الدراسة التالية تجيب بالنفي. وتنحو إلى القول إن أسلوبه اللبق والراقي هذا، يعود بالأحرى إلى قناعة عميقة بدور الأديان وضرورتها وحاجة الناس إليها. ومقارناتنا في الدراسة بين موقف ابن كمّونة من المسيحيّة والإسلام ومواقف يهود عصره منهما بيّنت هوّة وفروقات شاسعة بين الجهتَين. ألم يقُل في خاتمة الباب الثالث (النصرانيّة) عن كثير ممّا يُقال عن المسيحيّة:«وأما سائر ما ذكر من كلام المخالفين، فبعضه مجرّد تشنيع واستبعاد، وبعضه لا يخفى على المحصّل وجه دفعه، ولو بتكلّف».
ألا يعبّر هذا الكلام عن موقف مغاير بل ومناقض لموقف يهود عصر ابن كمّونة من المسيحيّة (والإسلام كذلك)، ما توسّعنا في عرضه في دراستنا؟ أو لم يكُن أسلوبه في الكلام على عقائد الآخر راقياً ومميّزاً؟!.
ولكن هذا الاحترام، كما سبق وأسلفنا، لم يعنِ عنده محاباة ولا مسايرة. فالطعون والشبهات على المسيحيّة والإسلام بل وحتى اليهوديّة أوردها بكل صراحة ومن دون مواربة. الاحترام العميق لم يؤثّر على صراحته بل جرأته في العرض. وقد دفع، وهو المتحفّظ طبعاً في الأساس، غالياً ثمن هذه الجرأة. لقد كان مصير السهروردي المقتول، وابن كمّونة من أوائل الذين اعتبروه شهيداً، ماثلاً أمامه. ولكن ذلك لم يفده كثيراً في تلافي مصير مشابه. وهل ينفع حذرٌ في دفع قدر؟!.
أيّـاً يكُـن فـإن قطبـي الأسلـوب الكمّوني ومحورَيه: الاحترام الصراحة، كفيلَين لوحدهما بجعل هذا الأثر جديراً بالبقاء واستخلاص العِبَر والدروس منه. ولكن للتنقيح مزايا أخرى كثيرة غير هذه، توقّفنا عند غالبيّتها في دراستنا، ونترك للقارئ اكتشافها في النص.
لقد كانت لنا رحلة طويلة وممتعة مع هذا الفيلسوف اليهودي الذي حيّر الكثيرين. وها هو جهد سنوات عديدة يصل إلى خواتيمه، فيوضع بين أيدي القرّاء، ويأخذ مكاناً له في المكتبة العربية.
ابن كمّونة فيلسوف حيّر الكثيرين، كيف ولماذا؟!.
لم تنتج الحيرة هذه عن التنقيح وحسب. فابن كمّونة هو صاحب الشبهات/المسائل التي عرفت باسمه أو نسبت إليه، وتداولها الفلاسفة الإيرانيون قروناً من الزمن ولا يزالون يقدّمون إجابات عنها. وقد اختُلف إلى حدّ التناقض في مذهبه وعقيدته «فبينما عدّه الكثيرون يهودياً، هناك مَن يعدّه مسلماً اعتماداً على مقدّمة آثاره التي يصلّي فيها على النبي وأهل البيت، بل عدّه آخرون شيعياً» يقول كاتب مقالة “ابن كمّونة” في دائرة المعارف الإسلاميّة الكبرى. وقد وصل البعض إلى حدّ وصمه بِز“شيطان الحُكماء”([7]). وهل بين الحُكماء شياطين. وهل لإبليس إلى الحِكمة وعقول الحُكماء درب وطريق؟!
لقد نسبت لابن كمّونة شبهات شتى، ما يتعلّق به من بعيد (أو قريب)، وما لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد. لكأن “جسمه لبّيس” كما يقول المثل اللبناني. أي أن سوابقه تتيح إلصاق شتّى التهم به كما يُقال. لِمَ حيط (حائط) هذا المفكّر/الفيلسوف واطي (منخفض) أَلأنه يهودي؟ أبسبب “تنقيحه” الذي أثار الكثير من الردود. أم بسبب الحادثة التي آلت إلى وفاته.
لقد حيّر ابن كمّونة الكثيرين، قلنا: بحياته وشبهاته وبوفاته كذلك. ولا نملك عن تفاصيل الحادثة التي توفّيَ إثرها بأيام سوى رواية “الحوادث الجامعة” المنسوب لابن الفوطي. مما يجعل مسألة الفصل في خلفيتها وأسبابها ودوافعها ونتائجها أمراً بالغ الصعوبة. وقد قرأنا في النص كما بيّنا في مطلع الدراسة أن الكاتب ذهب ضحيّة كتابه “التنقيح” على ما يبدو وفي غالب الظن.
كتاب بلغ أثره هذا الحدّ، كان لا بدّ من وقفة مطوّلة عنده. وقد استغرقت وقفتنا دراسة وتعليقاً كما أسلفنا سنوات.
تنقسم دراستنا إلى محاور/أبواب ثلاثة.
تناولنا في الباب الأوّل المؤلّف في حياته ومؤلّفاته وفلسفته. المعلومات التاريخيّة عن هذا المفكّر قليلة بل نادرة. وتكاد تنحصر في مصدرَين: معجم الألقاب للفوطي والحوادث الجامعة المنسوب إليه. في حين يغيب اسمه في المصادر العبريّة واليهوديّة. أما أبرز ذكر له في الأجيال التي تلته فعند مفكّري إيران وفلاسفتها كصاحب الشبهات، وشرح التلويحات للسهروردي.
ومع هذا الشحّ في المعلومات حاولنا أن نرسم الصورة الأقرب إلى الدقّة عن حياة هذا الفيلسوف (موضوع الفصل الأوّل من الباب الأوّل) ومؤلّفاته (موضوع الفصل الثاني) والتي ضاع منها الكثير في حين أن العديد مما بقي لما يزل مخطوطاً نائماً في الخزائن.
وكانت وقفتنا الكبرى (الفصل الثالث من الباب الأوّل) عند شخصيّته وشبهاته ومذهبه.
شخصيّته حاولنا تبيّنها بالعودة إلى نصوصه وما وصلنا من كتبه، فمن الضروري رسم أبرز ملامحها لفقه نصّ التنقيح.
أمّا شبهاته، وإليها يعود الفضل الأكبر في شهرته، فكان لا بد من عرض وتفحّص لها لتمييز الصحيح من المنحول، ومحاولة معرفة أسباب نسبة كل هذه الشبهات إليه.
أمّا مذهبه، وقد تفاوتت الآراء فيه إلى حدّ التناقض كما أشرنا، فقد بيّنا بعد عرض وافٍ أنه بقي على يهوديّته حتى وفاته، وإن كان قد طعّمها بعقلانيّة فلسفيّة اكتسبها من اشتغاله الطويل بالفلسفة وانكبابه على آثار ابن مَيْمون وابن سينا والسهروردي وغيرهم.
والمحطة الثانية (الباب الثاني) في الدراسة كانت عصر ابن كمّونة. فالتنقيح كما بيّنا يعكس ثقافة عصره، وما ساده من جدل وسجال بين أهل الملل وتسابق كذلك لكسب ودّ الحاكم المغولي واستمالته. ولتوضيح كل ذلك رأينا من الضروري دراسة أوضاع اليهود وأهل الذمّة عموماً في ظلّ الدولة العبّاسية وتغيّرها مع قيام الدولة المغوليّة. ولولا فسحة الحرّية الدينيّة التي أتاحها المغول في الحقبة الأولى من تاريخ دولتهم، لما كان ابن كمّونة قد تجرّأ على كتابة “التنقيح” ونشره. أما البحث في موقف يهود عصر ابن كمّونة من المسيحيّة والإسلام فقد أتاح لنا تبيّن مصادر بعض طعون التنقيح وكذلك إظهار تميّزموقف الكاتب منهما عن موقف سائر أهل جلدته.
والمحور/الباب الثالث والأبرز في بحثنا هو دراسة نص التنقيح. فبعد التمعّن في ظروف تأليفه ودوافعه وعلاقة ذلك بموقع المؤلّف من الحاكم وهو موضوع الفصل الأوّل انتقلنا في الفصل الثاني إلى دراسة مخطّط الكتاب ومنهجيّة الكاتب وما أخذ عليها ومصادر الكتاب ما ظهر منها وما سُتر. أما الفصل الثالث فتناول الباب الأوّل من الكتاب وموضوعه النبوّة. فبدا لنا المؤلّف غالباً فيه مجرّد ناقل عن الغزالي وابن سينا وابن مَيْمون في حين أن نظريّته في النبوّة تدور بمجملها حول نظريّة الفارابي وتأخذ عنها، أما معلوماته عن الأديان الأخرى غير الملل الثلاث فضحلة وتكاد تكون معدومة.
ودرسنا في الفصل الرابع الباب الثاني من التنقيح “اليهوديّة” فوجدنا أن ابن كمّونة في عرضه لليهوديّة وعقائدها عالّة على يهودا هاليڤي. في حين أنه أخذ الاعتراضات عليها من السمؤال المغربي وغالبيّة الردود على الاعتراضات عن ابن مَيْمون.
وتبقى مساهمته الأساسية هنا هي محاولة التوفيق بين هاليڤي (التيار الديني في اليهوديّة) وموسى بن مَيْمون (التيار الفلسفي الأرسطي). ولاحظنا أن ابن كمّونة على الرغم من حماسه الظاهر لليهوديّة ولنظريات هاليڤي في الأمر الإلهي وحصر النبوّة في شعب إسرائيل فهو لا يتكلّم على شريعة موسى وديانته بصيغة الز:نحن، بل يبقى على مسافة ما منها. هذا على الرغم من انحيازه الظاهر إلى نبوّة موسى واعتبارها هي ومعجزاته وتواترها نموذجاً مثالياً للنبوّة والمعجزة والتواتر. إنها المثال الذي عجز كل الأنبياء التالين عن إدراكه.
والفصل الخامس بحث في النصرانية من المنظور الكمّوني أي موضوع الباب الثالث من التنقيح. وقد وجدنا هنا أن ابن كمّونة، وقد فاته الابتكار في أبواب أخرى، لم يعوزه هنا. فخرج بنظريات جديرة بالتمعّن مثل الفصل بين مسيح التاريخ ومسيح المسيحيّة، ودور بولس في تأسيس هذه الديانة.. الخ. هذا مع أنه تلاعب بالكثير من النصوص الإنجيليّة وحرّفها بما يوافق أفكاره وهواه.
أما الفصل السادس والأخير فأفردناه لدراسة الباب الرابع والأخير من “التنقيح”. وقد لاحظنا أنه الأطول والأبرز والأهم. لكأن التنقيح كتب أساساً من أجل الخلوص إلى هذا الباب.
وفيه يزحف ابن كمّونة ببطء، ولكن بثبات، نحو أدلّة المتكلّمين على نبوّة رسول الإسلام، صلعم، فيعرضها بحياد ظاهر، ليتوسّع في الاعتراضات والطعون عليها. ما يجعل هذه الأدلّة تتهاوى وتسقط، برأيه، الواحد تلو الآخر. فلا إعجاز القرآن يصمد أمام تنقيح ابن كمّونة ولا دعوى خلوّه من التصحيف أو التحريف. ولا ما نقل عن إخباره، صلعم، بالغيب أو ما نسب إليه من المعجزات يصحّ أو يعوّل عليه في إثبات نبوّته. ولا غير ذلك من البشارة ببعثته وانقلاب الدنيا معها أو صفاته وأخلاقه.
ومع ذلك فابن كمّونة بعد تفنيد كل هذه الدلائل لا يخلص إلى موقف صريح واضح في نبوّة الرسول، صلعم، وصحّتها. لكأنه يترك للقارئ أن يستخلص ويستنتج تستّراً أو تحفّظاً ربما، أو محافظة على حدّ أدنى من موضوعية ادّعى.
والموضوعيّة/الحياد هو التحدّي الأكبر الذي حاول ابن كمّونة أن يواجهه. فهل نجح في رفع هذا التحدّي؟
هذا ما حاولنا الإجابة عنه في الخاتمة ملاحظين أنه نجح حيناً وأخفق أحياناً، مشيرين إلى النجاحات والإخفاقات في آن.
ولكننا، وللأمانة العلميّة، نطرح على ذاتنا السؤال عينه: ألا نخشى أن نكون قد وقعنا في ما حاول ابن كمّونة جاهداً تجنّبه، ولكنه وقع فيه. هل حاول فعلاً أن يكون محايداً، أم أن حياده الظاهر هذا كان مجرّد قناع لتمرير طعون وشبهات على المسيحيّة وخاصة على الإسلام؟!
الحُكم على النوايا أمر صعب بل شبه مستحيل، وليس بمقدورنا سوى أن نحكم على ما بأيدينا أي النص. وهذا الأخير يُظهر أن الكاتب اجتهد أن يقف على مسافة واحدة من الأطراف/الملل. فأصاب الهدف حيناً، وطاش سهمه أحياناً. ولكن هل نجحنا نحن بدورنا حيث زعمنا أنه أخطأ؟!.
وهل تقبل شهادة المرء عن نفسه؟ جلّ ما نقول أن الحياد التام في مسألة كهذه أمر عسير. فالدين يتناول أعمق ما في الإنسان: وجدانه، مصيره، خياراته في الحياة. ولكن هل يتطلب الحياد في جدال الملل الثلاث وسجالها وحوارها أن يكون المحاور غير منتمٍ لأي منها كي لا يشكّك في حياده؟ أيلزم أن تطبّق عليه الشروط الضروريّة للتحكيم في مباراة كرة قدم دوليّة مثلاً؟!
لقد آلينا جهدنا أن نلحظ لا أن نحكم. أن نحلّل المقولات والمواقف ونتبيّن دوافعها وخلفياتها لا أن نتّخذ بدورنا موقفاً منها، شاجباً كان أم مؤيداً.
سعينا بصدق أن نتعلّم من هفوات ابن كمّونة وأخطائه بقدر تعلّمنا من صوابه.
اجتهدنا، وللقارئ الحكم أيّ أجر يحقّ لنا: أَأجرُ المخطئ أم المُصيب.
Q.J.C.S.T.B
د. لويس صليبا
السوربون/باريس في 25/01/2009
[1] – الطبري، الإمام الفقيه المفسّر المؤرّخ أبو جعفر محمد بن جرير (224 – 310ﻫ)، تاريخ الأمم والملوك تاريخ الطبري، تحقيق أبو صهيب الكرمي، عمّان، بيت الأفكار الدوليّة، لا ط، لات، ص 1622.
[2] – الحزيمي، ناصر، حرق الكتب في التراث العربي مسرد تاريخي، كولونيا/ألمانيا، منشورات الجمل، ط1، 2003، 144 ص.
[3] – صليبا، د. لويس، ديانة السيخ بين الإسلام والهندوسية تاريخها، عقائدها، صراعها مع الإسلام وأبرز نصوصها المقدّسة، سلسلة أديان وكتب مقدّسة6، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2008، ص 284 – 289.
[4]– Saliba, Lwiis, L’Hindouisme et son influence sur la penseé musulmane selon al-Bîrûnî, Paris, Dar Byblion, 2ème édition, 2009, 250 p.
[5] – صليبا، د. لويس، أقدم كتاب في العالم، دراسة ترجمة وتعليقات، سلسلة أديان وكتب مقدّسة2، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2007، ص 26 – 29 و201 – 217.
[6] – صليبا، د. لويس، الصمت في اليهوديّة، تقاليده في التوراة والتملود وعند النبي إيليا والحسيديم، سلسلة الصمت في التصوّف والأديان 3، جبيل/ لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2006، ص 75 – 79.
[7] – م. ن.
المحتويات
بطاقة الكتاب……………………………………………….. 4
إهداء……………………………………………………… 5
سلسلة اليهوديّة بأقلام يهوديّة، 1 صدر منها…………………….. 6
سلسلة اليهودية بأقلام يهوديّة، 2 تعريف………………………… 8
مقدمة سحبان مروّة………………………………………….. III
مدخل إلى أبحاث الكتاب وأقسامه……………………………… 11
القسم الأول من الكتاب………………………………….. 25
الباب الأول: ابن كمّونة حياته مؤلّفاته وفلسفته……………. 27
تنقيح الأبحاث: كتاب قتل كاتبه……………………………….. 28
الفصل الأول: مَن هو ابن كمّونة………………………………. 31
– ابن كمّونة في المصادر القديمة…………………………….. 33
– ابن كمّونة في المراجع الحديثة……………………………… 37
– تفنيد لبعض ما ورد عن ابن كمّونة…………………………… 39
الفصل الثاني: مؤلّفات ابن كمّونة…………………………….. 43
أولاً: الكتب العلمية…………………………………. 45
ثانياً: الكتب الفلسفية………………………………… 46
ثالثاً: كتب الجدل والكلام……………………………. 59
الفصل الثالث: ابن كمّونة شخصيّته شبهاته ومذهبه…………………… 67
أولاً: شخصيّته…………………………………….. 67
1 – الحذر والتحفّظ……………………………. 69
2 – النزعة التوفيقيّة…………………………… 70
3 – الحياد…………………………………… 71
4 – تواضع العالم…………………………….. 72
5 – النزعة الدينية العميقة……………………. 73
ثانياً: شبهاته وأثره في الفلسفة……………………. 74
– شبهات ابن كمّونة………………………. 75
– شبهة التوحيد………………………….. 76
– شبهة الجذر الأصم…………………….. 81
– شبهة الاستلزام…………………………. 84
-خلاصة في شبهات ابن كمّونة……………. 86
ثالثاً: مذهب ابن كمّونة………………………….. 88
الباب الثاني: اليهود في زمن ابن كمّونة…………………… 95
الفصل الأول: عصر ابن كمّونة وأبرز أحداثه…………………… 97
– أهمّية دراسة عصر ابن كمّونة في فهم التنقيح…………… 99
– عصر ابن كمّونة وأحداثه…………………………….. 100
– ابن كمّونة بين الدولتين العبّاسية والمغوليّة………………. 100
الفتن بين اليهود والمسلمين………………………… 103
نكبات أهل الذمّة بعد سقوط بغداد…………………… 105
مدّعو النبوّة: معارضة القرآن زمن ابن كمّونة…………. 106
الانقلاب على السلطان المغولي المسلم……………… 108
حادثة ابن كمّونة ردّة فعل على الانقلاب…………….. 111
الوزير اليهودي والإطاحة به…………………………… 112
التنكيل باليهود بعد إطاحة سعد الدولة…………………… 113
الفصل الثاني: اليهود في الدولة العبّاسية………………………. 115
تفاعل الملل في المجتمع العباسي……………………… 117
– اليهود في بغداد عشية الغزو المغولي…………………… 118
– أوضاع اليهود في الدولة العباسية……………………… 121
– النظرة إلى اليهود في المجتمع الإسلامي………………… 125
الفصل الثالث: يهود العصور الوسطى وموقفهم من المسيحيّة والإسلام……………….. 131
– موقف اليهود من النصارى وعقائدهم……………………. 133
أحداث تباغض بين اليهود والنصارى…………………… 133
مقدّسات النصارى من المنظور اليهودي…………………. 136
– موقف اليهود من الإسلام……………………………… 139
نبي الإسلام بنظر اليهود……………………………… 139
أحداث تؤكّد النظرة اليهوديّة إلى الإسلام ونبيّه…………… 141
القرآن في الغربال اليهودي……………………………. 143
كتب الجدل اليهودي ضد الإسلام………………………. 144
– موقف اليهود في إطاره التاريخي……………………….. 146
الفصل الرابع: اليهود في الدولة المغوليّة………………………. 149
– انقلاب أوضاع اليهود مع قيام الدولة المغوليّة……………. 151
– المسيحيّون والفرصة الضائعة………………………….. 153
– سعد الدولة وعصر اليهود الذهبي………………………. 155
– سقوط سعد الدولة ونكبة اليهود………………………… 158
– حكم غازان والعودة إلى الذمّية…………………………. 161
– المغول والمماليك يتنافسان في اضطهاد الذمّيين………….. 162
الباب الثالث: دراسة لكتاب التنقيح………………………… 165
الفصل الأوّل: تنقيح الأبحاث: زمنه، ظروفه ودوافع تأليفه………………. 167
– نسبة التنقيح وتاريخه…………………………………. 169
– التنقيح وذروة الصراع على دين الدولة المغوليّة…………… 171
– موقع ابن كمّونة من الصراع بين الملل………………….. 176
– مجالس الحوار والجدل الديني عند المغول……………….. 178
– التنقيح محضر جلسة حوار وجدل……………………… 184
الفصل الثاني: مخطّط التنقيح ومنهجيّته……………………….. 185
1 – مخطّط الكتاب………………………………… 187
2 – منهجيّة الكاتب ……………………………….. 188
3 – مصادر التنقيح………………………………… 191
الفصل الثالث: النبوّة محور التنقيح ومفتاح فهمه……………….. 195
– ابن كمّونة ونظريّة النبوّة الإسلاميّة…………………….. 197
الفارابي مؤسّس نظريّة النبوّة في الفلسفة الإسلاميّة………… 198
ابن سينا على خُطى الفارابي………………………….. 202
الغزالي يعترض ثم يعتنق……………………………… 203
ابن مَيْمون يهوّد نظريّة الفارابي………………………… 204
ابن كمّونة ينقل عن ابن مَيْمون………………………… 207
– المعجزات من المنظور الكمّوني………………………….. 207
– شبهات منكري النبوّة في التنقيح الكمّوني………………….. 209
البراهمة وعلاقتهم بإنكار النبوّات…………………………. 210
– ثقافة ابن كمّونة الدينيّة تنحصر في الملل الثلاث…………… 213
الفصل الرابع: اليهوديّة بين السمؤال وهاليڤي وابن كمّونة…………….. 215
– محاور الباب الثاني من التنقيح………………………….. 217
ابن كمونة متبنّياً آراء هاليڤي…………………………. 218
تعريف بكتاب الخزاري لِهاليڤي……………………….. 219
الخزاري في أبرز محاوره وأفكاره………………………. 220
هاليڤي: النبوّة لا الفلسفة…………………………….. 222
هاليڤي: النبوّة محصورة بشعب إسرائيل وأرضه ولغته…….. 223
موقف هاليڤي من المسيحيّة والإسلام………………….. 225
فلسفة التاريخ اليهودي عند هاليڤي…………………….. 227
– ابن كمّونة بين هاليڤي وابن مَيْمون……………………….. 228
– ابن كمّونة والنبوّة والمعجزة والتواتر في اليهوديّة…………….. 230
– التوراة بين ابن كمّونة وردود ابن المحرومة…………………. 233
– حياد ابن كمّونة في الميزان……………………………… 236
الفصل الخامس: النصرانيّة في الفكر الكمّوني…………………… 237
– مخطّط دراسة النصرانيّة والتشكيك بحياده………………….. 239
مصادر التنقيح المسيحية……………………………. 241
معجزات المسيح من المنظور الكمّوني…………………. 244
المسيح وشريعة موسى………………………………. 246
أثر النظرة اليهوديّة إلى المسيحيّة في فكر ابن كمّونة……. 250
الفصل السادس: نبوّة محمد من المنظور الكمّوني…………………. 253
– البحث في الإسلام: الباب الأطول والأهمّ……………….. 255
– خلاصة في صحّة نبوّة الرسول………………………… 268
خاتمة الدراسة……………………………………………… 271
القسم الثاني من الكتاب: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث …… 279
كلمة التحقيق……………………………………. 281
مقدمة المؤلّف…………………………………… 283
الباب الأول: بيان حقيقة النبوّة وأقسامها………………….. 285
الفصل الأوّل: النبوّة: ماهيتها، أطوارها وميزاتها……………….. 287
أطوار المعرفة البشرية……………………………. 289
خواص النبوّة……………………………………. 291
الفرق بين النبي والرسول………………………….. 292
آراء المعترفين بثبوت النبوّة………………………… 293
أقسام الوحي…………………………………….. 295
الولاية والنبوّة……………………………………. 296
مراتب الأنبياء…………………………………… 297
الفصل الثاني: المعجزة بيّنة النبوّة……………………………. 299
المعجزات دليل على النبوات……………………….. 301
شكوك على المعجزات……………………………. 303
الأجوبة على الشكوك…………………………….. 305
الفرق بين المعجزات والكرامات والسحر……………… 305
الفصل الثالث: سرّ النبوّة وفوائدها……………………………. 307
الرؤيا والحلم والحدس………………………………… 309
سرّ الأفعال الخارقة للعادة…………………………….. 312
الغاية من وجود النبيّ………………………………… 313
فوائد بعثة الأنبياء……………………………………. 317
شبهات منكري النبوّة…………………………………. 320
كيفيّة إثبات النبوّة……………………………………. 325
الباب الثاني: أدلة اليهود على نبوّة موسى………………… 329
الفصل الأوّل: محاور العقيدة اليهوديّة…………………………. 331
سلسلة الأنبياء قبل موسى…………………………….. 333
موسى يُخرج بني إسرائيل من مصر……………………. 334
موسى كليم الله……………………………………… 336
معجزات موسى والأنبياء من بعده………………………. 337
شريعة موسى وكهنوت هارون…………………………. 339
عقيدة موسى واليهود…………………………………. 340
الفصل الثاني: إعتراضات على رواية اليهود……………………. 343
الاعتراض الأوّل: انقطاع التواتر……………………….. 345
الاعتراض الثاني: انقطاع تواتر التوراة………………….. 348
الاعتراض الثالث: التجسيم في التوراة…………………… 355
الاعتراض الرابع: قصص غريبة في التوراة……………… 358
الاعتراض الخامس: خلو التوراة من الكلام على الحياة…….. 368
الاعتراض السادس: الزرادشت ولغيره معجزات كَموسى……. 373
الاعتراض السابع: شريعة موسى منسوخة……………….. 376
الباب الثالث: معتقد النصارى في المسيح…………………. 389
الفصل الأول: أبرز مقولات النصارى………………………….. 391
العقيدة المسيحية بين التوحيد والتثليث………………… 393
قانون الإيمان المسيحي…………………………….. 394
مقولات فِرَق النصارى في الاتحاد……………………. 395
معجزات المسيح في الأناجيل……………………….. 396
اختلافات العقيدة بين النصارى………………………. 398
الفصل الثاني: أبرز الردود على النصارى………………………. 399
نقد عقيدة الثالوث ومقولات الاتحاد والامتزاج…………… 401
نقد مقولات اليعاقبة والنساطرة والملكانيّة………………. 403
نقد عقيدة التجسّد………………………………….. 405
أمثلة من الإنجيل على أن المسيح ليس بإله…………… 407
علامات مجيء المسيح لا تنطبق على إيشوع…………. 414
الفصل الثالث: أجوبة النصارى على المطاعن…………………… 417
دفاع عن التثليث والاتحاد………………………….. 419
دفاع عن ألوهيّة المسيح……………………………. 421
قول النصارى بوعد التوراة بمجيء المسيح…………….. 422
الرد على القول بالوعد بالمسيح……………………… 423
مجمل أجوبة النصارى على الطعون……………………………. 424
الباب الرابع: عقيدة أهل الإسلام في نبّوة محمد………………. 429
الفصل الأول: أبرز عقائد الإسلام……………………………… 431
الفصل الثاني: الدليل الأوّل: القرآن معجزة محمد………………….. 437
السؤال الأول: هل القرآن لنبي غير محمد؟………………… 441
السؤال الثاني: هل إن مؤلّف القرآن هو محمد؟…………….. 441
السؤال الثالث: هل طرأ على القرآن تحريف؟…………….. 443
السؤال الرابع: التحدّي بالإعجاز؟………………………. 459
السؤال الخامس: إنتشار خبر التحدّي؟………………….. 462
السؤال السادس: هل تواطأ الفُصحاء على اعتباره معجزاً؟……. 462
السؤال السابع: معارضة القرآن سبيل إبطاله؟…………….. 464
السؤال الثامن: هل توفّرت للخصوم دواعي معارضة القرآن؟……… 464
السؤال التاسع: الامتناع عن معارضة القرآن أهو بداعي الحرب؟……. 466
السؤال العاشر: هل اختفت معارضات القرآن؟……………. 466
السؤال الحادي عشر: إحتمال إخفاء معارضات القرآن؟……. 467
السؤال الثاني عشر: أشهر معارضات القرآن…………….. 468
السؤال الثالث عشر: هل كان محمداً سيداً في الفصاحة؟……. 473
السؤال الرابع عشر: تفرّغ الرسول لجمع القرآن مدة طويلة؟….. 476
السؤال الخامس عشر: جهل العرب أموراً يعلمها محمد؟……… 477
الفصل الثالث: الدليل الثاني: معجزة محمد إخباره بالغيب…………………. 479
الإنباء بالغيب في القرآن……………………………… 481
الإنباء بالغيب في السيرة والحديث……………………… 483
مناقشة علم الرسول بالغيب……………………………. 486
الفصل الرابع: الدليل الثالث: معجزات الرسول………………….. 497
الفصل الخامس: الدليل الرابع: البشارة ببعثة محمد……………….. 505
مناقشة ما قيل عن البشارة بمحمد………………………. 514
الفصل السادس: الدليل الخامس: إنقلاب الدنيا مع بعثة محمد…………………. 519
حال العالم قبل بعثة محمد وبعدها……………………….. 521
الرد على مقولة إنقلاب الأمور ببعثة محمد………………… 523
الرد على شبهة التجسيم………………………………. 524
الرد على شبهات النصارى والمجوس…………………… 526
الرد على شبهة عبادة الأصنام………………………… 529
الرد على ادّعاءات أخرى……………………………… 530
كثرة الأتباع ليست بدليل………………………………. 532
الفصل السابع: الدليل السادس: صفات محمد وأخلاقه…………………… 539
صفات محمد الحسّية والعقليّة……………………………. 541
الطعون على الاستدلال بصفات محمد……………………. 544
ردود المسلمين على الطعون…………………………… 547
مكتبة البحث……………………………………………….. 549
المحتويات…………………………………………………. 573
 دار بيبليون
دار بيبليون