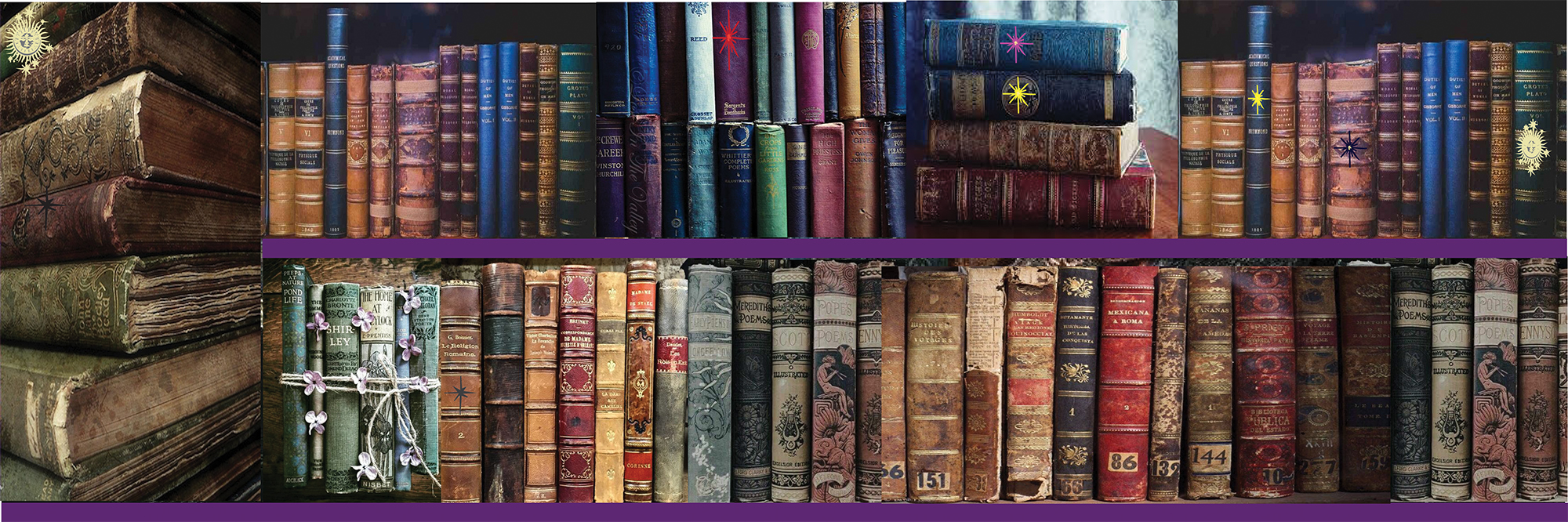مقدمة وغلاف كتاب “المسيحية بين البوذية والإسلام: مشتركات ومفترقات”/ تأليف لويس صليبا
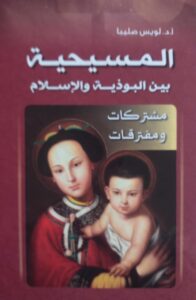
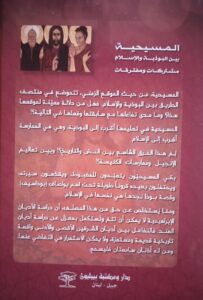
المؤلّف/Author :أ د. لويس صليبا Dr Lwiis Saliba
مستهند وأستاذ في الدراسات الإسلامية والأديان المقارنة
عنـوان الكتاب : المسيحية بين البوذية والإسلام: مشتركات ومفترقات.
Christianity between Buddhism and Islam : Title
عدد الصفحات : 429 ص
سنة النشر : طبعة أولى 2018 ، طبعة ثانية: 2018
الـنـاشــــــر : دار ومكتبة بيبليون
طريق المريميين – حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس ، لبنان
ت: 540256/09-03/847633 ف: 546736/09
www.DarByblion.com
Byblion1@gmail.com
2018 ©- جميع الحقوق محفوظة
ديباجة الكتاب
مدخل إلى دراساته وعمارته
المسيحية وموقعها بين البوذية والإسلام
المسيحية، من حيث الموقع الزمني، تتموضع في منتصف الطريق بين البوذية والإسلام. فقد ظهرت بعد البوذية بنحو خمسة قرون ونصف، وقبل الإسلام بستة قرون ونيّف. فهل من دلالة معيّنة لموقعها هذا الذي يتوسّطُ ظهورَ ديانتين عالميّتين أخريين؟!
وما مدى تفاعلها مع سابقتها وفعلها في التالية؟! وما هي نقاط الشبه أو المشتركات بينها وبين الديانة السابقة والتالية؟ وأين تكمن نقاط الخلاف أو المفترقات؟
أسئلة كبرى لا يطمح هذ الكتاب أن يجيب عنها كلّها، فهو أمرٌ يتخطّى حجمه المحدود بمراحل. حسبه أن يمهّد للإجابة، ويسلّط الأضواء على عدد من المشتركات والمفترقات المهمّة في سبيل حوار مثمر بين الأديان ولقاء بينها هو بلا ريب أساس أي سلم عالميّ يُرجى.
شتّان بين مسيحية النصّ ومسيحية التاريخ
المسيحية في تعليمها أقرب إلى البوذية، وهي في الممارسة أقرب إلى الإسلام. فشتّان بين مسيحية النصّ، ومسيحية التاريخ!!
النصّ تعليم واضحٌ لا لُبس فيه في اللاعنف، وفي فصل الدين عن الدولة وما بين ما هو لقيصر، وما هو لله. أما الممارسة ففلسفت العنف وأضفت على الحرب طابع الإلهي، وجعلتها حرباً مقدّسة. كما جعلت من المعتقد ديناً للدولة الرومانية، ومن الكنيسة حامية هذه الأخيرة ومحميتها في آن!!
لِمَ هذا الفرق الشاسع بين النصّ والتاريخ؟! وبين تعاليم الإنجيل وممارسات الكنيسة؟! ومن هو المسؤول عن هذا الانحراف الخطير الذي قلب وجه الدين الناشئ رأساً على عقِب؟!
هذا ما تحاول بحوثُ هذا المصنّف أن تجيب عنه. لا سيما من خلال دراسات مقارنة بين ديانة الناصريّ وسابقتها.
انحراف منذ زمن قسطنطين
وهي تتوقّف لتتبصّر مليّاً في التحوّل الخطير الذي عرفته الكنسية مع الأمبراطور قسطنطين. انحراف وسمها وحدّد تاريخها ومسارها لقرون طويلة من الزمن. إنه إغراء السلطة والحياة الدنيا، ومن يقدر على مقاومته وتفادي الوقوع فيه سوى القدّيسين وهم قلّة واستثناء؟! وهذا ما جعل المؤرّخ الكاثوليكي بول جونسون يتساءل: «هل استسلمت الأمبراطورية للمسيحية؟ أم أن المسيحية زنت مع الأمبراطورية؟» كما يرد في ب3/ف1 (فق: قسطنطين وأشوكا).
وبالمقابل خاضت البوذية مع أشوكا تجربة مختلفة، بل هي على طرفي نقيض من تجربة قسطنطين: اهتداء أشوكا إلى البوذية جعله يُقْلع عن مواصلة حروبه وانتصاراته العسكرية الكبرى. وهو كذلك لم يستجب لإغراء جعل البوذية ديناً للدولة. فالبوذيّون لم ينقضّوا على الهندوس عندما حكموا الهند، ولا الهندوس فعلوا ذلك عندما كان الحكم بأيديهم. وهي ظاهرة لم يعرفها شرق الأديان الإبراهيمية. ويجدر به أن يتبصّر بها…ويتعلّمَ شيئاً لحاضره منها.
في الدعوة إلى اللاعنف تلتقي المسيحية والبوذية، وتفترقان في وضعها موضع التنفيذ والتطبيق!
فشل المسيحية فـي كسر حلقة العنف المفرغة
المسيحية فشلت، أقلّه حتى اليوم، في أن تعيش اللاعنف الذي تدعو إليه! وكسر حلقته عبر تعليم الإنجيل: «من ضربك على خدّك الأيمن در له الأيسر». فهذا التعليم السامي عاشه أفراد قدّيسون، كانوا شواذاً عن القاعدة العامّة والسائدة في المجتمعات المسيحية.
أما البوذية، فقدّمت مع أشوكا وغاندي والدلاي لاما الحالي، نماذج جماعية معاشة من تعليمها.
مسيحية التاريخ غرقت في العنف: عنف في داخلها بين المذاهب المختلفة، وعنف في مواجهة الأديان الأخرى. وكم سالت الدماء أنهاراً بينها وبين اليهود…وبينها وبين الإسلام كذلك. وكأن الأديان الأبراهيمية الثلاثة لم تألف أن تعيش معاً بسلام. أو أن الحروب بينها كانت هي القاعدة، والسلم الأهلي شواذاً أو استثناء.
وتبقى الإشكالية تكمن في التالي: هل هي مجرّد مصادفة أن تلتقي المسيحية والبوذية في الدعوة إلى اللاعنف، ومواجهة العنف بنقيضه؟ وأن تلتقيا كذلك في الفصل بين الدين والدولة؟
فمن أين استوحت الأولى هذا التعليم المناقض لتعاليم اليهودية التي انبثقت منها؟
التفاعل المفترض بين البوذية والمسيحية
كثرٌ اليوم هم الباحثون والمؤرّخون الذين يرون تفاعلاً واضحاً بين المسيحية والبوذية التي سبقتها بأكثر من خمسة قرون. أما صلة الوصل فـ أشوكا ورسله إلى هذه المنطقة. فقد جابوا الممالك الهلّينية، ولا سيما مملكتي البطالسة في مصر والسلوقيين في سوريا، ونقلوا تعاليم المغبوط إلى هذا الجزء من العالم القديم. ولا يمحّص هذا المصنّف هذه الفرضية ويدقّق ليفصل الخطاب فيها. ولكنه بالمقابل لا ينفي هذا الاحتمال. فللبوذية أثرٌ في العديد من تيّارات الفلسفة والتصوّف كالأفلاطونية المحدثة والفيثاغورسية وغيرها، فهل يُستبعد أن يكون لها الأثر عينه في الدين الناشئ، مباشرة، أو عبر هذه الأخيرة؟!
بوذا فـي التقليدين المسيحي والإسلامي
بقي المسيحيّون يتعبّدون للمغبوط، ويقدّسون سيرته، ويحتفلون بعيده قروناً طويلة تحت اسم يواصاف (بوذاسيف)، كما بيّن المؤلف كاتب هذه السطور في دراستين سابقتين له([1])([2]) وهذا لوحده أليس دليلاً على عمق التفاعل بين التقليدين؟!
وقصة بوذا نجدها هي نفسها في الإسلام عبر سيرة الصوفي إبراهيم بن أدهم ، وعبر قصة بوذاسيف الحاضرة في التقليدين الإمامي (ابن بابويه القمّي)، والإسماعيلي. والأثر البوذي في التصوّف الإسلامي واضح وضوحه في الروحانية الرهبانية المسيحية كما بيّن الباحث في دراسة آنفة([3])
قراءة نقدية فـي سبيل الانخراط فـي حوار الحضارات
ولكن هذا السِفر لا ينتصر للبوذية، ولا هو يتحامل على المسيحية، ولا على الإسلام، كما قد يتراءى للبعض فهو يصف واقعاً ليس إلا. وإذا كان يدعو إلى اللاعنف، فهل في هذه الدعوة ضير أو انحياز؟! وها هي الكنسية اليوم، كما تبيّن أبحاث هذا المصنّف، قد قرأت تاريخها قراءة نقدية، وأقرّت بالأخطاء والخطايا. وهو السبيل الوحيد لتصويب المسار والانخراط في حوار الحضارات والديانات وتحاشي صدامها. وهذا تحديداً ما يريده إنسان اليوم. فقد سئم من العنف والحروب. وإذا كانت الأديان مولّداً دائماً للعنف والحروب فستنال هي الأخرى نصيبها من سأمه وشجبه! وقد وعى البابا يوحنا بولس الثاني هذا الخطر الداهم، وفطن إلى أن الحروب الدينية تقف وراء تفشّي ظاهرة الإلحاد، كما بيّن الباحث في دراسات سابقة.([4])([5]) وفلاسفة الغرب والإسلام، هم في الغالب فلاسفة حرب، قالوا بحتميّتها، انسجاماً ربما مع التقليد والعقلية التي نشأوا في كنفها. فذهبوا إلى أن الإنسان عاجز عن تجنّب الحروب وتخطّي العنف. وهم في ذلك لم يفعلوا سوى أنهم حلّلوا ووصفوا تاريخاً عرفوه، وواقعاً عاشوه، كما يبيّن أحد مباحث هذا السفر.(ب3/ف5).
وكما الفلاسفة كذلك المؤرّخون في الغرب والمشرق، إذ كانوا، وما يزالون، ذاكرة الرعب والهول والتدمير. يؤرّخون الظلم والحروب والبربرية حتى جعلوا من تاريخ البشرية تاريخ حروب، كما تذكر خاتمة الأبواب الثلاثة الأولى. أما الشعوب المسالمة فغالباً ما يغفلها المؤرّخون. لكأن التاريخ لا يحبّ السلم، وكأن الحرب قد خلقته
أشوكا وغاندي أسقطا معادلة حتمية الحرب
ولو عرف الفلاسفة والمؤرخون كلاهما، في ثقافتهم أو في تاريخهم، ظاهرة مشابهة لـِ أشوكا أو غاندي، لفكّروا مطوّلاً قبل تعميم نظريّاتهم هذه. وهذا تحديداً ما يتدارسه الإنسان المعاصر، ويتبصّر فيه. فهو يرفض واقع الحرب والعنف والإرهاب كحتميّة وإذا كان يدير وجهه نحو الشرق الأقصى، ولا سيما الهند وتقاليدها الروحية والدينية، فلأنه يعي أنها عرفت اللاعنف، وعاشته ومارسته، ونجحت في هذه الممارسة.
إنها زبدة ما استخلصه الباحث من دراسات مصنّفه هذا. وهي في الأصل أعمال ندوات ثلاث أو أربع نُشر بعضها ([6])([7]).
فماذا الآن في التفاصيل؟ أي في فصول هذا الكتاب وعمارته؟
الباب الأول ب1: “مدخل إلى البوذية” تمهيد بدا ضرورياً. فالقارئ العربي لا يعرف الكثير، بل هو يجهل الأساسي بشأن البوذية، وما يعرفه، أو هو بمتناوله في لغة الضاد، ملقوط مخلوط طبقاً لتعبير البيروني.
والفصل الأول ب1/ف1: “بوذا تاريخاً وتعاليم” لا يروي سيرة بوذا، فأكثرها معروف، ولكنه يركّز على تاريخيّة هذه الشخصية، وعلى ركن الزاوية في تعاليمها. التحقّق أو النيرفانا. واللاذات وقانون التغيّر الدائم. ولم يزعم المغبوط يوماً أنه يحتكر الحقيقة، أو أنه علّمها كاملة غير منقوصة. فالحقيقة لا يحصرها تعليم ولا كتاب، وهو لم يعلّم سوى حفنة من الحقائق، وغيرها كثير. وقد رفض غوتاما محاولات تأليهه، وسخر من تلامذته وسائر معاصريه الذين حاولوا ذلك. ورغم موقفه الواضح هذا لم تُحجم الأجيال التالية من الأتباع عن هذا الفعل.
والفصل الثاني ب1/ف2: “فلسفة بوذا في الحكم واللاعنف” يتناول الأساسي من تعاليم المغبوط المختصّة بموضوع الدراسة تحديداً. وصاياه الخمس مقارنة بالوصايا العشر التوراتية. تعليمه في اللاعنف وعيشه لهذا التعليم السامي. ثمّ وصاياه العشر للملوك والحكّام والتي قد تبدو مثالية وطوباوية للكثيرين. ولكن أشوكا بالأمس وغاندي اليوم أثبتا قابلية هذه التعاليم للتطبيق، وحقّقا المعجزة بعيشها ووضعها موضع التنفيذ.
والفصل الثالث والأخير من الباب التمهيدي ب1/ف3: “تشاندرا غوبتا ووزيره مكيافيلّي الهند” يروي سيرة جدّ أشوكا، الأمبراطور تشاندرا غوبتا محرّر الهند من احتلال الإسكندر. كيف وصل إلى السلطة؟ وكيف انقضّ على المحتلّ الإغريقي؟ وكل ذلك بمساعدة وزيره الداهية كاوتيلا الذي غالباً ما عرفه الغرب باسم مكيافيلّي الهند. فقد وضع نظريّات في السياسة والحرب سبق فيها ماكيافلّي وكلاوزفيتر بألوف السنين. وكتاب كاوتيلا وعنوانه أرتا شاسترا كان حقّاً رائداً في علوم السياسة والحرب. فأين يلتقي مع تعليم بوذا؟ وأين يفترق عنه؟ وهل من أثر للمغبوط في نظريّات ماكيافلّي الهند؟ كل هذه الإشكاليّات يطرحها ب1/ف3 ويجيب عنها، ويتوقّف عند العلاقات المميّزة التي ربطت مملكة غوبتا بحكم السلوقيين في سوريا وغيرهم من الحكّام الهلّينيين من خلفاء الإسكندر. وهذه العلاقات هي التي مهّدت لإرساليّات أشوكا إلى الشرق الأوسط والتي سيكون لها أثر حاسم في تقاليد صوفيّة وفلسفية ورهبانية عديدة مثل الأفلاطونية المحدثة وغيرها. أما والد أشوكا الأمبراطور بندوسارا، فكان محبّاً للفلسفة، فرزق بابن فيلسوف سيخلفه على العرش.
والباب الثاني ب2: “الأمبراطور أشوكا تلميذ بوذا الأمين” مخصّص للأمبراطور أشوكا وتجربته الفريدة في التاريخ الإنساني.
والفصل الأول ب2/ف1:”أشوكا ملك محارب يهتدي إلى البوذية” يروي سيرة هذا العاهل قبل اهتدائه إلى البوذية: كيف استولى على العرش وبدأ سلسلة فتوحاته. وكيف اهتدى إلى البوذية التي قلبت حياته رأساً على عقب. ويتوقّف الفصل عند نقوش أشوكا المحفورة على الأعمدة والصخور. إنها أقدم ما وصلنا من وثائق في تاريخ الهند والشرق الأقصى عموماً، وهي مستندات غير قابلة للتزوير والتحريف. وقد تضمّنت مراسيم ملكية غاية في الأهمّية.
والفصل الثاني: ب2/ف2: “مراسيم أشوكا في اللاعنف والتعدّدية الدينية” يورد ترجمة أمينة لأبرز مراسيم أشوكا. مرسوم حرب كالينغا، وفيه يعلن هذا الملك عزوفه عن أي عمل عسكري إثر الفظاعات التي اقترفت في هذه الحرب، والتي كانت من الناحية العسكرية نصراً مبيناً له. ولكنه نصر كانت كلفته جدّ مرتفعة. يذكر أشوكا في مرسومه عدد القتلى والجرحى والأسرى الهائل. ويعلن أنه سيعمد إلى فتوحات من نوع آخر مختلف تماماً: فتوحات الدهارما: الناموس الكوني. أما جنود هذه الفتوحات فسيكونون مبشّري تعاليم المغبوط المسالمين.
ويعمد ب2/ف2 إلى تحليل مرسوم حرب كالينغا أو المرسوم 13 كما يسمّيه المؤرّخون. ويقرأه من زاوية وصايا بوذا للملوك، فيجد أن هذا الملك كان منفّذاً أميناً لها وحريصاً على العمل بها. وقد برهن أن الوصايا هذه ليست مجرّد نصائح وتعاليم طوباوية، بل هي مستمدّة من الواقع. وأشوكا كان بوضعها موضع التنفيذ مثالياً واقعياً، طبقاً لتعبير المهاتما غاندي.
ويقدّم ب2/ف2 ترجمة أمينة لمرسوم آخر لا يقلّ أهمّية عن السابق. إنه مرسوم التسامح. وهو في الحقيقة دستور دولة عصرية تعدّدية، بل علمانية. وبهذا المرسوم أثبت الملك البوذي أنه أقدم مؤسّس نظام علماني في التاريخ.
والفصل الثالث: ب2/ف3: “أشوكا ملك ديموقراطي علماني“. يقدّم ترجمات أمينة لمراسيم أخرى لأشوكا. فالمرسوم الصخري رقم 6 يعلن أن الملك في خدمة شعبه في كل الأوقات.وهو يضحّي بحياته الخاصّة في هذا السبيل. والمرسوم رقم 3 يأمر بتنظيم المراقبة في مختلف أرجاء الأمبراطورية منعاً للفساد. والمرسومان 1 و2 يعلنان عن تأسيس مستشفيات بيطرية وواحات. ولأشوكا إنجازات أخرى في التربية وتعليم النساء وكذلك في العمران. ومن الناحية الدينية فقد دعا إلى المجمع البوذي الثالث، وأرسل المبشّرين إلى كلّ الأصقاع المعروفة في زمنه، لذا اعتبره العديد من المؤرّخين الرجل الثاني في البوذية، والأكثر تأثيراً فيها بعد مؤسّسها. وهو في الخلاصة رائد ديموقراطي علماني لاعنفي، وبهذه الميّزات وغيرها يبدو حاكماً عصرياً معاصراً، وعلى الحكّام الحاليين أن يستلهموا من تجربته الرائدة كما فعل المهاتما غاندي.
ويخلص ب2/ف3 إلى عرض فرضية الأثر البوذي في المسيحية ومناقشتها. وهو وإن لم يتبنّاها، فلا يردّها ويعتبرها قابلة للبحث والنقاش.
والباب الثالث مخصّص لتجربة الأمبراطور الروماني وعنوانه “قسطنطين نموذج مضادّ لأشوكا“. فطالما قارن الباحثون والمؤرّخون بين الأمبراطورين، وسمّوا أشوكا “قسطنطين الهند”. وواقع الأمر أن الثاني نموذج مضادّ للأول كما تبيّن فصول هذا الباب، ومن هنا العنوان.
والفصل الأول،ب3/ف1: “قسطنطين وقصة اهتدائه إلى المسيحية“.يبدأ بنقاط الشبه والاختلاف بين الأمبراطورين. وعناصر الشبه تقتصر على الشكل: كلا الأمبراطورين اهتديا كلّ إلى دين جديد، وخرجا على التقليد الموروث. كلاهما دعيا إلى مجمع ديني وسم الدين بطابعه. ولكن الشبه هذا يقف عند حدود الشكل: فالبوذية قادت أشوكا في أوج انتصاراته العسكرية إلى الامتناع عن الحروب، في حين وظّف قسطنطين ديانته الجديدة أداة في الحشد لحروب جديدة. أشوكا حمى كل الأديان والمذاهب في أمبراطوريّته، وأرسى دعائم نظام علماني يفصل بين الدين والدولة. في حين جعل قسطنطين وخلفاؤه المسيحية ديناً للدولة، واضطهدوا سائر الأديان. أما ما يُحكى عن اهتداء عجائبي لقسطنطين، فيعمد ب3/ف1 إلى تفنيد رواياته وتبيان ضعفها، ويسبر غور دوافع القيصر لاختيار المسيحية ديناً، ويُظهر أنه بقي زمناً متأرجحاً بين الميثراوية والدين الجديد. وهو لم يحسم أمره إلا عندما رأى أن المصلحة الزمنية تقتضي ذلك. ولكن يبقى أنه كان لرؤية قسطنطين الصليب المزعومة، أثر حاسم في ظهور ما سمّي بالحرب المقدّسة في المسيحية.
والفصل الثاني: ب3/ف2: “قسطنطين والمسيحية التقاء مصالح“يعرض كيف التقت مصالح قسطنطين والمسيحيين. وهؤلاء رغم كونهم أقلية كانوا أقلّية منسجمة تواجه أكثرية مبعثرة ومفكّكة. وقد أثبت تاريخ البشرية العسكري والسياسي والاجتماعي أن قوة الجيوش والمجتمعات لا يلعب العدد الدور الحاسم فيها بل الوحدة والانسجام. وقد أدرك قسطنطين بحذقه السياسي والعسكري أنه من الخير له أن يحالف أقلّية منظّمة ومنسجمة وموحّدة الأهداف والرؤى، من أن يركن ويستند إلى أكثرية شرذمتها الخلافات والمطامع. وهكذا كانت المسيحية خياراً سياسياً وعسكرياً له، قبل أن تكون خياراً إيمانياً ودينياً.
والفصل الثالث، ب3/ف3: “منشور ميلانو: حمى المسيحيين ثم انقضّوا عليه“. يورد ترجمة للنص الكامل لهذا المرسوم، ثمّ يعلّق عليه، ويقرأ بنوده قراءة نقدية. فهو يمنح المسيحيين وغيرهم من مواطني الأمبراطورية الرومانية حرّية العبادة. ولكن أتباع الناصري استفادوا منه للتمتّع بهذه الحرّية، وعندما انقلب ميزان القوى لمصلحتهم انقضّوا على الحرّية هذه. وكان منشور ميلانو مجرّد هدنة، وبيّن تاريخ الغرب والمسيحية أن لا محلّ فيه للتعدّدية الدينية.
والفصل الرابع، ب3/ف4: “المسيحية من دين مضطهَد إلى مضطهِد“يضع الإصبع على الجرح: أين وكيف ومتى بدأ الانحراف؟ فقسطنطين، وخلافاً للتعليم الإنجيلي، خلط بين ما لقيصر وما لله. والكنيسة أصيبت بعدوى التسلّط، فما أن ذاق رؤساؤها طعم السلطة وحلاوتها، حتى تصرّفوا كما الولاة والأباطرة. ومنحت الكنيسة الأمبراطور قداسة أغنته عن دعوى الألوهة. وبالمقابل سطا البابا على لقب “الحبر الأعظم” وكان الأمبراطور قد تخلّى عنه. فصار حاكماً زمنياً. واتّجهت المسيحية في مسار تصاعدي لتصير دين الدولة الرومانية الوحيد. وثبّتت تدريجياً وضعيّتها هذه. وما أن نجحت في ذلك حتى انقضّت على أتباع الملل الأخرى من وثنيين ويهود. فبقي الاضطهاد ولكن تغيّرت هويّة المضطهِد والمضطهَد. وأثبت تاريخ الأديان الإبراهيمية عموماً، والمسيحية خصوصاً أن التعدّدية مصطلح دخيل ومحدث في قاموسها.
والفصل الخامس، ب3ف5: “مداخلات مؤتمر لماذا الحرب“. يجمع مختلف مداخلات الباحث في المؤتمر المذكور. ولا سيما ردوده على الأسئلة والمداخلات المعقّبة على بحثه المقارِن بين أشوكا وقسطنطين. وقد اعتبر فيها أن المسيحية ديانة سلام تورّطت في الحروب. وطال تورّطها هذا وامتدّ إلى قرون عديدة. ويبقى أشوكا تحدّياً كبيراً أمام الإنسان المعاصر الباحث عن متنفّس في دنيا الحروب الخانقة. فتجربته الرائدة تؤكّد أن الحروب ليست حتمية تاريخية كما يصوّر أكثر الفلاسفة والمؤرّخون. ويقارن الباحث جواباً عن سؤال بين أشوكا وحمورابي، فيجدهما نموذجين متناقضين: حمورابي أقرب جغرافياً، ولكنه أبعد زمناً وذهنية. وهو وإن شابه الأمبراطور الهندي في نقوشه ومراسيمه الصخرية، فذهنيّته ذهنية عسكرية حربية، وشريعته شريعة العين بالعين، وأشوكا نقيض كل هذا.
ويختم الباحث مداخلته الجوابية في موضوع الأثر البوذي المحتمل في المسيحية ناقلاً طروحات بعض الباحثين في الموضوع، والقائلة: “بين شريعتي التوراة والإنجيل قطيعة واضحة لا تُفهم على حقيقتها من دون الأثر البوذي”!
وتختتم الأبواب الثلاثة الأولى من الكتاب بمحصّلة وخلاصة تقول: إذا كان عالم الإنسان مريض بالحروب وتاريخه تاريخ حروب، فهذا لا يعني أنه يقتضي عليه أن يستسلم لهذا الواقع كحتمية لا علاج لها. ففي هذا النفق المظلم أشعل أشوكا وتلميذه غاندي شمعة لا تزال تهدي وتضيء، والظلمة، مهما كانت حالكة، فهي لن تقوى على إطفاء هذه الشمعة.
والباب الرابع: “المسيحية والإصلاح الديني” هو أطول الأبواب وأكثرها فصولاً. ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأبواب الثلاثة الأولى، ويأتي بمثابة تكملة لها.
فالفصل الأول، ب4/ف1: “انحراف منذ زمن قسطنطين” يعود إلى زمن القيصر الروماني ليستبين مكمن الخلل. فمن دون معرفة ذلك لا سبيل للإصلاح، ولا حظّ له في النجاح. وهنا يعود ليكرّر أن الانحراف القسطنطيني تجسّد في محورين: الانتقال من سلام الإنجيل ودعوته الواضحة إلى اللاعنف إلى مبدأ الحرب المقدّسة. وجعل المسيحية ديناً للدولة.
والفصل الثاني: ب4/ف2: “الإصلاح البروتستانتي وموقفه من الدولة والعنف” يغربل حركة لوثر وزملائه وينقدها من هذه الزاوية تحديداً: ماذا فعل الإصلاح البروتستانتي ليعالج هذين الانحرافين؟!
فيتبيّن أن العنف والخلط بين الكنيسة والدولة حكما مسيرة لوثر. وقد أجرى إصلاحُه الدماء أنهاراً! وأين الإصلاح في كلّ ذلك؟!
والفصل الثالث، ب4/ف3: “عوامل نجاح الإصلاح البروتستانتي” يتساءل: إذا كانت هذه حال الإصلاح اللوثري بشأن العنف والعلاقة بين الكنيسة والدولة، فما الذي جعله ينجح ويستمرّ. فيورد خمسة عوامل ويتوقّف عند كل واحد منها محلّلاً مفنّداً: العامل الجرماني القومي، ودعم الأمراء للوثر، ومسألة الغفرانات، ووضع البيبليا بمتناول الجميع، وأخيراً اختراع الطباعة، فـَ غوتنبرغ أبرز عوامل نجاح لوثر. وقد لعبت الطباعة يومها الدور الذي لعبته وسائل التواصل في ما سمّي الربيع العربي.
والفصل الرابع، ب4/ف4:”الإصلاح المتواصل عبر تاريخ الكنيسة”
يُظهر بالمقابل أن كنيسة المسيح لم يعوزها مصلحون عبر تاريخها الطويل. ففي كل زمن وعصر ظهر مصلح. ويضرب على ذلك مثلين: أمبروسيوس (340-397) أسقف ميلانو، وفرنسيس (1181-1226) “بوذا المسيحية”.الأول فصل تماماً بين السلطتين الروحية والزمنية والثاني أسّس أولى رهبنات الصدقة، وعاش فقراً حقيقيّاً، وكان مثالاً في اللاعنف وفي الحوار مع الآخر، ولا سيما الإسلام.
والفصل الخامس، ب4/ف5: “الإصلاح المضادّ“. يتناول ردّة الفعل الكاثوليكية على الإصلاح البروتستانتي. ويركّز على وجهين منها: المجمع التريدنتيني وما أدخل من تغييرات، والرهبنة اليسوعية ودورها في ترسيخ سلطة البابا، وفي تأسيس المدارس والجامعات والمطابع وغيرها.
والفصل السادس ب4/ف6: “يوحنا 23ً بابا الإصلاح“. يؤكّد أن الإصلاح الحقيقي كان في المجمع الفاتيكاني الثاني. أما المصلح الفعلي فكان البابا يوحنا 23ً الذي دعا إليه. ومعه انتقلت الكنيسة من النهج الدفاعي إلى النقد الذاتي. وعرفت انفتاحاً ثلاثيّ الأبعاد والاتجاهات: على المسيحيين من غير الكاثوليك، وغير المسيحيين من يهود ومسلمين، وغير المؤمنين ممّن سمّاهم البابا “ذوي الإرادة الطيّبة” وصارت الحرب المقدّسة في خبر كان. وتحقّق الفصل النهائي بين الكنيسة والدولة والسلطتين الزمنية والروحية. وقد سار خلفاؤه من الباباوات في الدرب الذي شقّه.
والفصل السابع، ب4/ف7: “الإصلاح في الكنيسة المارونية“. يعرض للإصلاح في الكنائس الشرقية. ويأخذ الكنيسة المارونية نموذجاً. كيف تفاعلت هذه الكنيسة مع دعوة المجمع الفاتيكاني الثاني إلى الإصلاح؟ ويركّز على الإصلاح الليتورجي، وما عرفته الطقوس من تجديد، وعودة إلى الجذور في آن. ويسلّط الأضواء على روّاد الإصلاح الموارنة.
والفصل الثامن، ب4/ف8: “دروس من التجربة المسيحية في الإصلاح” يتناول الإصلاح بين البابوين بنديكتوس 16ً وخلفه فرنسيس. ليركّز بعدها على سبل الإفادة من الإصلاح المسيحي. ويرى أن أبرز ما يمكن يتعلّم أتباع الملل الأخرى منه هو الجرأة على القراءة النقدية كلٌّ لتاريخه. والإصلاح يكمن أولاً في إصلاح النظرة إلى الآخر، والكفّ عن تكفيره، وفي تطهير النصوص والنفوس من شوائب العنف ورواسبه لوقف حلقة الإرهاب المتمادي.
والفصل التاسع، ب4/ف9: “مداخلات ندوة الإصلاح الديني“. وهو يضمّ مختلف مداخلات المؤلف في تلك الندوة مقسّمة تبعاً للجلسات.وأبرزها ردوده على الأسئلة التي طرحت عليه بعد إلقاء محاضرته في تلك الندوة، وتعقيبه على المداخلات التي تلتها. وفيها أعاد طرح السؤال: هل نجرؤ على قراءة نقدية لتاريخنا؟! وأبدى تفهّماً للتحسّس الإسلامي من محاولات التبشير في البلدان العربية والإسلامية، ودعا إلى وحدة معايير في التعامل مع التبشير المسيحي والدعوة الإسلامية. كما تناول مفهوم الجهاد في الإسلام، وبيّن أنه محدث. ودعا إلى وجوب الإقرار بأن الكهانة في الإسلام وسائر الأديان هي أمر واقع، وإن لم يعترف بعضها بدور الوسيط بين الله والإنسان. والتعامل بالتالي معها انطلاقاً من هذا الواقع. وأكّد أن تأوين النصّ هو اليوم ضرورة ملحّة، والمسيحية كانت سبّاقة في هذا المجال. ويبقى أن نجاح أي إصلاح يشترط بادئ ذي بدء استقلالية الديني عن السياسي.
والباب الخامس والأخير، ب5: “جدلٌ فحوار بين المسيحية والإمامية” تتموضع المسيحية فيه في موقعها التاريخي السابق للإسلام. إلى أي مدى كانت فاعلة، أو مؤثّرة فيه؟! أسئلة كبرى يكتفي الباحث بالإجابة عنها من زاوية التفاعل المسيحي-الإمامي.
وهو موضوع لم يطرق بعد كما يجب، ولم يحصل على ما يستحقّ من اهتمام الباحثين والدارسين وروّاد الحوار بين الديانتين.
والفصل الأول، ب5/ف1: “تجربة في حضرة الإمام الرضا” يتناول أثر الإمام الرضا في تاريخ إيران. ثم يروي تجربة صوفية للمؤلف في مقامه في مشهد. ويستخلص منها عناصر حوار وتقريب بين المسيحية والإمامية. فشعائر زيارة مقامات الأولياء والقدّيسين تتشابه بين التقليدين، بل ثمة تفاعل وثيق بينها.
والفصل الثاني، ب5/ف2: “نص مجلس الرضا مع أهل الأديان عند المأمون”.هو في الحقيقة نقل أمين لرواية الشيخ الصدوق ابن بابويه القمّي لوقائع هذا الحدث. وهو النصّ الذي سيكون موضع دراسة وتحليل في الفصل التالي.
والفصل الثالث، ب5/ف3: “قراءة نقدية لـِ مجلس الرضا مع أهل الأديان“. يفنّد نصّ رواية الصدوق هذه. والبداية: صحّة النسبة: نصّ مستفيض، يذخر بالمواقف الدقيقة والعبارات الاصطلاحية دوّن بعد قرن ونصف من الحادثة! فكيف يمكن الركون إلى صحّته؟!
أما مشاركة جاثليق النصارى في المجلس المذكور فهي مستحيلة، لأنه كان في أيامه الأخيرة، ويستحيل أن يكون قد غادر بغداد يومها إلى مرو حيث انعقد مجلس الرضا المزعوم.
هذا من ناحية الشكل، وسند الحديث وشخصيّاته. ماذا في المضمون؟ إنه في الجملة لا يضيف جديداً إلى تراث الجدل المسيحي-الإسلامي. وهو يكرّر ما نجده في مصادر إسلامية جدلية سابقة له. وهنا تدخل القراءة النقدية في تفاصيل رواية الصدوق عن مجلس الرضا. فقد تضمّنت أخطاءً تاريخية وكتابية بيبلية عديدة. فهي تنسب إلى إنجيل يوحنا وغيره من الأناجيل آيات غير موجودة فيها. وتكرّر الخطأ عينه بشأن التوراة، ولا سيما سِفر المزامير منها. وتجعل يوحنا الديلمي يتنبّأ بمجيء رسول الإسلام، وقد ولد بعد الهجرة بنحو أربعين سنة! أما ما تورده رواية الصدوق من معطيات عن الأناجيل وكتّابها، فأكثرها ملقوط مغلوط مخلوط.
أياً يكن فالجدل بحدّ ذاته من شأنه أن يكون تنفيساً للعنف والاحتقان. والنبش في نصوص الآخر، وإن بحثاً عن نقاط الضعف، فهو مدخل لمعرفته كما هو ومن كتبه. وفي رواية مجلس الرضا عناصر عديدة يمكن الإفادة منها في سبيل حوار مسيحي-إسلامي بنّاء.
والفصل الرابع، ب5/ف4: “ندوة الحوار المسيحي-الإمامي“. يتوقّف عند التعاطف المسيحي التاريخي مع الشيعة، ويحلّل أسبابه وخلفيّاته. فالفريقان كانا ضحية الاضطهاد والمضطهِد عينه.
أمّا المشتركات فعديدة، ويتوقّف ب5/ف4 عند أبرزها: مراسم عشوراء وما فيها من تفاعل مع طقوس جمعة الآلام عند المسيحيّين. ويستند إلى دراسة ميدانية مقارِنة لطقوس الجماعتين. ويشير إلى السمات المشتركة في الاحتفالين، ويحلّلها. والخلاصة فالعقائد مختلفة، بل ومتضاربة، ولكن الاختبار الروحي في هذه الطقوس واحد ويوحّد. ويبقى تشابه الطقوس نقطة لقاء بالغة الأهمّية.
بيد أن معوقات الحوار عديدة، ولا يجب الاستخفاف بها. وهي تتطلّب مجهوداً جدّياً من الطرفين. وأولها ما في فقه الإمامية من تكفير للآخر مسيحياً كان أم لا. وكذلك تحريم أكل ذبائحه، بل ومجمل طعامه أحياناً!
وباختصار معبّر، فلا بدّ من الحوار، لأن البديل عنه هو العنف والحرب! فهل يجوز أن يبقى أيّ من الفريقين غافلاً لذلك؟!
اللاعنف هو القاعدة وليس الاستثناء
وختاماً: أسئلة وإشكاليات خطيرة يتدارسها هذا السِفر، وتتناول كبرى المعضلات التي يطرحها إنسان اليوم: عنف الأديان الإبراهيمية: جذوره وأسبابه، وإمكانيّات معالجته، العلاقات بين هذه الأديان، وبينها وبين الملل الأخرى.
كلّها مواضيع الساعة، كما كانت مواضيع ملحّة منذ ألوف السنين، وستبقى. فما من عصا سحرية للحلّ، ولكن التفكّر والتبصّر يبقى أولى الخطوات نحوه.
وهو سِفر يطمح إلى لقاء بين الأديان، رغم أن بعضها، ولا سيما ذاك المتورّط في العنف حتى أذنيه، قلّما يحفل بالحوار وما يُرجى منه.
ويحكم هذا المصنّف على المسيحية بأنها فشلت حتى اليوم في عيش اللاعنف الذي تدعو إليه! ولكنه ليس حُكماً عامّاً مبرماً، فالاستثناء ليس بغائب، ومرشّح أن يصير هو القاعدة. ويبقى أن الحكم المذكور حكم جريء، ونقد ذاتيّ في سبيل الإصلاح وتصويب المسار. وقد وعى أحبار الكنيسة ذلك، وأوّلهم يوحنا 23ً، ويوحنا بولس الثاني. والبابا فرنسيس يسير اليوم في هذا الاتّجاه.
دراسة الأديان الإبراهيمية لا تكتمل بمعزل عن أديان الهند
وممّا يُستخلص عن حق من هذا المصنّف، أن دراسة الأديان الإبراهيمية لا يمكن أن تتمّ وتُستكمل بمعزل عن دراسة أديان الشرق الأقصى، وعلى رأسها أديان الهند. وإلا فاللوحة المرسومة ستبقى ناقصة ومبتسرة. فالتفاعل بين أديان الشرقين الأقصى والأدنى واقعة تاريخية قديمة ومستمرّة، ولا يمكن الاستمرار في التغاضي عنها. ومن له أذنان سامعتان فليسمع.
Q.J.C.S.T.B.
باريس في 9/10/2017
[1]-صليبا، د. لويس، أقدم كتاب في العالم ريك ڤيدا دراسة ترجمة وتعليقات، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيليون، ط4، 2016، ب4/ف1، فق: بوذاسف، ص189-191.
[2]-صليبا، د. لويس، زرادشت وأثره في الأديان الخمسة الكبرى إيران المجوس جسر عبور بين أديان الشرقين الأقصى والأوسط، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2017.
[3]-صليبا، لويس، زرادشت، م. س.
[4]-صليبا، د. لويس، عنف الأديان الإبراهيمية حتمية أم خيار؟ أعمال المؤتمر المسيحي-الإسلامي، الصرفند/جنوب لبنان 2015، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2018، ص77-78.
[5]-صليبا، د. لويس، الإسلاموفوبيا.نحو صدام بين عالمين بحث في علاقات الإسلام المعاصر بالمسيحية والغرب، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2018، ب2/ف3، ص206-207
[6]-صليبا، د. لويس، الحرب في البوذية وفي المسيحية دراسة مقارنة لتجربتي الأمبراطورين أشوكا وقسطنطين، ضمن لماذا الحرب، أعمال المؤتمر الفلسفي الدولي 9 و10 كانون الأول 2016، بيبلوس، المركز الدولي لعلوم الإنسان برعاية اليونسكو، ط1، 2017، ص25-99.
[7]-صليبا، د. لويس، التجربة المسيحية في الإصلاح، قراءة نقدية وتعقيب، ضمن: في إصلاح المجال الديني، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية في الحمّامات/تونس، 27-29/11/2016، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص163-185، وص201-202.
 دار بيبليون
دار بيبليون