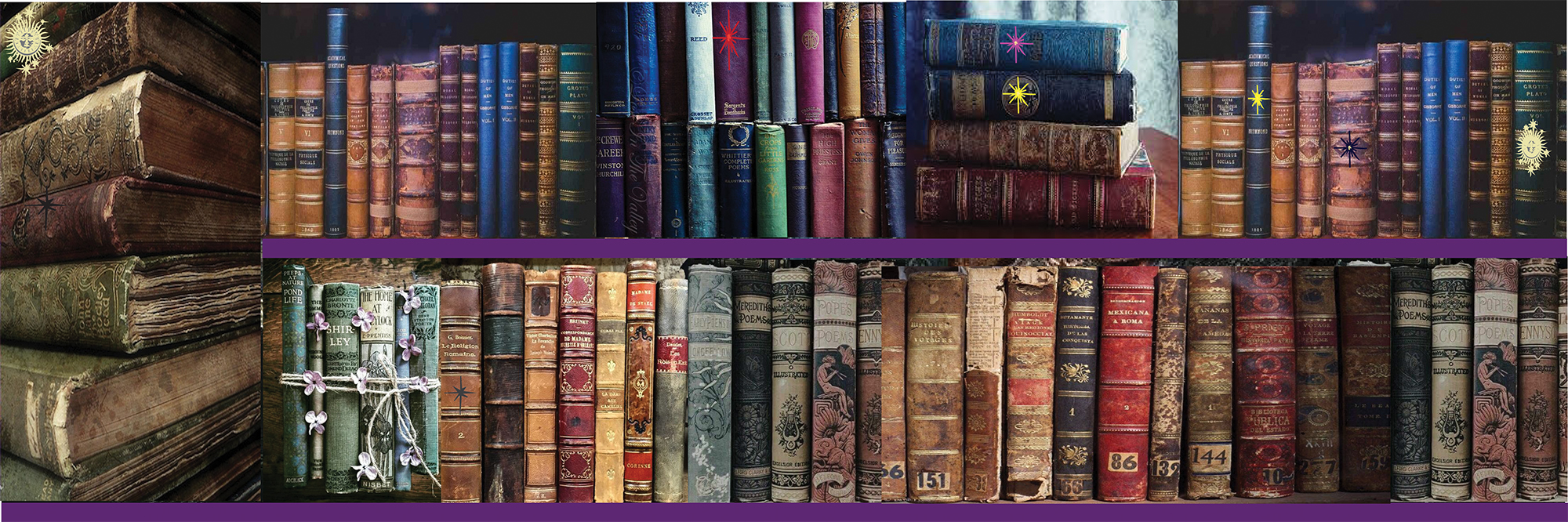مقدمة وغلاف كتاب “زرادشت وأثره في الأديان الخمسة الكبرى”/ تأليف لويس صليبا
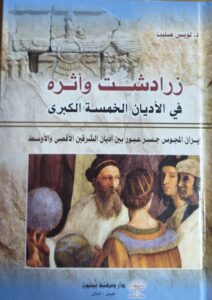

المؤلّف/Author : أ د. لويس صليبا Prof Lwiis Saliba
مستهند وأستاذ في الدراسات الإسلامية والأديان المقارنة
عنـوان الكتاب : زرادشت وأثره في الأديان الخمسة الكبرى
إيران المجوس جسر عبور بين أديان الشرقين الأقصى والأوسط
Title : Zarathustra and his impact on the five major religions
عدد الصفحات :521ص.
سنة النشر : طبعة خامسة: 2022، طبعة رابعة:2018 ، ط3: 2018، ، ط2: 2017، ط1: 2017
الـنـاشــــــر : دار ومكتبة بيبليون
طريق الفرير – حي مار بطرس- جبيل/ بيبلوس ، لبنان
ت: 540256/09-خليوي: 03/847633 ف: 546736/09
Byblion1@gmail.com www.DarByblion.com
2022©- جميع الحقوق محفوظة. يمنع تصوير هذا الكتاب، كما يمنع وضعه للتحميل على الإنترنت تحت طائلة الملاحقة القانونية
فذلكة الكتاب
مدخل إلى بحوثه وطروحاته
عناوين المدخل:
– من مقارنة الأديان إلى دراستها من الداخل.
– توافق الدين والعلم أسطورة.
– زرادشت شخصية مهمّشة.
– أثر زرادشت الحاسم في الملل الثلاث.
– الأديان العالمية الخمسة الكبرى.
مصادر البحث: نصوص الزرادشتية وبحوث المستشرقين
– خاتمة.
من مقارنة الأديان إلى دراستها من الداخل
المقاربة الموضوعية في علوم الأديان مسألة بالغة الصعوبة إن لم تكن شبه مستحيلة!!
فأوّل ما يخطر للمرء في مقاربته لأيّ ظاهرة أو موضوع ديني هو مقارنته بدينه. والمقاربة المقارِنة هذه أمرٌ شبه حتميّ، لأن ذهن الإنسان، ولا سيما ملَكة التعلّم فيه، يدرك الأشياء ويفقهها بالمقارنة مع ما يعرف: فإذا كان بصدد تعلّم لغة جديدة مثلاً، فهو يقارنها دوماً بلغته الأمّ ليسهل عليه التعرّف والحفظ، وهكذا…يذكر كاتب هذه السطور من تجربته في تعليم اللغة الفرنسية للعرب، أن للعربي ميل وتوجّه لقول: le porte و Le lune الباب بصيغة المذكر وكذلك القمر لأنهما في لغته الأمّ بصيغة المذكّر، رغم أن ذلك خطأ فادح بالفرنسية. وأوّل ما كان يَنصح به الطالب العربي أو غير الفرنسي عموماً الذي يتعلّم الفرنسية هو أن يفكّر بهذه اللغة مباشرة، وأن يتوقّف عن التفكير بلغته الأمّ، ثم ترجمة ذلك إلى الفرنسية. فمتى بدأ يفكّر باللغة الجديدة التي يتعلّم، دخل في ذهنيتها وذهنية شعبها، وسهُل عليه أن يعبّر عن أفكاره فيها بعبارة صحيحة لا عُجمة فيها. فأن تفكّر بلغة هو أن تدخل حرَمَها، وتدرسها وتتلقّنها من الداخل. وهكذا فلآلية المقارنة، والتعلّم بالمقارنة حدود، وهي سيف ذو حدّين، فإن كانت تسهّل الفهم والتعرّف حيناً، فهي تزيد من اللبس غالباً. وهي في علم الأديان تطيح بإمكانية فهم الآخر كما هو، إذ يُجري المرء عملية إسقاط لاشعورية لعقائده على ما يتعلّم، ويستتبع ذلك عادة مفاضلة، أو أقلّه حكم ضمني على الآخر. وكما أن طالب اللغات لا يتقن لغة ويمتلك ناصيتها، إلا إذا فكّر بهذه اللغة، أي دخل عالمها ودرسها من الداخل، فكذلك دارس الأديان لا يعرف ديناً على حقيقته إلا إذا درسه من الداخل، وعاشه، وتتلمذ عليه، وإن لفترة محدودة. وهذه الدراسة من الداخل لا تمنع المقاربة الموضوعية العلمية، بل هي خير ممهّد لها ومكمّل.
توافق الدين والعلم أسطورة
ولا بدّ من كلمة هنا تتناول المقاربة العلمية في علوم الأديان. وأول ما يُقال هنا أن ما يروّجه رجال الدين عن توافق الدين والعلم وانسجامهما، ليس سوى إشاعة، بل أسطورة، لذرّ الرماد في العيون.
فالدين قِوامه، أو أقلّه أبرز عناصره، الأسطورة والشعيرة (الطقوس) Mythe et Rite. والعلم لا يقنع بالأسطورة تفسيراً للحقائق، بل يعمد إلى تفكيك ما اكتنف الأديان من أساطير بحثاً عن الوقائع. ولو نزعنا من الأديان الإبراهيمية أساطيرها لتخلخلت بنيتُها، بل وسقطت العمارة، يقول الباحث المستهند دو لاكروا F. De La Croix
في الأديان، لا سيما الإبراهيمية منها، ميلٌ واضح وحاسم لإنكار أي تأثر بدين آخر. والعلم يرفض هذا الطرح، ويقول بتفاعل الأديان. الأديان تقول إن مصدرها وحيٌ سماويّ، ولا تعترف بمصدر آخر، والعلم لا يقرّ مصدراً كهذا، وإن كان لا ينفيه تماماً. ويقول ما من شيء، أو أحد، يبدأ من الصفر، ويضع فرضية الوحي السماوي جانباً عندما يبحث في تفاعل الأديان.
الأديان تقدّس الأشياء والأشخاص والنصوص، وتحرّم مقاربة ما قدّسته مقاربة علمية، لا مناص لها من أن تنزع طابع القدسية عنه. وهنا يعلو الصراخ وتُروّج مزاعم المسّ بالمقدّسات وتدنيسها. أما العلم، فيرفض من ناحيته كلّ تقديس، ولا يفرّق في مقاربته بين نصّ ديني اعتُبر مقدّساً، ونصّ لم تُسبَغ عليه هذه الصفة. لا سيما وأن التقديس يحمي الأساطير، ويحرّم نقدها وتفنيدها، وهي بحرمتها تسيطر على فكر الإنسان، وتهيمن على حياته.
زرادشت شخصية مهمّشة
يدرك الكاتب تماماً حساسية موضوع هذا الكتاب، والتفتيش عن أثر لدين يراه البعض قديماً وبدائياً وشبه منقرض، في أديان كبرى تحتلّ اليوم واجهة الصدارة عدداً وأثراً وتأثيراً. وإذا عدنا إلى مَثَل اللغة الأمّ وتعلّم لغة أخرى الآنف الذكر، فالمرء يألف لغته الأم، ويعشقُها، فيخالها أجمل لغات الأرض، بمجرّد الإلفة هذه. وهذا لا يعني أن العربية أفضل من الفرنسية مثلاً، وأكثر بلاغة، ولا العكس. ولكن الإنسان لا ينفكّ يقارن ويفاضل، وكذا القول في الدين. وهنا تحديداً سبب حساسية موضوع هذه الدراسة. فزرادشت (أو زارا) شخصية دينية محورية ومركزية بقيت مغيّبة عن الواجهة والدراسات والبحوث حقبة طويلة. ولعلّ أول من ذكّر العالمَ، ولا سيما الغرب، بهذا النبي المنسي كان نيتشه في مصنّفه الشهير هكذا تكلّم زرادشت، وذلك رغم الهوّة الساحقة التي تفصل بين مؤسّس الزرادشتية وزرادشت فيلسوف السوبرمان.
وما أن تنبّه العلماء إلى هذه الشخصية المركزية في علوم الأديان وتاريخها حتى توالت الاكتشافات المذهلة بشأن أثرها الحاسم في الديانات العالمية الخمس الكبرى، ولا سيما الإبراهيمية منها. فإيران، من حيث موقعها الجغرافي والتاريخي، كانت جسر عبور بين أديان الشرقين الأقصى والأوسط أي بين أديان العالم الخمسة الكبرى اليوم.
أثر زرادشت الحاسم في الملل الثلاث
والأثر الزرادشتي في الأديان الإبراهيمية أدهش الكثيرين وأذهلهم لدرجة أوصلت المستشرق دو لاكروا الآنف الذكر إلى أن يقول:
«من يدرس سيرة زرادشت وعقائده وكتابه المقدّس، يرى أن الأديان الإبراهيمية ليست صنيعة موسى ويسوع ومحمد، بقدر ما هي صنيعته أيضاً. فأثره فيها جليّ واضح، ولا يقلّ عن أثر كلّ من الثلاثة هؤلاء في دينه.
فما أخذته هذه الأديان عنه، ليس مجرّد استعارات بسيطة، وأحجار تتمّم البنيان وتجمّل، بقدر ما هو حجر زاوية في عقيدتها وبنيانها. فعنه أخذت عقيدة الشرّير/الشيطان، والجنة وجهنّم، والنبوّة والقيامة والبعث، ويوم الحساب والدينونة، والمعراج والصعود إلى السماء، وانتظار المخلّص وولادته من عذراء، ومجيء المنقذ في آخر الزمان، والزمن الخطّي المستقيم Temps linéaire. وكلّها عقائد أساسية، لا تقوم لهذه الأديان قائمة من دونها».
وتخلص عالمة الأديان المستشرقة ماري بويس (1920-2006)، بنتيجة بحثها الطويل في الزرادشتية وتاريخها وعقائدها وكتبها المقدّسة، إلى رأي مماثل، فهي تعتبر الحضور الزرادشتي في العالم اليهودي-المسيحي حضوراً فاعلاً وقوياً، وإن أريد له أن يبقى في الظلّ، وبهذه العبارة اللافتة تعنون أحد أبحاثها.([1]) وهي في بحث آخر تؤكّد أن تاريخ البشرية الديني لا يُفهم، على حقيقته وفي أبرز أبعاده وخفاياه، إذا استمرّينا في جهل أو تجاهل الزرادشتية وتاريخها وأثرها الحاسم في غيرها من الأديان، فتعنون بحثاً آخر لها:”الزرادشتية:إعادة اكتشاف فصول مفقودة من تاريخ الإنسان الديني“([2]).
ويذكر كاتب هذه السطور أن موضوع الأثر الزرادشتي في الأديان قد خطر له مراراً البحث فيه. وسبق له أن تناوله في ثلاثة من مصنّفاته،([3])([4]). صدر آخرها في هذه السنة،([5]) وتناول أثر زرادشت في نقل النموذج النبوي إلى الأديان الإبراهيمية، وكذلك مفهوم الخلق من لا شيء Exnihilo، وهما موضوعان محوريّان ورئيسان، ولكن لم يتمّ التطرّق إليهما في هذا المصنّف، إلا لماماً، تحاشياً للتكرار.
واليوم إذ سنحت الفرصة مجدّداً للبحث في أثر زرادشت والزرادشتية في الأديان الأخرى، لم يشأ الكاتب أن تقتصر دراسته على الأديان الإبراهيمية وحسب، بل أرادها أن تشمل سائر الأديان الكبرى، لما له من أثر حاسم فيها جميعاً. وهذا الأثر كان لموقع إيران الذي يتوسّط الشرقين: الأقصى والأوسط الدور الأساسي فيه، فكانت هي والزرادشتية ديانتها جسر عبور نقلت مؤثرات أديان الهند إلى الأديان الإبراهيمية وبالعكس. وهو لا يتناول بالبحث الزرادشتية إلا من هذه الزاوية تحديداً، ومن هنا العنوان:”زرادشت نبيّ إيران وأثره في الأديان الخمسة الكبرى“، أما التعريفات والمداخل والنُبَذ، فالغرض الأساسي منها أن تمهّد لدراسة هذا الأثر.
الأديان العالمية الخمسة الكبرى
وقفة في البداية عند العنوان، وما فيه من معطيات. ”زرادشت نبيّ إيران“ لا يُقصد من ربط نبوّته ورسالته بإيران أيّ تحجيم لهما، أو محاولة حدّ من أثرهما العالمي. فزرادشت نفسه أراد أن يكون نبيّ الفرس وإيران، والزرادشتية، كما يرد في الدراسة، لم تكن ديانة تبشير، وهي إلى اليوم لا تتيح الدخول فيها إلا لمن ولد من أب زرادشتي، أي أنه فارسي أو من أصل إيراني، ومن هنا فالتسمية لا تبعد دلالةً عن ذلك.
ماذا الآن عن ”الأديان الخمسة الكبرى“؟ وهل هي فقط خمسة؟! وما هي؟! لو شاء الباحث المزيد من التحديد لقال:”الأديان العالمية الخمسة الكبرى“، والمقصود الملل الثلاث، أو الأديان الإبراهيمية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام مضافاً إليها الهندوسية والبوذية، ولكنه آثر حذف عبارة ”العالمية“ كي لا يطول العنوان. وليس هو أول من استعمل هذا المصطلح، فهو مستخدَم في علوم الأديان. فالبروفسور عادل تيودور خوري مثلاً يستخدمه مراراً في سلسلة ”في علوم الأديان“ التي يشرف عليها، ويصدرها بالألمانية وبالعربية، ومنها كتابه المعنون:”مدخل إلى الأديان الخمسة الكبرى“ وبالألمانية: Die fünf grossen Weltreligion. وينتظر القارئ منه أقلّه أن يحدّد المصطلح الذي يورده في العنوان، ويشرحه، ولكنه لا يجني سوى خيبة أمل، فهو يقول في مقدمة كتابه المقتضبة: «يجمع هذا الكتاب المعطيات الأساسية للأديان الخمسة الكبرى في العالم:الهندوسية والبوذية والإسلام واليهودية والمسيحية» ([6]). إنها ببساطة نقيصة في المنهج، إن لم تكن عيباً فيه.
ويحسن التوقف عند العنوان الألماني الأصليّ للكتاب، فترجمته الدقيقة والحرفية:”في الأديان العالمية الخمسة الكبرى“. فلـمَ حذَف المؤلف لفظة ”عالمية“ عند ترجمته العنوان، ولـمَ لمْ يبرّر ذلك، أو أقلّه يُشر إليه؟! يبقى الجواب عنده. ولعلّه لم يشأ أن يطول العنوان بالعربية في حين أن ”الأديان العالمية“ بالألمانية كلمة واحدة Weltreligionen. وواضح أن المقصود بمصطلح ”الأديان الخمسة الكبرى“ المستخدم مراراً في عناوين كتب سلسلة ”في علوم الأديان“ الآنفة الذكر وفي متونها:”الأديان العالمية الخمسة الكبرى“. ويتأكّد ذلك من مقدمة كتاب آخر في السلسلة، يقول فيها المؤلف كونراد مايزيغ:«إذا نظرنا إلى البوذية من ناحية العدد، أي بالنسبة إلى عدد مؤمنيها، وكذلك بالنسبة إلى انتشارها الجغرافي، تبيّن لنا أن البوذية مع أتباعها الذين يربو عددهم على الخمس مئة مليون، هي أحد الأديان العالمية، على غرار دين الهند العالمي الآخر، الهندوسية، والأديان الكبرى الثلاثة الساميّة الأصل، أعني اليهودية والمسيحية والإسلام» ([7]).
وما يقصده الكاتب بِ ”الأديان الكبرى“ هو تماماً ما عناه مؤلفو ”سلسلة في علوم الأديان“ أي ”الأديان العالمية الكبرى“. وعندها فقط يمكن تحديدها بِ خمسة، أي اليهودية والمسيحية والإسلام والهندوسية والبوذية. فكلّ من هذه الأديان تخطّى الحدود الجغرافية للدول، والعرقية للشعوب، فاتسم بسِمة العالمية. فالهندوسية منتشرة في جنوب شرق آسية، وفي أندونيسيا والنيبال وسريلانكا، بالإضافة إلى الهند بالطبع، والبوذية تنتشر في الصين وبورما ونيبال وڤيتنام والتيبت وتايلاند وكمبوديا واليابان وأندونيسيا ، وغيرها. فكلّ منهما دين عالمي، وكلٌّ منهما من الأديان الكبرى عدداً، إذ يعدّ تابعوه بمئات الملايين. والملل الثلاث أديان عالمية كبرى عدداً وانتشاراً. ولا تنطبق هاتين الصفتين على ما يُعرف من أديان أخرى في عالم اليوم. فالكونفوشسية من الأديان الكبرى، إذ يعتنقها مئات الملايين في الصين. ولكنها ليست ديناً عالمياً، إذ لم تتخطَّ حدود موطنها. وبالمقابل، فالبهائية دين عالمي، ولكنه ليس من الأديان الكبرى من حيث عدد أتباعه.
وهكذا فالأديان العالمية الكبرى هي، حصراً وتحديداً، الخمسة الآنفة الذكر، وإذا كان عنوان الكتاب قد اقتصر على عبارة ”الأديان الخمسة الكبرى“ فاختصاراً، وهو يعني ضمناً ”الأديان العالمية الخمسة الكبرى“، فاقتضى التوضيح.
مصادر البحث: نصوص الزرادشتية وبحوث المستشرقين
ولو شاء الكاتب أن يصنّف Classifier مصادره ومراجعه الأساسية
لجعلها في مجموعتين رئيستين:
1-النصوص الزرادشتية المقدّسة أولاً، ونصوص الأديان الخمسة تالياً، والتي ينقّب عن الأثر الزرادشتي فيها.
ومصادر الزرادشتية وكتبها كالأڤستا بمختلف أجزائه مثل الفانديداد وغيره، وكتاب أردا ڤيراز أو معراجه وغيرها تكاد المكتبة العربية تخلو منها خلوّاً تامّاً. وما عُرّب منها، كنصّ الأڤستا المعرّب عن الروسية والصادر في سوريا، وغيره لا يُعتدّ به، ولا يمكن أن يكون عليه الاعتماد. لذا كانت العودة إلى ترجمات علمية ودقيقة فرنسية وإنكليزية، وهي مذكورة في الهوامش، وفي مكتبة البحث.
2- أعمال المستشرقين، ومؤرّخي الأديان، والمتخصّصين في الدراسات الإيرانية Iranologues أمثال ماري بويس، بول دو بروي، دوشين، ماكس موللر وغيرهم. وفي هوامش متون الدراسة نُبَذ تعريفية بهؤلاء العلماء، وأبرز محاور إسهاماتهم ومؤلّفاتهم.
أما المصادر العربية القديمة في الأديان، ففائدتها محدودة في دراسة أثر الزرادشتية في الأديان الكبرى باستثناء الإسلام، ولكنها استخدمت خصوصاً في دراسة البوذية في أرض الإسلام وتفاعلها مع الزرادشتية، وكذلك في دراسة أثر الزرادشتية في ديانة القرآن.
ماذا الآن عن هذا المصنّف بنية ومضموناً؟
طُرق الموضوع في سبعة فصول توزّعت في بابين.
الباب الأول (ب1): ”الزرادشتية جسر عبور بين أديان الشرقين الأقصى والأوسط“ يقدّم مدخلاً عامّاً إلى الزرادشتية وميزاتها، ويتناول تفاعلها مع أديان الهند، ولا سيما الهندوسية والبوذية تأثراً وتأثيراً.
والفصل الأول منه (ب1/ف1) يتصدّى لأبرز الإشكاليات المتعلّقة بإيران وزرادشت وديانته: زمان هذا النبيّ ومكانه المختلف فيهما حتى اليوم، ويتوقّف عند أبرز تهمتين وجّهتا إلى الزرادشتية: عبادة النار، وزواج الإخوة والمحارم. فبشأن الأولى يؤكّد أنها تهمة باطلة ألحقها الكتّاب العرب بالمجوس تحقيراً لهم، أما بشأن زواج الإخوة والمحارم عموماً، فالفرس ليسوا الشعب الوحيد الذي أباحه، فقد شرّعه الفراعنة، والسومريون أيضاً، وذلك بهدف الحفاظ على نقاوة الدمّ. ويحاول هذا الفصل أن يستقرئ هذا التقليد العريق في القدم وأبعاده ودواعيه، وكيف يمكن للإنسان المعاصر أن يفهمه، وماذا يستخلص منه.
وإلى هذين المسألتين يعرض ب1/ف1 بعض الميزات البارزة الأخرى في الزرادشتية، والتي كان لها أثر بعيد في الأديان الأخرى: عقيدة الحساب والقيامة بعد الموت، مقولة الدين الحقّ Veh Din، المعراج الزرادشتي وأثره الحاسم في الإسلام والأديان الأخرى، النموذج النبوي وتعميمه على الأديان الإبراهيمية، وغير ذلك.
والهدف العامّ للفصل إدخال القارئ في جو الزرادشتية العامّ أولاً، ولفت نظره إلى أهمّيتها وأثرها الحاسم في ما تلاها من أديان، علماً أن نقاط هذا الأثر ومحاوره سيُعاد البحث فيها في الفصول التالية، أما الإشارة إليها في هذا الفصل التمهيدي، فالغرض منها عرض الإشكاليات الأساسية التي ستتصدّى لها الفصول التالية، والتحضير للمعالجة.
ويبقى أن ب1/ف1 كان في الأساس مادة محاضرة عامة، ومقابلة تلفيزيونية على المنار، وأثبت في مطلع الدراسة كما هو من دون تعديلات تُذكر. مع ما قد يعني ذلك من احتمال تكرار.
والفصل الثاني من الباب الأول (ب1/ف2) يدرس التفاعل العميق بين الزرادشتية والهندوسية، ولا سيما في الحقبة الڤيدية. وهنا يظهر ريك ڤيدا مصدراً أساسياً لِ الأڤستا، لا بل إن كلمة أڤستا تعني ڤيدا أي معرفة كما ذُكر في مطلع ب3/ف2. ويظهر زرادشت نبياً يندرج ضمن التقليد الڤيدي. وهو اكتشاف بالغ الأهمّية. فزارا أقدم النماذج النبوية في الأديان، كما بيّن ب1/ف1 والأبحاث السابقة للمؤلف الآنفة الذكر. ولكنه، وفي الوقت عينه، يبدو في أناشيده في الكاتا بصّاراً Rishi من بصّاري ريك ڤيدا ورؤيويّه. همْ يتوجّهون إلى أُلهانيات متعدّدة مثل إندرا Indra و أغني Agni وسوما Soma، وهو يتوجّه إلى إله واحد أهورا أي أسورا Asura ريك ڤيدا واسمه ڤارونا Varuna. ماذا نستخلص من كلّ ذلك؟ مفهوم النبوّة عند زرادشت هو مفهوم الإدراك والاستبصار والتبصّر عند رؤيويّ الڤيدا وبصّاريه Rishis، أخذه زرادشت عنهم وحوّله من عملية استبصار محض داخلية إلى ما يمكن أن نسمّيه وحي خارجي، أو وحي إله أوحد مباشر، أو لاحقاً عبر روح قدسه. وهكذا فالوحي والاستبصار في الأساس واحد، وينحصر الاختلاف في المسار أو الوجهة: أهو عملية داخلية من الذات إلى الذات، أم من ذات عليا وإله أوحد إلى الذات؟!
فهل إن مفهوم الوحي والنبوّة هو في الأساس فكرة ريك ڤيدية أخذها زرادشت وطوّرها لتتناغم مع منظومته التوحيدية الصارمة؟ من شأن جواب إيجابي عن هذه الإشكالية البارزة أن يكون اكتشافاً ثوروياً في علوم الأديان، فأثر نبي إيران في نقل مفهوم الوحي والنبوّة إلى الأديان الإبراهيمية يبدو مرجّحاً إن لم يكن محسوماً، فهل إن هذا المفهوم مستوحى من مفهوم الاستبصار الريك ڤيدي؟ إنها واحدة من الإشكاليات البارزة التي يطرحها ب1/ف2، أو بالحري يودي إليها.
ومن الإشكاليات الأخرى التي يطرحها ب1/ف2 النظام الكوني Dharma في الڤيدا وفي الأڤستا. إنه مفهوم واحد في الكتابين، ما يدلّ على عمق التفاعل بين التقليدين.
ويدرس ب1/ف2 العصير الألهاني سوما في ريك ڤيدا وهوما في الأڤستا، وما يُكسب السالك من قدرات خارقة، وأبرزها الطيران. وفي معراج أردا فيراز أن هذا الأخير، قبل عروجه إلى السماء، شرب عصير الهوما، أو بالحري إن عروجه كان بفعل هذا العصير! فاختبارات الطيران التي يتحدّث عنها اليوغيون، وتناولها الكاتب في عدد من أبحاثه السابقة ([8])([9]) هل هي في أساس اختبارات المعراج والصعود إلى السماء؟! إشكالية بارزة يسعى ب1/ف2 إلى الإجابة عنها.
وممّا يتصدّى له ب1/ف2 من إشكاليات، سقوط الآلهة لتصير شياطين في ريك ڤيدا والأڤستا، وهل إن هذه المقولة هي في أساس ما ترويه الأديان الإبراهيمية عن سقوط ملائكة لتصير أبالسة؟ وما علاقة سقوط الأبالسة في التوجّه الحثيث والمباشر نحو التوحيد؟!
ويخلص ب1/ف2 إلى أن الهنود والإيرانيين شعبان من أصول واحدة، وكانا متّحدين سابقاً، ولا يمكن فهم التفاعل العميق بين التقليدين الڤيدي-الهندوسي والأڤستي-الزرادشتي بمعزل عن هذه الحقيقة التاريخية.
والفصل الثالث والأخير من الباب الأول (ب1/ف3) هو الأطول. وذلك لأنه يدور حول محورين كما يظهر من عنوانه: ”الزرادشتية والبوذية، والبوذية في أرض الإسلام“. فبشأن المحور الأول، فهو يكشف عن أن البوذية ديانة عريقة في إيران، وقد تعود إلى زمن غوتاما بوذا نفسه. ولها في بلخ وفي باميان (أفغانستان اليوم) آثار مهمّة. وهذا الحضور المبكر والفاعل للبوذية في إيران أثمر تفاعلاً عميقاً بين الديانتين، فتعدّدت المؤثرات الزرادشتية في البوذية: في الأيقونوغرافيا البوذية، مفهوم الشيطان: مارا، انتظار بوذا المخلّص Maitreya فغرست الزرادشتية انتظاراً مسيحانياً في البوذية، كما كان شأنها في اليهودية والمسيحية والتشيّع. ويتوقّف الفصل عند الدور الأساسي لإيران في نشر البوذية، فمنها انطلق المبشّرون نحو الصين وسائر بلدان الشرق الأقصى، فحوّلوا الكثير منها إلى ديانة غوتاما.
والمحور الثاني من ب1/ف3 يعرض ويدرس البوذية في كتابات المسلمين. فهؤلاء عرفوا تحديداً البوذية، أو السمنية كما سمّوها، في إيران. وقسم من أرض الإسلام اليوم مثل بلخ وأقسام كبيرة من أفغانستان كانت بالحري جزءاً من أرض البوذية. ونظراً لأهمية هذا الموضوع في وجدان القارئ العربي، وارتباطه المباشر بمادة هذا الكتاب، فقد تمّ التنقيب عن كل النصوص العربية القديمة التي تحدّثت عن البوذية وحضورها في إيران، ومعابدها وطقوسها، والأسَر البوذية التي أسلمت، ولا سيما البرامكة. وأقدم هذه المصادر ابن حنبل (164-241هـ) في ردّه على الزنادقة. ثم ابن الفقيه (290هـ) الذي يصف معبد بلخ البوذي ”النوبهار“ وما كان يجري فيه من طقوس وشعائر، ويروي قصة البرامكة سدنة هذا المعبد. ويضيف المسعودي (345هـ) معطيات مهمّة إلى ما ذكر ابن الفقيه، ولا سيما بشأن بوذاسيف. أما ابن النديم (ت380هـ) فمصدر ثمين عن البوذية وعقائدها ومعابدها ونُصب البدّ التي عرفها المسلمون، وتماثيل باميان العملاقة التي دمّرتها مؤخّراً حركة طالبان في شباط 2001.
وحفظ البيروني (ت440هـ) لنا كعادته معطيات قيّمة عن البوذية، فمعابدها كانت منتشرة في مختلف أرجاء خراسان الشرقية، وهو يرسم لنا لوحة للبوذية وعقائدها كما عرفها المسلمون.
ويضيف ياقوت الحموي (ت626هـ) معطيات قيّمة بشأن بلخ والنوبهار وباميان، وكذلك البرامكة، نعرضها ونحلّلها في فقرة خاصة.
أما القزويني (ت682هـ)، فأبرز ما يميّز عرضه ربطه غير المباشر بين المتصوّف المسلم إبراهيم البلخي وتراث بلخ البوذي. وهذا الصوفي نُسجت سيرته المتداولة في محاكاة واضحة لسيرة الأمير غوتاما بوذا.
وآخر من نعرض له الفيلسوف المتصوّف ابن سبعين (ت667هـ)، فكتابه بُدّ العارف، وغيره من آثاره يُظهر أثراً بوذياً أشار إليه ابن تيمية وغيره من القدماء.
ويخلص الفصل إلى أن التفاعل بين البوذية والإسلام في إيران الكبرى جدير بالدراسة والاهتمام، ومن شأنه أن يكشف النقاب عن تأثيرات مهمّة.
والباب الثاني ب2 مخصّص كما يوضح عنوانه لِ ”الزرادشتية وأثرها في الأديان الإبراهيمية“. وطبيعي أن تتوزّع البحوث حول محاور ثلاثة، لكن الكاتب أضاف فصلاً (ف3)، هو في الأساس نصّ مداخلة له في ندوة، وذلك لتعلّقه المباشر بموضوع البحث.
والفصل الأول من الباب الثاني ب2/ف1 يختصر عنوانه مجمل ما فيه: ”الزرادشتية واليهودية وانتقال عقائد الشيطان والجنة والقيامة إلى البيبليا“. فأي طريق سلكت هذه المفاهيم الزرادشتية الأساسية للوصول إلى البيبليا؟ العبارة المفتاحية للجواب هي ”السبي البابلي“. ففيه تفاعل العبرانيون بعمق مع الفرس حتى سمّي التلمود البابلي ”التلمود الفارسي“. وهذا السبي جعلهم يعتبرون قورش الفارسي (538-529 ق م) المسيح المخلّص. وقبل السبي لا أثر لمفهوم الشيطان في البيبليا، وبعده يظهر فيها واضحاً جلياً، كما يبيّن هذا الفصل. وهذا القول ينسحب أيضاً على مفهوم الجنة والجحيم، والثواب والعقاب. ويتوقّف ب2/ف1 عند هذه الظاهرة ويتبصّر مليّاً فيها. والانتظار المسيحاني لم يعرفه اليهود قبل السبي، وظهر عندهم خلاله وبعده. ولا شكّ أن عدوى انتظار تحقّق نبوءة زرادشت في مجيء مخلّص ”ساوشيانت“ قد انتقلت من الفرس إليهم.
والفصل الثاني ب2/ف2 عنوانه هو الآخر يحكي عنه: «عقيدة المخلّص المولود من عذراء وانتقالها من الزرادشتية إلى الترجمة السبعينية». وكما سبق وذُكر فهذا الفصل هو في الأساس مداخلة في ندوة عنوانها:”كتاب مقدّس واحد وديانتان متناحرتان“. كيف تحوّلت آية أشعيا 7/14 {ها إن الصبية تحبل} إلى ”ها إن العذراء تحبل“ في الترجمة السبعينية للتوراة؟ هذا التحوّل الذي حيّر الكثيرين، واعتبره المسيحيون من وحي الروح القدس، ليس غريباً عن أثر زرادشتي مباشر، فالمخلّص الزرادشتي الموعود ستحبل به فتاة عذراء وتلده، ويهود فارس كانوا على علاقة وطيدة بيهود الإسكندرية، ويبدو أنهم نقلوا إليهم هذا التأثير، فظهر في الترجمة السبعينية التي أبصرت النور في مدينة الإسكندر. تلك هي المقولة المحورية لِ ب2/ف2 وهو يُعرّف بهذه الترجمة، وكيف صارت لاحقاً محور الخلاف بين اليهودية والديانة الناشئة التي خرجت من رحمها أي المسيحية. ويختتم الفصل بدراسة مقارنة بين مريم في البيبليا وفاطمة في القرآن. هل من ذكر مباشر وواضح لهذه الأخيرة في آي التنزيل؟ السنّة ينفون ذلك، في حين يؤكّده الشيعة، إنه خلاف مشابه تماماً للخلاف اليهودي-المسيحي حول الذكر المحتمل لمريم في التوراة.
والفصل الثالث من الباب الثاني ب2/ف3 يطرح إشكالية مركزية:”هل إن يسوع هو الساوشيانت الذي وعد به زرادشت وبشّر“؟!
الإنجيليون، ولا سيما منهم متى، كانوا على علم بنبوءة زرادشت، فجعل الإنجيلي الأول المجوس يعلنون أن هذه النبوءة قد تحقّقت في الناصري يسوع المولود ملكاً لليهود. ويدرس هذا الفصل قصة المجوس كما رواها إنجيل متى، ودلالاتها. ويتوقّف عند نبوءة بَلعام ومغزى الخلط بينها وبين نبوءة زرادشت، وكذلك التماهي المبرمج بين الشخصيتين: بَلعام التوراة، وزرادشت الأڤستا. ثم يورد رواية زيارة المجوس كما جاءت في إنجيل منحول هو إنجيل الطفولة العربي، ويحلّل هذه الرواية، ويفنّد عناصرها ومعطياتها ودلالاتها على الأثر الزرادشتي في عقيدة المسيح المخلّص في المسيحية.
ويتوسّع هذا الفصل في تبيان ملامح الأثر الزرادشتي في المسيحية. فيدرس ما يجده منها عند القدّيس يوستينوس (ت165م). فهو أول من تحدّث عن ولادة المسيح في مغارة، وولادة المخلّص في مغارة تقليد زرادشتي بامتياز، ويتعلّق بالنبوءة بولادة الساوشيانت. والرعاة الذين يعاينون الوليد المخلّص الملكي، ويسجدون له مذكورون في خبر ولادة الأمبراطور الفارسي قورش الذي اعتبره اليهود مسيحاً مخلّصاً كما مرّ. ويخلُص الفصل إلى دراسة مقارنة بين يسوع والمخلّص الزرادشتي الموعود: مثله يسوع يطرد الشياطين ويشفي المرضى، ويولد في الاعتدال الشتوي، وتحت علامة نجم. وبقدر قُرب يسوع من ”ساوشيانت“ المخلّص المنتمي إلى عالم الروح، فهو يبتعد عن المخلّص الذي ينتظره اليهود: الملك الممسوح الذي يسحق أعداءه، ويجعلهم موطئاً لقدميه.
والفصل الرابع والأخير من الباب الثاني ب2/ف4 هو الأطول بين الفصول. فهو يدرس: ”الزرادشتية وأثرها في الإسلام“. ويتناول أولاً المجوس وحضورهم الفاعل في جزيرة العرب في الجاهلية، وفي أي أماكن عاشوا؟ ثم ينتقل ليدرس المجوس في القرآن، ودلالات ذكرهم فيه، ليتوسّع بعدها في تقصّي الأحاديث النبوية التي نجد لهم ذكراً فيها، ومدى صحّتها، وما يعني ذلك. أما المحور الأساسي الذي يدور حوله الفصل فهو سلمان الفارسي، هذه الشخصية/اللغز التي بلغت الأخبار عنها حدّ الأساطير. هل هي تاريخية؟ أم مجرّد أسطورة كما مجوس الإنجيل؟! هوروڤيتس وغيره من المستشرقين اعتبروها مختلقة، والهدف إعطاء الفرس دوراً في نشأة الإسلام. ويتفحّص الفصل الأحاديث والآثار التي تنوقلت عن سلمان، بدءاً بما روي عنه في السيرة النبوية لابن إسحاق، ويقرأ هذه الرواية قراءة نقدية، وكذلك ما نُسب إلى سلمان من دور في واقعة الخندق. ثم يذكر ما أُخرج في صحيحي البخاري ومسلم من أحاديث عن سلمان، ليتوقّف بعدها عند روايات ابن سعد في طبقاته، وأبرزها حديث ”سلمان منا أهل البيت“ ومدى صحّته، وكذلك قول الإمام عليّ المشابه لهذا الحديث، وأي منهما أُخذ عن الآخر؟!
ويلحظ ب2/ف4 أن ابن عبد البرّ قد أهمل هذا الحديث، واكتفى بذكر قول عليّ المشابه له. ويتوقّف عند سلمان الشخصية المركزية في كلا التصوّف والتشيّع. ويُعنى بدراسة المقارنة في التقليد الإسلامي بين لُقمان وسلمان، ودلالات هذه المقارنة ومغازيها. من هو لُقمان؟ هل هو أحيقار الحكيم؟ ولـمَ قورن سلمان به؟!وينتقل إلى تفنيد الروايات الشيعية التي تحدّثت عن دور لسلمان في الوحي! وهنا يستعين بأبحاث المستشرق ماسينيون في هذا الصدد، وتفحّصه للأحاديث المروية عن سلمان. ويميل في النهاية إلى الأخذ بتاريخية سلمان، مع التأكيد على الطابع الأسطوري للكثير من الأخبار والأدوار التي نُسبت إليه.
ويواصل ب2/ف4 تتبّع المؤثرات الزرادشتية في الإسلام. ومن أبرزها مقولة نجاسة الكافر، والتي لا نجد لها أثراً لا في المسيحية ولا في اليهودية. في حين يقول القرآن {إنما المشركون نجس} (التوبة9/28). وقد بيّنت أبحاث المستشرق جولدتسيهر أنها عقيدة زرادشتية نصّ عليها الفانديداد بوضوح. وإذا كانت مذاهب أهل السنّة قد امتنعت عن اعتبار أعيان (ذوات) المشركين نجسة، فقد أكّدت الإمامية ذلك بتأثير فارسي مباشر.
والمرتدّ في الزرادشتية تُطلّق امرأته منه، ويُستتاب، فإن رجع عن رِدّته عُفي عنه، وإلا فعقوبته القتل، وهذا تحديداً ما يجري في الإسلام. وسبق للمؤلف أن تناول بالبحث حدّ الرِدة، وبيّن أن لا أساس له لا في القرآن، ولا في السيرة النبوية. ولعلّ الحلقة المفقودة، أو القطبة المخفية، في هذا الحدّ هي الأثر الفارسي، فهو كفيل بتفسير سبب رسوخ هذه العقوبة الظالمة في الإسلام، في حين أن لا أساس قرآني لها. ومن شأن تشدّد الشيعة في إقامة هذا الحدّ أن يؤكّد هذا الأثر.
والحور العين في القرآن لهن سوابق في النصوص الزرادشتية المقدّسة، إنها الحورية داينا التي تلقى الميت على جسر الصراط سينڤاد، وينقل ب2/ف4 عن كتاب أردا ڤيراز وصفاً حسّياً إيروتيكياً لها.
ويرفض القرآن مقولة في اليوم السابع استراح الله بعد خلقه الكون (تكوين2/3). وقد سبقته إلى ذلك النصوص الزرادشتية، ورفض لاهوتيو المجوس مقولة السبت واستراحة الله فيه العبرانية.
والمسواك، هذا التقليد الراسخ في الإسلام، هو في أصله عادة فارسية طقوسية مرتبطة بالصلاة والتطهّر قبلها.
والفردوس القرآني، لفظاً ومفهوماً وتصوّراً، فارسي الأصل. والجنة القرآنية تحاكي الحديقة الفارسية تصميماً وتوزيعاً.
والصلوات اليومية في الإسلام خمس، وهي كذلك في الزرادشتية، فالعدد خمسة مقدّس عند المجوس.
وهكذا، فما أخذته اليهودية عن الزرادشتية من عقائد الفردوس وجهنم والشيطان إلخ… اعتمده الإسلام، وأضاف إليه كمّاً كبيراً من المؤثرات الفارسية، ما جعل عبد الرحمن بدوي يقول:«الحياة الروحية في الإسلام تكاد تدين بكلّ شيء فيها لهذا الجنس الآري [الفرس] المتعدّد الجوانب، الخصب الملكات.»
وبنهاية ب2 والفصول السبعة الأولى الموزّعة على بابين يكون صلب موضوع الدراسة قد استُكمل.
والباب الثالث: ”الزرادشتية: نصوص مقدّسة وتعريفات“. وقد يتساءل القارئ لـمَ لمْ يكن هذا الباب أول الأبواب وبه تُفتتح الدراسة؟!
والجواب بسيط: لم يوضع في بداية الدراسة لسببين:
1- ليست مادّته في صُلب الموضوع، فالتعريفات، وكذلك النصوص الزرادشتية ينحصر دورها في الإضاءة على مادّة البحث وتوضيحه.
2- حظّ هذا الباب من الابتكار والإتيان بجديد محدود. فمساهمة المؤلف فيه تكاد تنحصر في النقل والترجمة. التعريفات أكثرها مترجم عن أعمال وبحوث المتخصّص في الدراسات الإيرانية المستشرق البلجيكي دوشين. والنصوص الزرادشتية من الأڤستا وغيرها غالبيتها منقولة عن ترجمات فرنسية وإنكليزية رصينة ودقيقة. وقد ذكرت المصادر والمراجع المنقول عنها، كلّ في مكانه.
وهكذا يكون ب3 قد قدّم نصوصاً أصلية، ومهّد للقارئ للدخول في عالم الزرادشتية من خلال مصادرها الأصيلة. كما قدّم له تعريفات لأبرز مفاهيم ديانة زارا وعقائدها ومصادرها ومختلف حقبات تطوّرها. والعنصران هذان زاد ضروري، بل إلزامي، في كل رحلة بحث جادّة.
والفصل الأول من الباب الثالث ب3/ف1 يُعرّف بزرادشت وبالأناشيد المنسوبة مباشرة إليه في الأڤستا أي تلك المسمّاة الكاتا، ثم ينقل ثلاثة أناشيد منها، مع بعض التعليقات.
والفصل الثاني ب3/ف2 يعرّف بِ: الأڤستا ولغاتها وأزمنة تدوينها، كما يُعرّف بِ: ياسنا، ياشت، أهورا مزدا، أنغرا ماينيو أو أهريمان، وكلّها مفاهيم ومصطلحات وعقائد لا تُفهم الزرادشتية من دونها. ثمّ ينقل أناشيد من الياسنا والياشت تُرجمت عن الإنكليزية والفرنسية.
والفصل الثالث ب3/ف3 يقدّم جملة تعريفات مهمّة: الڤانديداد أو الڤيدڤات، بارشنوم، ييما. ثم يتناول بالبحث والتعريف الپارسيين: أي زرادشتيي الهند: كيف ومتى ولماذا هاجروا من إيران، ويروي باختصار تاريخهم في موطنهم الجديد، وكيف تطوّرت نظرتهم إلى دينهم، والأثر الهندوسي في عاداتهم وتقاليدهم، وكذلك هجرة بعضهم إلى أميركا إلخ…
ثم يُتبع ب3/ف3 هذه التعريفات بنصوص من الڤانديداد تُرجمت عن الإنكليزية.
أما الفصل الرابع ب3/ف4 فيقتصر على نقل نصوص نقوش أركيولوجية زرادشتية وفارسية مع تعريف موجز بها.
والباب الرابع يأتي بمثابة ملحق يساند مادة الكتاب، ويرفد صُلب موضوعه بما يضيء على جوانب مهمّة منه. وعنوان الباب: ”علوم الأديان والتصوّف في العالم وإيران“.
والفصل الأول منه ب4/ف1 ”في الأديان الخمسة الكبرى وتفاعلها والتصوف والعنف“.
وهو في الأصل مقابلة تلفيزيونية مع المؤلف. ونُقلت هنا بنصّها الكامل لعلاقتها المباشرة بموضوع الدراسة. ما هي علوم الأديان؟ وما جدواها في هذا العالم المتغيّر؟ كيف تتفاعل الأديان الخمسة الكبرى مع بعضها؟ وكيف ينظر كلّ منها إلى الآخر؟ وما علاقة التصوّف بالأديان؟ وهل هو عابر أم تابع لها؟! ولـمَ يستند بعض الأديان إلى العقيدة، في حين يستند آخر إلى الاختبار؟ وأين موقع اليوغا من التصوف ومن الأديان عموماً؟ وهل عنف الأديان مسألة حتمية؟ أم يمكن معالجتها. كلّها مواضيع شائكة، بل ملتهبة أحياناً، يعالجها هذا الفصل بإيجاز، ولكن بوضوح.
وفي الفصل الثاني ب4/ف2 يطلّ المؤلف على إيران اليوم وأين هي من تاريخها القديم وتراثها العريق، وذلك من خلال تجربته الشخصية مع الإيرانيين، فيتحدّث عن ميزتهم كشعب، وذهنيتهم واختلافها عن الذهنية العربية، واستيعابهم لتاريخهم وماضيهم الزرادشتي. وكذلك عن تعاطيهم مع الغرب وإسهاماتهم في الاستغراب الذي يقابل علم الاستشراق، وإمكانات الإفادة من التجربة الإيرانية في العالم العربي، ليخلص إلى التحدّيات التي تواجه الإنسان والمفكّر الإيراني اليوم.
وعنوان ب4/ف2:”الأديان والفلسفة في إيران اليوم“. وهو في الحقيقة من صلب موضوع الكتاب، وهو في الأصل النص الكامل لمقابلة أجرتها مع المؤلف قناة المنار اللبنانية، ومنها انبثقت فكرة هذه الدراسة كما سبقت الإشارة.
والباب الخامس والأخير:”حوارات في الموت والعالم الماورائي في الأديان“. وفصول هذا الباب هي في الأساس نقود على بعض كتب المؤلف وردوده عليها، وقد اختيرت من بين عشرات من أمثالها لأنها تتفق مع الموضوع العام للكتاب.
والفصل الأول ب5/1:”غودو والانتظار العبثي للمخلّص“. وعدت الزرادشتية أتباعها بمجيء مخلّص على رأس كل ألف سنة، ومن بعدها حذت أكثر الأديان حذوها، فنادت بانتظار المخلّص وخدّرت أتباعها وأقعدتهم مترقّبين متربّصين. ويتناول صمويل بيكيت هذا الانتظار الذي يراه عبثياً في قالب هزلي ساخر. فهو يرى أنهم يترقّبون ترقّب أبطال مسرحيته مجيء غودو الموعود، والذي لن يأتي. وغودو صيغة تصغير وتحبّب لِ God أي الله. غودو هو المخلّص الإلهي الذي يبني المؤمنون على مجيئه الأسطوري قصوراً في الأحلام. وهذا الانتظار غير مجدٍ كما يرى بيكيت، ويلهي الإنسان عن هدف حياته الأساسي: التطوّر والسلوك نحو التحقّق والاستنارة.
هل سيأتي المخلّص من الخارج؟! أم هو بالحري يقظة داخلية، وجهد دؤوب، وطريق من الذات إلى الذات؟
في تجربة رامانا مهارشي، أحد كبار حكماء ومتصوّفي الهند في القرن العشرين، جواب غير مباشر عن الانتظار العبثي. ومن غودو ينتقل ب5/ف1 إلى اختبار رمانا الصوفي، ولا سيما ما حكاه عن اختباره للموت وهو فتى، والذي أوصله إلى التحقّق. طريق الموت فتحت لِ رمانا أبواب الحياة الأبدية فعلاً لا مجازاً. فمن عبثية بيكيت إلى تحقّق مهارشي، يجول الفصل وينتقل، فيكون للموت معنى يقي من عبثية الحياة ويوقظ منها.
والفصل الثاني ب5/ف2 ”سنّة الحياة والموت Dharma في الهندوسية والبوذية“، يحاول أن يستبين هذا الناموس الكوني الذي التقت في الحديث عنه الزرادشتية والهندوسية والبوذية، عل اختلاف في التفاصيل، وذلك من خلال جديلة الغياب والحضور التي يمكن أن يخبرها السالك إثر وفاة قريب حبيب له.
والفصل الثالث والأخير ب5/ف3:”في حضرة الموت وغيابه“ دراسة نقدية لكتاب المؤلف:”جدلية الحضور والغياب“.
خاتمة
وهنا تنتهي الجولة الطويلة، وقد بلغت محطّاتها ستة عشر فصلاً. وما كان مقدّراً لهذا السِفر أن يصل إلى هذا الحجم، لكن اهمّية الموضوع وجدّته، ونُدرة التطرّق إليه في البحوث العربية السابقة فرضت على الكاتب هذا التوسّع.
وقد آلى على نفسه الوقوف على مسافة واحدة من الزرادشتية ومن الأديان الخمسة الكبرى التي يدرس أثرها فيها. فعلوم الأديان تقبل المقارنة، بل تحثّ عليها، ولكنا بالمقابل ترفض المفاضلة. فعسى رهان المؤلف يكون قد نجح.
والكلّ يشكو اليوم من الأصوليات الدينية وما تُفرز من عنف وإرهاب يروّع الكوكب بأسره، فهل هو صدام الحضارات الذي طالما رُوّج له؟!
في هذا الكتاب درسٌ عميق من الماضي لأبناء اليوم والغد: هذه الأديان التي لا يزال تأثيرها حاسماً في فكر الإنسان المعاصر وفي سلوكه، طالما تعايشت وتفاعلت بالأمس البعيد والقريب، ولم تُقم يوماً حدوداً، أو ترفع أسواراً بينها.
فهذا الأمس، رغم محدودية وسائط تواصله، لم تصحّ فيه القطيعة والعزلة، فهل تصحّان اليوم، وفي عصر وسائل الاتصال اللامتناهية في سرعتها وقدراتها؟!
وكما يقول المستشرق دو لاكورا الآنف الذكر:”دراسة الأديان في تفاعلها المتواصل، وحركة الأخذ والعطاء المستمرّة بينها تؤكّد أن ما من واحدة دون الأخرى تحتكر الحقيقة المطلقة، وتستطيع أن تحصرها فيها أو في كتابها“.
والكلّ محكوماً، كان بالأمس، بالتفاعل والحوار، وهكذا سيبقى اليوم وغداً.
Q.J.C.S.T.B.
د. لويس صليبا
باريس في 22/07/2016
[1]-Boyce, Mary, Zoroastrianism: A Shadowy but Powerful Presence in the Judeo-Christian world, Friends of Dr Williams Library Forty-First Lecture, London, 1987.
[2]-Boyce, Mary, Zoroastrianism: the Rediscovery of Missing Chapters in Man’s Religious History, Teaching Aids for the Study of Inner Asia 6, Bloomington, 1977.
[3] -صليبا، د. لويس، أقدم كتاب في العالم ريك ڤيدا دراسة ترجمة وتعليقات، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط4، 2016، زرادشت نقطة التقاء بين الأديان الكبرى، ص21-26.
[4] -صليبا، د. لويس، الديانات الإبراهيمية بين العنف والجدل والحوار مع بحوث في اليوغا والتصوفين الإسلامي والهندوسي، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2016، زرادشت وأثره في الأديان الإبراهيمية، ص105-107.
[5] -صليبا، د. لويس، عنف الأديان الإبراهيمية حتمية أم خيار؟ جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2016، ص275-277.
[6]-خوري، عادل تيودور، مدخل إلى الأديان الخمسة الكبرى، ترجمة المطران كيرلّس سليم بسترس ومراجعة المؤلف، جونية/لبنان، المكتبة البولسية، ط1، 2005، ص5.
[7]-مايزيغ، كونراد، مدخل إلى البوذية، ترجمة المطران كيرلّس سليم بسترس، جونية/لبنان، المكتبة البولسية، ط1، 2010، ص8.
[8] – صليبا، د. لويس، اليوغا في المسيحية دراسة مقارنة بين تصوفين، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2016، ص176-200.
[9] – صليبا، د. لويس، اليوغا في الإسلام مع دراسة وتحقيق وشرح لكتاب باتنجل الهندي للبيروني، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2016، ص
 دار بيبليون
دار بيبليون