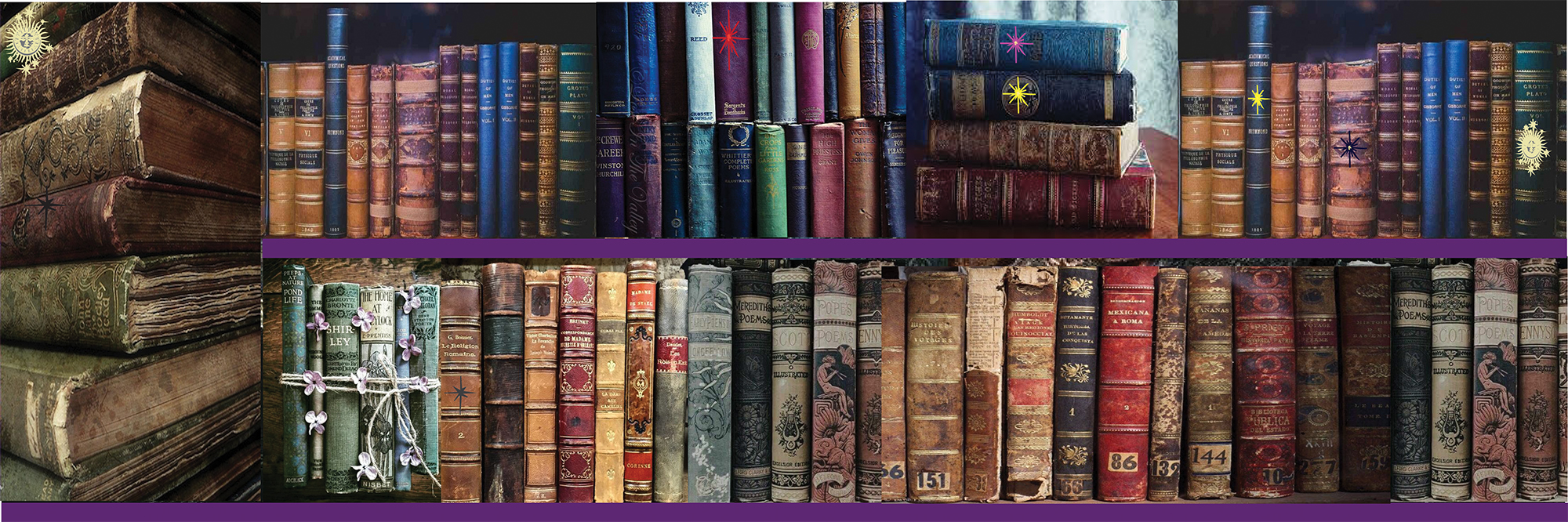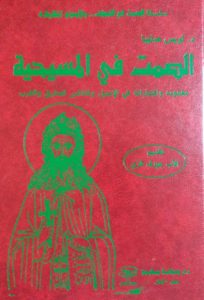

“الصمت في المسيحية: مفهومه واختباراته في الإنجيل وكنائس المشرق والغرب” تأليف د لويس صليبا، صدر مؤخّراً عن دار ومكتبة بيبليون/جبيل في طبعة خامسة في 456ص وتجليد فنّي فاخر، وهو الرابع في سلسلة الصمت في التصوّف والأديان المقارنة.
في زمن الضجيج والضوضاء الدائمَين وصخب وسائل التواصل والإعلام الذي لا ينقطع، يأتي هذا الكتاب مع السلسلة التي تضمّه ماشياً “عكس السير”، أي في الاتّجاه المعاكس لمسار الحضارة الراهنة. ولعلّ هذا أحد أسباب رواجه وإقبال القرّاء غير المتوقّع عليه، فتوالت طبعاته حتى الخامسة. فهو يتيح للقارئ عودةً إلى الجذور، وجذور كل امرئ راسخة هي في الصمت والسكينة، فمنها أتى، وإليها حتماً يوماً سيعود. وتقاليد الصمت لا تخلو أيّة ديانة منها، بل هي في أساس أكثرها وفي طليعتها المسيحية. المسيحيّة والصمت، يقول المؤلّف (ص19) حكاية قديمة، تعيد إلى البدايات، ليس بداية المسيحيّة وحسب بل بداية الخلق حتى. “في البدء كان الكلمة (يوحنا1/1) لكن هذه الكلمة انبثقت من الصمت صمت الآب السرمدي، وتتكلّم دائماً في صمتٍ أبدي، وفي الصمت يجب على النفس أن تسمعها، كما يقول القدّيس يوحنّا الصليبي”
إذاً مع الصمت في الإنجيل، صمت يسوع ومريم، تبدأ الرحلة الصامتة الهاتفة. الابن/الكلمة بصمتٍ تجسّد، وولد في عائلة من الصامتين، وعاش سنواته الثلاثين الأولى في صمت شبه مستمرّ. وزرع المسيح صمته في كلّ زمانٍ ومكان (ص20). فرجّعت آيات الذكر الحكيم أصداء هذا الصمت. فالمسيح في الإسلام هو الكلمة والمتكلّم في المهد (آل عمران3/46)، وهو معلّم الصمت. أخرج الغزالي في الإحياء حديثاً: “قال عيسى العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، وجزء في فرار الناس” (ص59). ومريم نموذجٌ سامٍ للصمت في الإسلام: “إنّي نذرتُ للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيّا” (مريم19/26) ويفسّر القرطبي: الصوم المقصود هو صومٌ عن الكلام” (ص81).
ومن الإنجيل والقرآن ينتقل المؤلّف إلى تقاليد الصمت عند آباء البرّية (ص23): “عاشوا غائصين في الصمت كما السمكة في الماء”. وهنا يقارن الباحث بين جهادهم الأكبر اليومي والمستمرّ وشهادة سابقيهم (ص24): “للآباء بطولات في الصمت والوحدة والعفّة لا تقلّ عن بطولات الشهداء، بل تبزّها. فالشهيد يموت مرّة واحدة عن إيمانه، والناسك يموت كل يومٍ عن حاجات الجسد وشهوات اللسانَين العُلويّ والسفلي والحواسّ”.
وآباء البرّية عاشوا الصمت ولم يفلسفوه، تنفّسوه كما الهواء، علّموه بالقدوة والأسوة (ص25).
ويتوسّع الكاتب في عرض روحانيّة الصمت عند القدّيس أنطونيوس (250-256م) أبي الرهبان، وعند إفرام (306-373م) كنّارة الروح القدس، وعند باخوميوس (286-346م) مؤسّس الحياة الديرية المشتركة. وعند القدّيس أرسانيوس (354-449م) مربّي أبناء الأباطرة الذي سمع يوماً نداءً يقول له (ص133): يا أرسانيوس أهرُبْ من معاشرة الناس تخلُص”، فهجر حياة القصور والترف وعاش في دير، ثم سمع نداءً ثانيّاً يقول (ص135): “يا أرسانيوس الزم الهدوء والصمت والبعد عن الناس فتخلص، لأن هذه هي جذور عدم الخطيئة”. فترك الدير وعاش في صومعة بعيدة مداوماً على العزلة والصمت والسكينة. ويخصّ الباحث روحانيّة الصمت عند يوحنّا السلّمي (525-605م) بفصل، وكذلك تعاليم إسحاق السرياني القائل الصمت سرّ الدهر الآتي (ص177-187).
ويبقى الشيخ يوحنّا الدلياتي (قرن 7 م) الأبرز بين الذين طوّروا فلسفة أو روحانيّة متكاملة في الصمت. يتدرّج من السكوت أوّل مقامات الصمت، ليعلّم صمت الحواس وحفظها، ويصل إلى صمت العقل وحفظ الذهن، ويعرّف الصلاة بأنّها عُجب أوقفه الدهش عن كلّ حركة فغدا صمتاً تامّاً. وهو في كلّ ذلك يلتقي مع متصوّفي الهندوسية والبوذية، وكان عمليّاً وعميقاً في آن (ص189-222).
ويخصّ الباحث أبطال الصمت في الكنيسة الغربية ببابٍ كاملٍ من سبعة فصول: القدّيسون: مبارك (480-456)، وبرونو (1030-1101) مؤسّس الرهبنة الكارتوزية، ويوحنّا الصليبي (1542-1591)، وتريزا الطفل يسوع (1873-1897)، ونازارينا حبيسة روما (1907-1990) …
ليخلص إلى (ص31): “المتصوّفون يَجمعون المتعدّد ويوحّدونه، في حين يعدّد اللاهوتيّون والمتكلّمون الواحد ويفرّقونه”
وخاتمة البحث (ص33): “الأديان تجتمع في محيط الصمت الوسيع وتلتقي”
 دار بيبليون
دار بيبليون