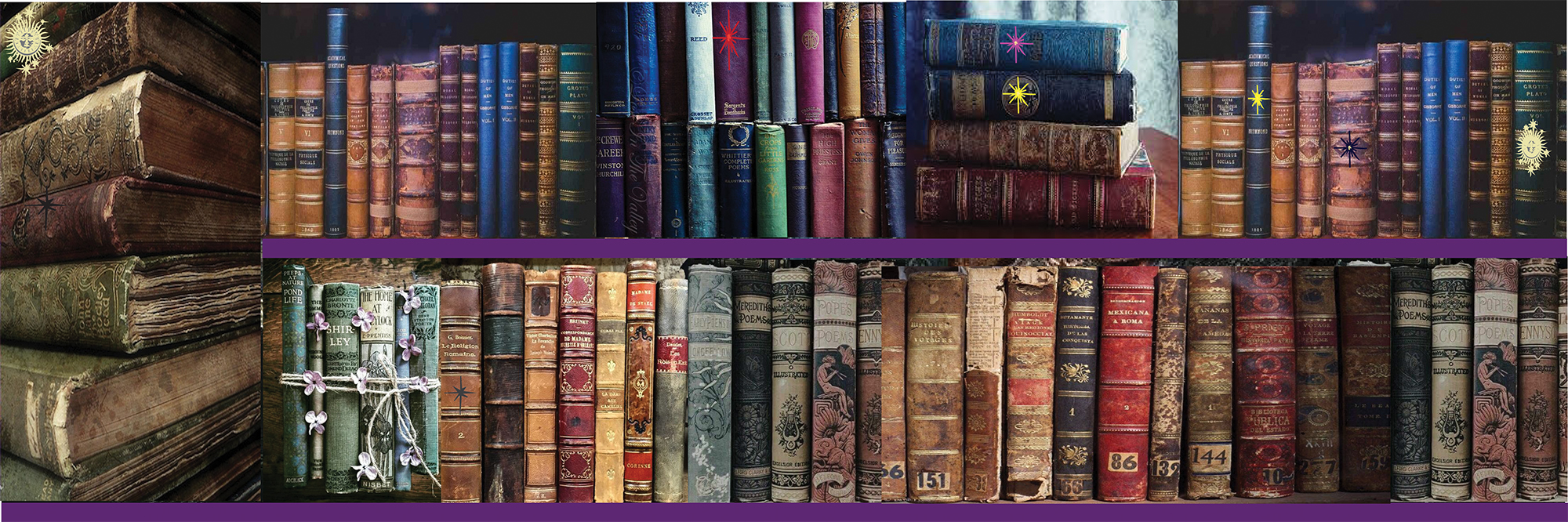مقدمة وغلاف كتاب “القرابين البشرية في اليهودية القديمة”/ تأليف لويس صليبا


المؤلّف/: Author أ. د. م. لويس صليبا Prof. Lwiis Saliba
مستهند ومدير أبحاث وأستاذ مشرف في علوم الأديان والدراسات الإسلامية
عنوان الكتاب: القرابين البشرية في اليهوديّة القديمة
ذبيحة يفتاح في التوراة والتلمود والميثولوجيا والمسيحية والإسلام والآداب
عدد الصفحات: 500ص
سنة النشر: طبعة ثالثة: 2025، ط2: 2020، طبعة أولى 2020
الناشر: دار ومكتبة بيبليون
طريق الفرير، شارع55، مبنى 55، حي مار بطرس، جبيل-لبنان
ت: 09540256- 09430054، خليوي:03847633، ف: 09546736
2025©جميع الحقوق محفوظة، يمنع تصوير هذا الكتاب، كما يمنع وضعه للتحميل على الإنترنت تحت طائلة الملاحقة القانونيّة.
ديباجة الكتاب
مدخل إلى بحوثه وعمارته
يصعب على الباحث المحايد والموضوعي أن يتوقّع مسبقاً إلى أين ستقذف الرياح بسفينة بحثه. وهي كثيراً ما تجري بما لا تشتهي السفن. ومن كان رزيناً وتقريريّاً في دراساته لا يسمح للأحكام المسبقة والأهواء والمشارب أن تتحكّم بمسار بحثه، وتوجّه أشرعته. ويقرّ إن حطّ به المسار حيث لم يحتسب ولم يتوقّع.
انطلقت فكرة هذه الدراسة الموسّعة من مشروع صغير ألا وهو إعداد مدخل لكتاب نسيب الباحث الشاعر أمين خيرالله صليبا “نذر يفتاح” 1913. وعند تصفّحه الأوّل فاجأه طرح هذا الشاعر بشأن نذر يفتاح وتأويله المحدَث له، لا سيما وأنّه رسخ في وجدانه، ومنذ الصغر، وتحديداً يوم قرأ مسرحيّة سعيد عقل “بنت يفتاح”، أن هذه الفتاة العذراء قضت شهيدة نذر أبيها الذي ضحّى بفلذة كبده الوحيدة من أجلِ نصرٍ عسكري. فمن أين أتى أمين صليبا بالتأويل القائل إن هذه الصبية إنّما نُذرت للبتولية الدائمة طيلة حياتها وليس للمحرقة؟!
ومع توسّعه في التحرّي والتفتيش اكتشف الباحث (كاتب هذه السطور) أن مقولة نسيبه الشاعر تأويل قروسطي أبتدعه عددٌ من الحاخامات والربّانيين، إذ أزعجتهم هذه الذبيحة البشرية المخالفة والمناقضة تماماً للشريعة الموسويّة، فرأوا أن تأويل نذر يفتاح على أنّه نذر للبتوليّة وخدمة للهيكل أهون الشرَّين، وذلك رغم ما في هذا التأويل، هو الآخر، من مخالفة صريحة للشريعة الموسويّة، فهي لم تعرف يوماً للبتوليّة معنى ولا مفهوماً، كما عرفت المسيحيّة لاحقاً، بل كانت ترفض هذا المبدأ وتعتبر من لا ينجب أولاداً بمثابة ميت. (ب1/ف6، فق: البتوليّة مستهجنة). لم يحفل هؤلاء المؤوّلون بكلّ هذه المحاذير، فالمهمّ والأساسي بالنسبة لهم كان التخلّص، بأي ثمن، من وصمة الذبائح البشريّة وما تستتبع، وكذلك سحب البساط من تحت أقدام المفسّرين المسيحيين الذين رأوا في ذبيحة يفتاح لابنته الوحيدة صورة مسبقة ونمطاً لذبيحة الآب لابنه الوحيد يسوع.
هنا كانت نقطة البداية والانحراف في التأويل. وأظهرت الدراسة المتأنّية مدى تأثّر الحاخامات القروسطيين بالظاهرة الرهبانيّة النسائية المسيحيّة، وانعكاس تأثّرهم هذا على تأويلهم للنصّ البيبليّ. (ب1/ف6، فق: جرسونيد وأباربانل والتأثر بالحياة الرهبانيّة المسيحيّة).
ورأى المفسّرون المسيحيّون لاحقاً في تأويل نذر يفتاح بالتكرّس للبتولية ما يوفّر لمفهوم الحياة الرهبانيّة ونذر العفّة الدائمة أساساً وسنداً بيبليّاً توراتيّاً، فاستخدموه نقلاً عن تفاسير الربّانيين وعلى رأسهم رابي دافيد كيمحي أو راداك.(ب1/ف6، فق: المفسّرون المسيحيّون وتأويل النذر). وتفكيك آلية هذا التأويل المحدَث والمبتدَع تطلّبت عودة متأنّية إلى كلّ النصوص القديمة التى روت قصّة يفتاح ونذره، وتفحّصها بدقّة. وأوّل هذه النصوص رواية المؤرّخ اليهودي يوسيفوس، ومن ثمّ ما جاء في العاديات البيبليّة لفيلون المنحول، وكذلك ما ورد في التلمود والمدراش وغيرها من الأصول اليهوديّة، وتعريب هذه النصوص العبرية واللاتينية والسريانية وتقديمها للقارئ، وكلّها تؤكّد أن هذه الصبيّة العذراء قُدّمت محرقة وذبيحة حقيقيّة ليهوه إله إسرائيل.
يفتاح قائد شعب إسرائيل قرّب ابنته الوحيدة ذبيحة، ولم يُلَم، رغم ما في هذا العمل من مخالفة صريحة للشريعة الموسوية التي تحرّم الذبائح البشريّة ، بل تصل إلى حدّ معاقبة الفاعل بالقتل لكبح جماح هذا الانفلات العبري في محاكاة الشعوب المجاورة.
ولكن كيف يمكن أن نفهم هذه المفارقة الكبرى: شريعة تحرّم تحريماً تامّاً الذبائح البشريّة، وقائد الشعب اليهودي المؤتمن، أقلّه نظريّاً، على هذه الشريعة وحُسن تطبيقها، يقرّب ابنته الوحيدة ذبيحة؟!
هنا يبدو التحليل الذي قدّمه المستشرق والأركيولوجي الفرنسي رنيه ديسّو هو الأقرب إلى الواقع التاريخيّ: كتاب الشريعة كان معطّلاً، أو بالحري ضائعاً منسيّاً. والرواية التوراتيّة نفسها تؤكّد ذلك، ولم يعثَر عليه سوى في عهد الملك يوشيّا، ومع بداية الإصلاح الذي قاده هذا الأخير. (ب1/ف3، فق: ديسّو القرابين البشرية جزء من اليهوديّة القديمة).
وديسّو من أوائل مَن اقترحوا حلّاً منطقيّاً ومقنعاً لهذه الأحجية/الحزّورة التي حيّرت العلماء والمفسّرين زمناً طويلاً. ومعظم الشعوب الساميّة، إن لم يكن كلّها، عرفت الذبائح والقرابين البشريّة: الكنعانيّون، لا سيما فينيقيّو صور عبدة ملكارت، القرطاجيّون، عرب الجاهليّة في الجزيرة… وغيرهم كثير مارسوا هذا الطقس الدمويّ ردحاً طويلاً من الزمن. واليهود القدماء لم يشذّوا عن هذه القاعدة، رغم ما حوَت شريعتهم من تحريمات وزجر واضح وذمٍّ وإدانة لهذه الممارسة المقيتة. والقرابين البشريّة كانت جزءاً أساسياً من طقوس اليهوديّة القديمة: إنها واحدة من النتائج الحاسمة التي توصّلت إليها هذه الدراسة. وذبيحة يفتاح، أي تقديم ابنته قرباناً ليهوه، لم تكن حالة مفردة، أو شواذاً عن القاعدة، بل كانت مثلاً على قاعدة متّبعة اندثرت تدريجيّاً بعد إصلاح الملك يوشيّا.
إثر الوصول إلى هذه النتيجة الحاسمة أطرق الباحث مفكّراً حائراً!! وهو الذي كرّس العديد من مؤلّفاته وبحوثه لمواجهة معاداة الساميّة الرائجة بقوّة في أوساط المفكّرين العرب، فها هو يجد نفسه أمام واقعةٍ تاريخيّة
إن أقرّها فسيُتّهم بما اتَّهم هو نفسه الآخرين به: معاداة الساميّة! فكيف له أن يتحمّل هذا الوِزر؟!
سبق له أن برّأ، في دراستَين آنفتَين، اليهود من تهمة أُلصقت ظلماً بهم ألا وهي استنزاف الدم البشري لإعداد فطير صهيون! ([1])([2]) وكم سقط منهم من ضحايا بجريرة هذه التهمة الباطلة!
وما خلُص إليه بنتيجة هذا التفكّر يلخَّص في أنّه لا بدّ من وضع هذا التقليد اليهودي القديم والمناقض للشريعة الموسويّة في سياقه التاريخيّ الحقيقيّ، والعبرانيّون لم يكونوا مبتدعيه ولا مبتكريه، بل أخذوه عن جيرانهم، ولا سيّما منهم الكنعانيين الفينيقيين، وبالأخصّ سكّان صور وعبدة الإله ملكارت، كما بيّن رنيه ديسّو. فهل من الجائز والمنطقي أن نصم اللبنانيين مثلاً بالعار لأن أجدادهم الفينيقيين مارسوا هذا الطقس الديني الدموي؟! وهذا ما ينسحب أيضاً على عرب الجزيرة الذين عرف أسلافهم الجاهليّون هذه القرابين.
وممّا يرفع حرج الباحث في إعلان هذه الواقعة وتأكيدها أن كبار الحاخامات الإسرائيليين واليهود المعاصرين أقرّوا بهذه الحقيقة التاريخية الثابتة، ومنهم الحاخام رايس وغيره. (ب1/ف3، فق: الحاخام رايس يتبنّى مقولة القرابين البشريّة ليهوه). ولا بدّ من أخذ هذه المسألة في حدودها التاريخيّة القديمة، والامتناع عن عملية إسقاط الماضي العتيق والغائر في القدم على الحاضر، فهذا خطأ منهجيّ وإنسانيّ يذرّ الكثير من الرماد في العيون!.
ماذا الآن عن هذه الدراسة بنيةً وفصولاً ومباحث؟
مقسّمة هي تبعاً لموضوعاتها إلى أربعة أبواب، وفي ما يلي عرضٌ مقتضب لأبرز مضامين كلّ باب وفصلٍ ومباحثه.
الباب الأول ب1 بمجمله دراسة بيبلية أو مجموعة دراسات كتابيّة تفسيريّة تتمحور حول سفر القضاة فصل 11، أي حول الرواية التوراتيّة لنذر يفتاح، ومن هنا عنوان الباب: نذر يفتاح: النصّ والتأويل.
والفصل الأول ب1/ف1 يأتي بمثابة تمهيد للدخول في صُلب الموضوع في سائر الفصول، إذا يتناول الباحث فيه الدوافع التي حدت به إلى تصنيف كتابه: إنّه مؤلَّف نسيبه الشاعر والكاتب المسيحي أمين ظاهر خيرالله صليبا (1880-1948) “نذر يفتاح”.([3])وما يطرحه من تأويل محدَثٍ للنذر أثار انتباهه، لا سيما وأنّه كان بصدد كتابة مقدّمة لهذا السفر، فجرفته الرمال المتحرّكة للبحث، وحدت به في النهاية إلى تصنيف هذا السِفر ليجلو ملابسات هذه المسألة.
الفصل الثاني: ب1/ف2: نذر يفتاح في النصّ التوراتي، يورد النصّ العبري الذي يروي قصّة يفتاح أي قضاة11 في تعريب حرفي أمين وبين السطور، ويعلّق عليه في الحواشي شارحاً ومفسّراً ومقارناً نذر يفتاح بنذور توراتيّة أخرى لا سيما نذر يعقوب (تكوين28/20-22)، وذبيحته بذبيحة إبراهيم لابنه (تكوين22). وهكذا يكون ب1/ف2 نقطة انطلاق أساسية وركيزة الدراسات البيبلية التي ستَليه.
الفصل الثالث: ب1/ف3: قصّة يفتاح في سياقها البيبلي التاريخيّ، وهو أطول الفصول وأبرزها، إذ حوى الكثير من جديد هذه الدراسة ومكتشفاتها. ونقطة الانطلاق من شخصيّة يفتاح وموقع قصّته في البيبليا أي سفر القضاة، وهذا الأخير تعليمٌ لاهوتيّ أكثر ممّا هو كتاب تاريخ، ويفتاح يشطر هذا السِفر شطرَين، فهو قاضٍ ومخلّصٍ للشعب في آن. أمّا عصره، أي حقبة القضاة في تاريخ إسرائيل فزمن “كلّ مين أيدو إلو” وفق التعبير العامّي، أي كلٌّ يعمل ما يروق له، كما تقول الآية الخاتمة لهذا السفر (قضاة12/25). وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نفهم ذبيحة يفتاح المناقضة، بل الناقضة تماماً للشريعة الموسوية. بيد أن “القطبة المخفيّة” التي من شأن اكتشافها وتسليط الأضواء عليها أن يفهمنا حقيقة هذه الذبيحة وخلفيّاتها ودوافعها تكمن في ما هو أبعد من ذلك. وقد بيّن المؤرّخ والمستشرق الفرنسي رنيه ديسّو أن ذبيحة يفتاح لم تكن حالة فرديّة وشاذّة، بل مجرّد مثلٍ نموذجيّ عن تقليد قرابين بشريّة مرفوعة ليهوه، رغم ما في ذلك من مخالفة للناموس. ويضرب ديسّو أمثلة عديدة من نصّ التوراة عينها (سفر الملوك) ومن المكتشفات الأركيولوجية، ويقدّم تعليلاً منطقيّاً يشرح هذه المفارقة التي حيّرت العلماء والمؤرّخين والمفسّرين ردحاً طويلاً من الزمن. فكتاب الشريعة الموسويّة كان ضائعاً ومنسيّاً كما توضح الرواية البيبلية (2ملوك/8-13). وعُثر عليه في بداية عهد الملك يوشيّا. وتحريمات الشريعة كانت منسية وضائعة مع كتابها. وإصلاح يوشيّا يكمن في الأساس في إعادة العمل بها. لكنه إصلاحٌ لم يدم طويلاً، وبقيت القرابين البشريّة تقليداً راسخاً في إسرائيل. وجاء بعد ديسّو العديد من الباحثين وأكثرهم وافقه الرأي، وأوّلهم الأميركي ألبرتو غرين الذي أكّد أن الأضحيات البشرية كانت مقبولة بصورة واضحة في إسرائيل، وجاءت بعده سوزان نيديتش فأظهرت أن مفهوم الإله الذي يشتهي الذبائح البشرية كان عنصراً أساسيّاً في ديانة إسرائيل القديمة. أمّا الباحثة الألمانية ميشايلّا بوكس فبيّنت أن تقدمة الأبناء قرابين كانت جزءاً من طقوس عبادة يهوه. في حين أكّد الباحث دميان ستاشرا أن الذبائح البشرية كانت أفضل القرابين ليهوه في إسرائيل القديمة. وجاء مؤخّراً الحاخام الإسرائيلي موشي رايس ليوافق سابقيه من الباحثين ويتبنّى مقولة القرابين البشرية ليهوه في ديانة إسرائيل القديمة.
وإلى ذلك يدرس ب1/ف3 ما حكي عن نزعة معادية للمرأة في قصّة نذر يفتاح ويفنّد آراء القائلين بذلك. لينتقل إلى دراسة طقوس النواح على بنت يفتاح ودلالاتها. ويتناول الربط بينها وبين طقوس خصب الأرض، ليلحظ أن طقوساً كهذه تضع الباحث على الحدود التي تفصل، أو بالحري تربط، بين الديانة والميثولوجيا، وهو ما سيعود ليفصّل الكلام فيه في ب3/ف2.
والفصل الرابع ب1/ف4: نذر يفتاح في تاريخ يوسيفوس اليهودي، يقدّم تعريباً لهذا النصّ اللاتيني، وهو أقدم ما وصلنا من نصوص يهودية عن قصّة يفتاح ونذره، ومن هنا أهمّيته. لا سيما وأنّه يقطع الشك باليقين مؤكّداً أن ذبيحة يفتاح المخالفة للشريعة كانت ذبيحة دمويّة حقيقيّة.
والفصل الخامس: ب1/ف5: نذر يفتاح في التلمود والترجوم والتراث اليهودي القديم، يُجري مسحاً عامّاً للروايات التفسيريّة اليهوديّة القديمة: التلمود والترجوم، ولا سيما ما ورد في العاديات البيبلية المنسوبة لفيلون الإسكندري، ويقدّم ترجمة أمينة لهذه النصوص التي جمعها الحاخام لويس غنزبرغ في رواية واحدة. ثم يعمد إلى تحليلها ومقارنتها بالتفاسير المسيحيّة الآبائية لقصّة يفتاح ونذره. ويرى أن الهمّ الأساسي لهذه الروايات اليهوديّة القديمة كان تقديم تبرير ما لذبيحة يفتاح الدموية المخالفة للشريعة. وترى رواية فيلون المنحول أن حكماء إسرائيل يومها كانوا قد نسوا حكم الشريعة الذي يحظّر تحظيراً تامّاً تقريب الأبناء أضحيات، ولعلّ في ذلك إشارة ما إلى نسيان كتاب الشريعة وضياعه الآنف الذكر.
الفصل السادس: ب1/ف6: التأويل المحدَث لنذر يفتاح، وهو من الفصول المهمّة. لأنّه يسبر عمق المسألة التفسيرية ليرفع التضادّ ويجلو حقيقة التأويل الذي لم يُعرف قبل القرون الوسطى. فما الذي دفع راداك أو رابي دافيد كيمحي إلى ابتداع هذا التأويل وترويجه؟ ولماذا تبنّاه من بعده العديد من المفسّرين اليهود ثم المسيحيين؟!
معاداة المسيحيّة كانت من أبرز دوافع راداك ووالده من قبله، وقد شاء في تأويله المحدَث أن يحرم المفسّرين المسيحيين من فرصة التوحيد بين ذبيحتيّ يفتاح والآب بابنه الوحيد، كما أكّد العالِم البيبلي جاكوبوس تيرينوس. أمّا من اعتمدوا تأويل راداك فدوافعهم كانت متعدّدة: الحاخامان جرسونيد واباربانل تأثّرا بالحياة الرهبانية وتبتّل العذارى المسيحيّات في الأديار المحيطة بهما، فتصوّرا أن بنت يفتاح كانت رائدة هذا النمط من التكرّس للهيكل والحياة الإلهيّة. أما العلّامة البيبلي المسيحي نيقولا دو لير، ومن تلاه من المفسّرين المسيحيين، فوجدوا في هذا التأويل أساساً توراتيّاً لنذر البتولية والحياة الرهبانية التي كانت رائجة ومألوفة في أوروبا المسيحيّة القروسطية. ورغم رواج هذا التأويل الكيمحاوي وتداوله، بقي بعيداً عن روح الرواية التوراتية وتقاليدها، وقد حذّر مارتن لوثر منه واعتبره تحريفاً للنص البيبلي الواضح.
الفصل السابع والأخير في الباب الأول: ب1/ف7: نذر يفتاح في تفاسير آباء الكنيسة. وهذه التفاسير لا تقلّ قِدماً وأصالة عن التفاسير اليهوديّة العتيقة. القدّيسان أمبروسيوس ويوحنا فم الذهب شدّدا على تسرّع يفتاح في نذره، أما اغسطينوس فتوقّف عنده في عدد من مؤلّفاته. ورأى عموماً أنّه نذرٌ لا يرضي الله. أمّا ثيودوريطس القورشي، فكرّر ما جاء في فيلون المنحول أنّه نذر أحمق، وعنه أخذ هذه المقولة أكثر المفسّرين السريان. وأوّلهم أفراهاط الذي رأى في يفتاح صورةً للمسيح. ووضع مار أفرام عدداً من الأناشيد في يفتاح واعتبره كاهناً يكهن بدمه،كما شدّد على بتوليّة بنت يفتاح واعتبرها صورة مسبقة لمريم العذراء وللبتولية المسيحيّة. وتوقّف تيودور بركوني عند انقراض طقوس النحيب على بنت يفتاح ودلالاته. أما المروزي فأبرز ما جاء في تفسيره قوله إن الوثنيين عبدوا بنت يفتاح وسمّوها اللات! في حين اعتبرها ديونيسيوس بن صليبا باكورة الشهيدات، وصورة للعذارى الشهيدات المسيحيّات في الاضطهاد الأربعيني زمن ملك الفرس شابور الثاني (329-379م).
والباب الثاني، ب2: بنت يفتاح في أشعار السريان، مخصّص لشاعرَين. الأوّل مار يعقوب السروجي الملفان، والثاني مار إسحاق.
والفصل الأول، ب2/ف1: مدخل إلى ميمر بنت يفتاح ليعقوب السروجي، يتوقّف عند سيرته ولاهوته وشاعريّته، وقصيدته في بنت يفتاح هي بلا ريب أطول القصائد وأشهرها في هذا الموضوع.
الفصل الثاني، ب2/ف2: الميمر 159 على بنت يفتاح للسروجي معرَّباً، يقدّم ترجمة لهذه الدرّة الشعرية والليتورجية تجمع بين الأمانة للأصل والغنائية الشعرية، وتضع في الهوامش تفاسير وحواشٍ تساعد على فهم القصيدة ورموزها ومجازاتها.
الفصل الثالث، ب2/ف3: قراءة في ميمر بنت يفتاح للسروجي يقدّم دراسة نقدية بيبلية وتفسيرية تحليليّة لهذه المطوّلة الشعرية. مثل وظيفة التكرار الليتورجية والتعليميّة فيها، ويتوقّف عند الصوَر المبدعة فيها، ويرى السروجي أن يفتاح كان صورة للآب، وذبيحته وابنته صورة للابن. أما البطل الحقيقي لملحمته الشعرية فخفيّ حيناً، وحاضرٌ دوماً، وهو الذي قُرّب ذبيحةً على الصليب.
والفصل الرابع، ب2/ف4: سوغيتا على يفتاح البارّ وابنته لمار إسحاق. يقدّم تعريباً كاملاً لقصيدة سريانيّة عُثر عليها مؤخّراً، ولا يُعرف عن ناظمها سوى الاسم: إسحاق. وفيها لمعات وصور شعرية مميّزة، وهي تتقاطع مع ميمر السروجي السابق الذكر حيناً، وتتمايز عنه أحياناً، ولا يُعرف أيّهما الأقدم. ويبقى أن لكلّ من القصيدتين نكهتها ورونقها وجوّها الغنائي والليتورجي الخاصّ.
والباب الثالث: ب3: بنت يفتاح في الميثولوجيا والمسرح والآداب الغربية. دراسة أدبية وتاريخيّة وميثولوجيّة مقارنة.
الفصل الأول، ب3/ف1: ذبيحتا بنت يفتاح وإيفيجينيا، غالباً ما قارن الباحثون والمفسّرون بين عذراوَين ذبيحتَين، فقيل عن إيفيجينيا إنها بنت يفتاح الإغريق، أو العكس. وهذا التشابه المدهش بين القصّتَين كيف يفسَّر؟! وأيهما الأقدم؟ ذهب بعض الباحثون البيبليّون المعاصرون أمثال توماس رومر إلى أن القصّة اليفتاحيّة صدى لأسطورة إيفيجينيا الإغريقية. في حين أكّد ألبرتو غرين، الآنف الذكر، أن ثمّة أثر مباشر لأسطورتَي إيفيجينيا وابن الملك إيدومينوس في قصّة بنت يفتاح. أياً يكن فلا يمكن بعد اليوم تفسير التوراة وتأويلها بمعزل عن التراث الأسطوري المجاور والمعاصر أو السابق لها.
الفصل الثاني: ب3/ف2: بنت يفتاح في الميثولوجيا شرقاً وغرباً، وهو يأتي ثانياً في الأهمّية والحجم ومباشرة بعد ب1/ف3. ولعلّها الدراسة الأولى لبنت يفتاح في الميثولوجيّات اللاحقة. ونقطة الانطلاقة ملاحظة المفسّر السرياني المروزي القائل إن الوثنيين عبدوا بنت يفتاح وسمّوها اللات. فمَن هي هذه الأخيرة وسائر بنات الله اللواتي يتحدّث عنهنّ القرآن؟ ويبدو أن اللات هي مؤنّث الله كما أكّد الطبري في تفسيره، وهي كانت كما الله من أبرز الآلهة المحلّيين عند الصفويين كما بيّن ديسّو. وهي كذلك إلهة عذراء انتقلت من النبطيين إلى عرب الجزيرة قبل الإسلام. ومع كلّ انتقال كانت تكسب أسماءً وصفاتٍ جديدة. ومع تغيّر الشعوب كانت وظيفتها تتغيّر، وكثيراً ما تقاطعت مع التقليد المسيحي، لا سيما وأنها اعتُبرت إلهة عذراء وأمّ الآلهة! وهي تقابل أرتميس عند اليونان، وهنا يعاد الربط مرّة أخرى بين أرتميس/إيفيجينيا و اللات/بنت يفتاح. ويدرس هذا الفصل القرابين البشريّة عند عرب الجاهلية المقدّمة لنجمة الصبح/اللات، ويورد الرواية التي سردها القدّيس نيلوس عن محاولة الجاهليين تقديم ابنه قرباناً لها، ليتوقّف بعدها عند ما ورد في السيرة النبويّة عن تقديم الجاهليين أبنائهم أضحياتٍ. ليخلص إلى تقليد عميق الدلالات وقضى بتأليه الأبناء/القرابين عند الجاهليين وغيرهم من الوثنيين، ممّا قد يشرح أسباب تأليه بنت يفتاح وتماهيها مع اللات!
والمصدر الثاني الذي يدرسه هذا الفصل رواية القدّيس إبيفانيوس عن تأليه السامريين لبنت يفتاح وعبادتهم لها. هل كان يقصد طقوس النحيب التي ذكرها النصّ التوراتي وسبقت الإشارة إليها؟ وما مغزى تماهيها عندهم مع إلهة الخصب الإغريقية Kore؟ وهكذا يعيد إبيفانيوس الربط بين طقوس المناحة على بنت يفتاح وطقوس الخصب، بل يماهي بينهما. ويبقى مجال البحث والتدقيق مفتوحاً على مصراعَيه في هذا الموضوع، لا سيما وأنه غابة شبه عذراء لم تطأها قدمٌ منذ زمن.
والفصل الثالث: ب3/ف3: قصيدة دو فيني في بنت يفتاح: تعريب ودراسة. وتحفة هذا الشاعر الفرنسي الرومنطيقي لعلّها من أجمل ما كُتب في الآداب الغربية عن بنت يفتاح. شاعرٌ رواقيّ الفلسفة، سوداوي المزاج، تشاؤمي النظرة. وكان موت بنت يفتاح بنظره صورة عن موت الذئب في قصيدته المشهورة، وكذلك عن موته هو وكان يراه قريباً. وفي قصيدته بنت يفتاح فجّر دو فيني نقمته الإلحادية على الإله: يهوه الإله الغيور الذي يهوى رائحة الدمّ والذبائح البشريّة. ويبقى أن الشاعر هو البطل الحقيقي لقصيدته: موتها صورة عن موته الآتي، وكلاهما من ضحايا الله.
ومن الآداب الغربية ننتقل إلى الأدب العربي واللبناني تحديداً، وذلك في الباب الرابع والأخير من الكتاب.
الباب الرابع: بنت يفتاح في الأدب اللبناني. أربعة أعمال شعرية ومسرحية خصّصت لبنت يفتاح في حقبة زمنية يسيرة لا تزيد عن عقدَين وسنتَين من الزمن 1913-1935. أمين صليبا، الخورأسقف يوسف الحايك، سعيد عقل، وبولس سلامة، كلٌّ كانت له محاولة شعرية في الموضوع. ولكلّ سيخصَّصُ فصل من هذا الباب الأخير.
الفصل الأول، ب4/ف1: مقاربة نقديّة لكتاب “نذر يفتاح”، يعود إلى نقطة البداية ألا وهي كتاب أمين صليبا، ولكنّه يدرسه هنا دراسة نقديّة أدبيّة: ما قيمة أشعاره؟ وما مدى نجاح حبكته القصصيّة في التشويق والإثارة؟ ويكفي الأمين فخراً أن يكون رائد الإبداعات اليفتاحيّة في الأدب العربي عموماً، واللبناني خصوصاً، وكان من شأن سِفره هذا أن ينبّه معاصريه من الأدباء والشعراء، ويجعلهم يقدحون قريحتهم في هذا الموضوع البيبلي الوطنيّ.
والفصل الثاني، ب4/ف2: عذراء يفتاح للمونسنيور الحايك. مسرحية استوحت تأويل النذر بالبتولية الدائمة، وروت قصّة بنت يفتاح في الخطّ الذي اعتمده يوربيديس في رواية قصة إيفيجينيا. ولا شكّ أن الحايك قرأ مسرحية “إيفيجينا في أوليس” لهذا الشاعر الإغريقي، كما قرأ مسرحيّة إيفيجينيا لراسين واستوحى منهما لا سيما في خاتمة مسرحيّته. وكان أوّل من مسرَحَ بنت يفتاح من اللبنانيين. بيد أن مسرحيّته تكاد تؤلّه العنف، وهي تجعله مقدّساً وتحوّل حرب يفتاح إلى جهاد دينيّ ضد الشرك والوثنيّة. ويدرس هذا الفصل خصائص مسرحية الحايك: أين أبدع وأين أسفّ؟ وحيث وفّق في الحبكة المسرحيّة وحيث أخفق. وكيف تنقلب الأدوار عنده بين مشهد وآخر يتلوه. ليتوقّف ختاماً عند الغنائية الشجيّة والأشعار المغنّاة وهي أحلى ما في المسرحيّة.
والفصل الثالث، ب4/ف3: بنت يفتاح في إبداع سعيد عقل. يتناول بالدراسة والتحليل تحفة الشاعر اللبناني سعيد عقل المسرحية/المأساة “بنت يفتاح”. وهي جديرة بامتياز أن تكون جوهرة ترصّع جبين الأدب العالمي. ولعلّها أبرز مسرحية في هذا الموضوع. أراد سعيد عقل أن يكتب مأساة، لا فاجعة. والمأساة تلتزم بدقّة باحترام الوحدات الثلاث: وحدة المكان والزمان والأزمة. واختار نهج راسين، وإن أضفى على شخصيّاته مسحة مثالية من كورناي. وأضاف على الرواية التوراتية عناصر تجعل الأزمة تشتدّ وتصل إلى الذروة، فجعل أمّ يفتاح مجنونة تلاحقه، وابنته تجهل هويّته الحقيقيّة، لا سيما وأنّه ربّاها على كره يفتاح، وهي لن تعرف حقيقة أبيها وجدّتها إلا في اللحظة التي تدرك فيها أنّها ستكون الأضحية على مذبح يهوه. وقد أبدع الشاعر في إضفاء طابع غنائي شجي على مسرحيّته جسّدته الحوارات ولا سيما الأناشيد التي يحفل بها هذا العمل المسرحي وأبرزها نشيد الحرّية وهو فاتحة المأساة. وتظهّر الدراسة عناصر الفكرة اللبنانية الحاضرة في هذه المسرحية. ثم تورد نقد أنطون سعادة لها، لتضعه بدوره في غربال النقد. فتشير إلى النزعة التوتاليتارية في مقاربة الزعيم للأعمال الأدبية، وإلى الطابع المُعادي للساميّة الذي يشوب فكره القوميّ. وتبيّن أن المسرحية حافلة بالقيَم الروحية والوطنيّة وهي تتخطّى البعد القومي الضيّق الذي يتقوقع فيه دعاة القوميّة الضيّقة. والخلاصة فهي تحفة شعريّة خالدة وذروة من ذرى الأدب اللبناني والعربي. ولا تقارَن بمسرحيّة الحايك ولا حتى بقصيدة بولس سلامه الملحمية التي ستُدرَس في الفصل التالي.
الفصل الرابع، ب4/ف4: قصيدة بنت يفتاح لبولس سلامه. وميزة هذا الفصل أنه يورد النص الكامل لهذه القصيدة الملحميّة التي يصعب إيجادها، إذ لم تُنشر في أيّ من دواوين الشاعر، وقد بذل الباحث جهداً ملحوظاً للحصول عليها، وكذلك لنشرها. إذ عمد إلى شرح مفرداتها الصعبة، وما أكثرها، وإلى تشكيل الأبيات بالحركات المناسبة لتسهيل قراءتها وفهم مضامينها. ثمّ عقّب عليها بمبحث تناول فيه المنافسة الشعرية التي حَميت بين سعيد عقل وسلامه في الثلاثينات، وكانت بنت يفتاح واحدة من أبرز مواضيعها، وكان حكم شيخ النقّاد مارون عبّود سلبياً على قصيدة سلامه هذه، فاعتبرها من الصغائر ودمى الأدب. ولعلّه لم يجانب الصواب في حكمه هذا. فالقصيدة يكثر فيها النظم على حساب الشعر. بيد أنها لا تخلو من لُمَع ابتكار وإبداع أشار إليها الباحث ووضَعها في رقعة الضوء إنصافاً لهذا الشاعر الذي عاد ليبدع شعراً ملحميّاً خالداً.
والسؤال المركزي هل: كان لهذه الأعمال الشعرية الأربعة في بنت يفتاح أثر ما في الأدب اللبناني؟ والجواب يحمله الفصل التالي.
الفصل الخامس، ب4/ف5: بنت يفتاح وغِربة بطلة جبال الصوّان. طالما اعتُبرت بنت يفتاح رمزاً للحرّية، لا سيما حرّية الأوطان، وللتضحية. فمنذ يوسيفوس المؤرّخ درج المفسّرون والشعراء والمسرحيّون على استلهام معاني الحرّية الوطنيّة من تضحيتها، وسعيد عقل استهلّ مسرحيّته عنها بنشيد الحرّية في دلالة واضحة على هذا الرمز. وفي غِربة بطلة مسرحية جبال الصوّان للأخوَين رحباني ملامح يفتاحيّة جليّة يحلّلها هذا الفصل ويتوقّف عند دلالاتها: كلاهما ابنتان وحيدتان ومنذورتان للموت في سبيل الوطن والحرّية، وثمّة نقاط شبه أخرى عديدة يعرضها الباحث محلّلاً المسرحيّة الرحبانية في أبرز محاورها وشخصيّاتها، فرمزيّة موت غربة على البوّابة بيبلية بامتياز. وغِربة هي عروس الدمّ وعذراء كان عرسها على بوّابة وطنها كما كان عرس بنت يفتاح على المحرقة. بيد أن غِربة ذبيحة يفتاحيّة ممسحنة، تماماً كما مسحن آباء الكنيسة وشعراؤها، من أمثال السروجي، ذبيحة بنت يفتاح وجعلوها صورة ممهّدة لذبيحة الجلجلة. وغِربة تقول إنها حبّة القمح التي جاءت لتنزرع في أرضها، كما شبّه الناصري نفسه بحبّة القمح التي تموت في الأرض كي لا تبقى مفردة. (يوحنا12/24).
ولكن ما هو مصدر هذه المُسحة اليفتاحيّة في المسرح الرحبانيّ؟ لعلّها نتيجة تأثّر بالمسرح السعقليّ. وكان عقل من أبرز ملهمي الرحبانييَن، وترك أثراً بيّناً في آثارهما الشعريّة والمسرحيّة.
وبهذا الفصل الرحبانيّ تختم الدراسة، وفي الحديث عن هذه المسرحيّة الغنائية الحافلة بالأبعاد الوطنيّة والإنسانيّة، والإبداعات الموسيقية والشعريّة مسكُ ختام.
ومن دواعي سرور المؤلّف وحبوره أن يخوض في دراسة مزدوجة الطابع أدبية/بيبلية في آن، وهو الذي قادته دراسة الآداب والنصوص وتحليلها إلى علوم الأديان. ولكن هل من فرقٍ بين مقاربة وتحليل وتفسير نصّ مقدّس ونصّ آخر أدبي؟!
عقلية الإنسان وتقديسه للأشياء والنصوص وحدها خلقت هذا الفرق وابتدعت الحدود واصطنعت الحواجز بين نصّ ونصّ. سبقت الإشارة، في هذا البحث، ونقلاً عن العالِم البيبلي الأب لويس خليفة، إلى أنّ “اكتشاف الأنواع الأدبية في البيبليا حدثٌ ولا أهمّ في تاريخ تفسيرها. وبفضلها خطا التفسير البيبلي خطواتٍ عملاقة في استكشاف كلمة الله على حقيقتها وواقعيّتها” (خاتمة ب3/ف1).
والتقديس عنصرٌ خارجٌ عن النص، وليس من داخله، والتحليل والتفسير كي يصيب كبد الحقيقة لا بدّ له أن يبدأ بدراسة النصّ من الداخل، وإلا بقي غريباً عن الكثير من مضامينه. وهذا كان دأب الباحث في هذا السِفر: دراسة النصوص البيبلية والأدبية والميثولوجيّة من الداخل لاستخراج مضامينها ودلالاتها وإشاراتها وتلميحاتها وإخراجها ووضعها في رقعة الضوء.
وهو بالطبع لا يزعم أنه قال الكلمة الفصل في هذا المجال. حسبه أنه جَروء على خوض غمار وبحار موضوع قلّ من تطرّق إليه بالعربية، وعساه يكون بعمله هذا قد مهّد الطريق لآخرين.
Q.J.C.S.T.B
باريس في 9/10/2019
[1] -صليبا، د. لويس، الفكر اليهودي بين الخصوصيّة والشموليّة، دراسة وتقديم لتلمود اليهوديّة المعاصرة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2016، تهمة استنزاف الدمّ، ص43-77.
[2] -صليبا، د. لويس، من تاريخ الصهيونيّة في أرض الإسلام دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2017، ف5: مقتل الأب الكبّوشي، ص123-158.
[3] -خيرالله صليبا، أمين ظاهر، البيان الصُراح عن نذر يفتاح، دمشق، المطبعة البطريركية الأرثوذكسية، ط1، 1913، ط2:دار ومكتبة بيبليون-جبيل/لبنان 2019، 104ص.
 دار بيبليون
دار بيبليون