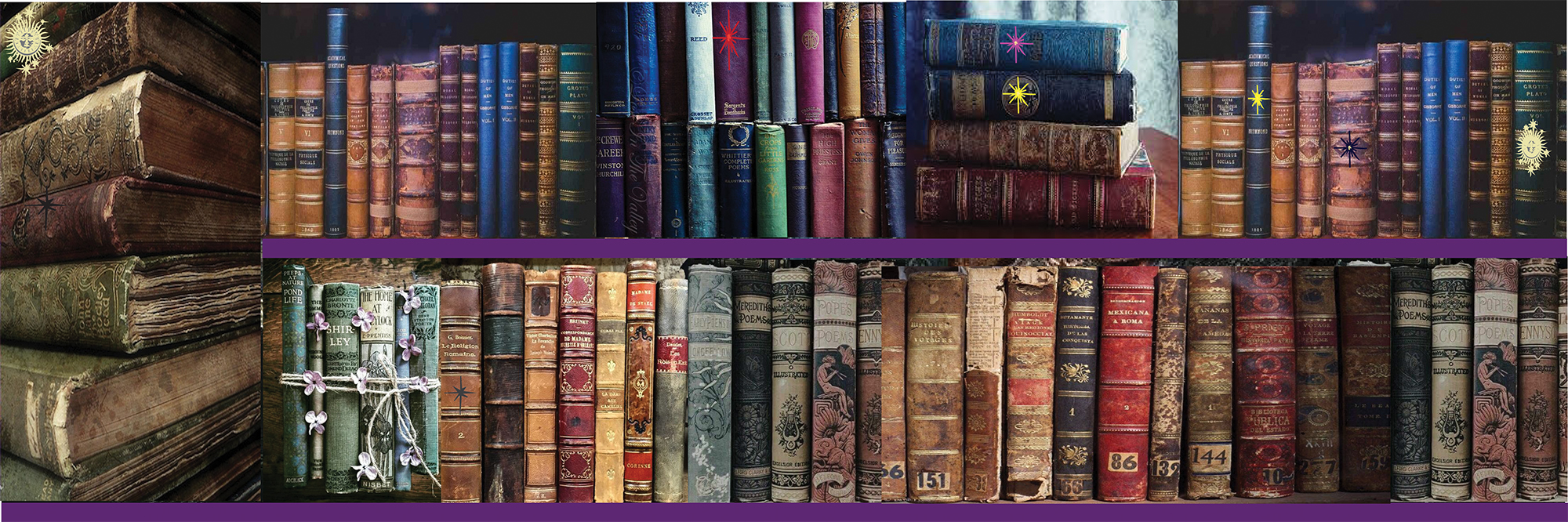نصّ محاضرة أُلقيت بالألمانية في “مؤتمر المسلمين التقدميين”، مؤسسة فريدريش أبرت، برلين 22 – 24 تشرين الأول 2009، ونُشرت في مجلة الحداثة (بيروت)، 125/126 (2009)، ص 131 – 138.
عبد الرؤوف سنّو
أستاذ في الجامعة اللبنانية
ظهر الإسلام في الجزيرة العربية، ومنها انتشر من خلال الجهد العسكري أو الديني. وبعد قرن من الزمن على ظهوره أصبح عالمياً، تجسده دولة لها مؤسساتها وتخضع شعوباً وأدياناً. ولا تزال الفتوحات الإسلامية حتى اليوم موضوع نقاش أكاديمي وشعبي، وفق رؤى مختلفة حول طبيعة هذا التوسع ونتائجه.
1- الفتوحات الإسلامية: إشكاليات الماضي والحاضر
استند المسلمون في فتوحاتهم إلى آيات قرآنية تحثهم على الجهاد وفق تفسيرات ملتبسة حول وسائل تحقيقه. وإذا كانت غاية هذا المؤتمر هي ممارسة النقد لكل ما جرى من فتوحات باسم الإسلام على أيدي مسلمين، فأقول إن غالبية المسلمين لم تستطيع، لا في الماضي ولا في الحاضر، سواء أكانوا أفراداً أم مثقفين، أن يمارسوا بعقلانية نقداً لهذه التجربة: أولاً، باعتبار أن الجهاد أمر مفروض من الله ولا يجوز شرعاً الخوض فيه، وثانياً، بسبب التداخل المحكم بين ما هو ديني وما هو دنيوي. فتستخدم غالبية المسلمين الملتزمين الشريعة من أجل الدفاع عن الإسلام، وترى فيها كل الحلول لمشكلات الحاضر والمستقبل. فتتجنب الاجتهاد خشية أن يفتح الباب أمام حرية سلطة العقل واستخدام معايير ومفاهيم علمية لنقد التاريخ الإسلامي أو نقد الشريعة، والقول إنها لم تعد تتماشى مع مقتضيات الظروف الراهنة. وهناك قلة صغيرة من المسلمين تخشى توجيه النقد إلى الإسلام، دين ومؤسسة، بدافع الخوف أو الخشية من العزلة الاجتماعية، كما حصل لعدد من شيوخ الأزهر. وتقف المؤسسة الدينية، مدعومة من المؤسسة السياسية، بالمرصاد ضد أي منحى للنقد يمسّ الإسلام جوهراً وشكلاً وبالتالي نفوذها، والذي قد يأتي من داخل البيت الإسلامي. والشواهد على ذلك كثيرة: من إخوان الصفا، والسهروردي والحلاج وعلي عبد الرازق وطه حسين وصادق جلال العظم، وآخرها سلمان رشدي ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي. كما تتصدى المؤسسة الدينية ويساندها المجتمع الإسلامي في أية بقعة من بلاد الإسلام بقوة لأي مسّ وتشويه ونقذ لاذع يصيب الإسلام يأتي من الخارج، كالرسوم الكاريكاتورية التي تتعرض بخسّة للنبي محمد.
في مقابل الرؤية الإسلامية، تنظر معظم الأدبيات الغربية إلى الفتوحات الإسلامية بمفاهيم الحاضر، مستخدمة حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الدولي والحدود القومية للدول لإطلاق إحكام على تجربة تاريخية ولّت، لكن آثارها لا تزال تتفاعل حتى اليوم. إنها معايير لا تصح في كتابة التاريخ الذي من أولى منهجياته ألا نقيس الماضي على الحاضر مطلقاً، بل التعلم من الماضي وتجاربه. فتخلط تلك الأدبيات الغربية ما بين الإسلام كدين والإسلام السياسي، كدولة ومؤسسات. فالإسلام كدين، انتشر في بعض مراحله كالمسيحية من دون فتوحات عسكرية، وعلى سبيل المثال ما حصل في جنوب شرق آسيا من خلال الدعوة والتجارة. فكان مثالاً على التعايش مع الأديان الأخرى. أما الذي انتشر بحد السيف، فهو الإسلام السياسي من أجل تأمين ما نسميه اليوم “المجال الحيوي” (Lebensraum)، وإقامة إمبراطورية واسعة الأرجاء، عبر ضم أراضٍ وأقاليم وشعوباً جديدة إليها، وبالتالي تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية. وهذا لم يحدث من دون سفك الدماء أو إخضاع “الآخر” لنظام غريب. إن ما تتذرع به الأدبيات الإسلامية بأن الجهاد اقتصر على التوسع ونشر الدين الجديد فحسب، هو برأينا، عباءة لتغطية أهدافاً سياسية واقتصادية.
لقد فعل العثمانيون الشيء نفسه، خلال توسعهم في الشمال الغربي من آسيا الصغرى أو بعد عبورهم إلى أوروبا، أو في مدّ حدود سيطرتهم على البلاد العربية. ومن المؤكد أن بناء إمبراطوريتهم الواسعة تجاوز كل مسوغات الجهاد، عبر التوسع في مناطق خارج الأطر الدينية أو اللغوية أو العرقية التركية، بهدف المنافع السياسية والاقتصادية، وهو ما أُطلق عليه في القرن التاسع عشر تسمية “التوسع الإمبريالي”. فالجزية ونظام الدفشرمة، كانا أسوأ ما مارسه العثمانيون من إساءة إلى حقوق الإنسان بمفاهيم اليوم، وراء أسلمة الكثيرين من الألبانيين وغيرهم. وباسم الإسلام والجهاد في سبيله، فرض العثمانيون سيطرتهم على الشعوب العربية، وقبلت بها تلك الشعوب زهاء أربعة قرون,
رغم شعارات الجهاد، تبقى الفتوحات الإسلامية ومن ضمنه العثمانية، وفق معايير حقوق الإنسان اليوم، توسعاً إمبريالياً لفرض دين وقيم وعادات على شعوب أخرى أو إخضاعها لسلطة أجنبية وسلبها حقوقها الطبيعية. لقد تأسست كل الإمبراطوريات القديمة بواسطة قهر “الآخر” وإخضاعه واستغلاله، وسارت الإمبراطوريات في العصور الوسطى في الطريق نفسه، وليس الدولة الإسلامية وحدها. ثم جاء الاستعمار ليكوّن إمبراطوريات على حساب الشعوب الأخرى واستعبادها، والانتداب بعد الحرب العالمية الأولى ليحقق أهدافه تحت ستار النهوض بالشعوب التي كانت تخضع لحكم أجنبي. حتى الدول القومية الحديثة، شهدت حروباً وسفك دماء في سياق تشكلها، فدخلت شعوب وأعراق غريبة وأراضٍ في نطاق هذه التشكيل. لكن الفرق بين الفتوحات الإسلامية من جهة والحروب الصليبية القديمة وكل أنواع “الصليبية الجديدة”، وفق ما يصطلح عليه المسلمون الملتزمون، أن المسلم يمارس النقد تجاه تجربته السلبية مع الغرب والاستعمار، وتبيان الصفحات الناصعة في مقاومته له، وصولاً إلى حروب اليوم، فيما يمتنع عن ذلك بالنسبة إلى الفتوحات الإسلامية، باعتبارها أمراً مفروضاً من الله. فيتم التغاضي عمداً عما ألحقته الفتوحات الإسلامية من أذى للآخرين، معنوياً أو جسدياً، والتستر وراء آيات قرآنية متعددة التفاسير لتبرير “الجهاد” العسكري. في المقابل، يُمارس الغرب وعلمائه النقد لكل تاريخه، وهذا يعود إلى استخدامهم سلطة العقل والعلمنة والثقافة المجتمعية والنظرة العلمية إلى الأمور، فضلاً عن اعتماد منهجيات حديثة لتفسير التاريخ، وليس أقلها الجدلية التاريخية.
2- نظام “أهل الذمة” تسامح ديني أم مصالح اقتصادية؟
إن أحد أوجه النقد للفتوحات الإسلامية يطال نظام “أهل الذمة”، الذي نظم بصورة فريدة لا سابقة لها عملية خضوع غير المسلمين إلى الإسلام كمؤسسة سياسية ومجتمعية. وبموجب هذا النظام، انقسم المجتمع في “دار الإسلام” بين مسلمين أصحاب السيادة، وبين “أهل الكتاب” في درجة أدنى. ووفق الشروط العمرية الملتبسة، التي لم تُطبق في كل العهود الإسلامية، أو ربما لم تكن موجودة أصلاً، وفق أرثور تريتون (Arthur Tritton). فكان لا يُسمح للذمي بالانخراط في النظام السياسي، ولا في الجيش، ومن سُمح لهم بدخول الإدارة بتولي مناصب عليا، كالوزارة أو الدواوين، لم يلبثوا أن اعتنقوا تدريجاً الإسلام مكرهين في الغالب للحفاظ على مناصبهم. وعلى الصعيد الاجتماعي، مُنع الذمي من الزواج من مسلمة وفق الشرع الإسلامي و”الشرع” السياسي – المجتمعي، وتعرض للإهانات والتعسف والظلم، من أوامر خاصة بالملابس والسلوك في الشارع، ومصادرة الممتلكات ودور العبادة وتحويلها إلى مساجد.
إن الخيارات الثلاثة التي واجهها غير المسلمين: إما الحرب أو اعتناق الإسلام أو الاحتفاظ بدينهم ودفع الخراج على الأرض والجزية على الرأس، لقاء الحصول نظرياً على حماية الدولة الإسلامية ورعايتها وتقديمهم الولاء والطاعة لها والقبول بالتموضع في مرتبة اجتماعية أدنى، تبقى في ضوء مفاهيم اليوم، بعيدة عن التسامح وحقوق الإنسان. إن نظرية إما أو، جعلت المسيحية تختفي من الجزيرة العربية وبلاد الشام، بسبب ثقل الجزية أولاً، والإزدراء الاجتماعي ثانياً والتهميش السياسي ثالثاً. فيُزعم أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أتهم المسيحيين بنشر الوباء في الجزيرة العربية، ثم اجتهد بالقول ناقلاً عن الرسول: إن دينين لا يجتمعان معاً في الجزيرة العربية، وبالتالي تمّ ترحيل كل المسيحيين من جزيرة العرب، بمن فيهم مسيحيو نجران الذي حملوا عهداً من الرسول.
وعلى الرغم من ذلك، علينا أن نفهم الثقافة الدينية والسياسية والمجتمعية التي جعلت الدولة الإسلامية تبتدع نظام “أهل الذمة”، وليس غيره:
1- لم يكن بإمكان الدولة الإسلامية استيعاب “أهل الذمة” بعقائدهم وفق مفهوم المواطنة الحديثة التي تجعل المواطنين سواسية. فالإسلام عرف الأخوة في الدين التي هي أساس النظام الاجتماعي، التي انبثقت عنها نظرية “الأمة الإسلامية”، وليس الأخوة الإنسانية، أو المواطنة التي تجعل أفراد المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الاثنية، مواطنين لا رعايا. فالوطن بالنسبة إلى المسلمين هو “دار الإسلام”، حيث تسود الأمة الإسلامية وتُطبق فيها الشريعة، وتعيش مختلف الشعوب والأعراق الخاضعة لسلطة الإسلام، من دون أن تحصل على الحقوق التي يتمتع بها المواطن المسلم، رغم أن تلك الشعوب وأصحاب الأديان كانوا يدفعون ما يتوجب عليهم من ضرائب محقة أو جائرة، وتعرضوا في بعض العهود إلى معاملة سيئة.
2- تؤكد الأدبيات الإسلامية باستمرار أن تطبيق نظام “أهل الذمة” هو دليل التسامح الإسلامي، وهذا برأينا ليس كل الحقيقة. فخلف النظام المذكور، كمنت كل المصالح الاقتصادية للنظام الإسلامي الحاكم. فكان السادة المسلمون أمام خيارين: إما أسلمة غير المسلمين بالقوة وخسارة الجزية، أو إجبارهم على دفع الجزية والخراج، حيث كانـــت الضريبة الأخيرة تُدفــع إلـى جانــــب الضريبة الأولـــى بالنسبة إلـــى الفلاحين مـن هـــم علـــى غير ديــن الإسلام. وكــــان احتفاظ “أهل الذمة” بعقائدهم يعني انسياب الأموال بغزارة إلى “بيت المال” الإسلامي. ومن هنا، جرى ابتداع نظام “أهل الذمة” لجباية الضرائب من غير المسلمين، وتغليف ذلك بستار
التسامح.
إن توسع المسلمين من العرب البدو إلى خارج الجزيرة العربية، لم يكن هدفه الوحيد نشر الإسلام، ولكن لإيجاد “مجال حيوي” اقتصادي للدولة الإسلامية الناشئة، ذلك أن موارد الجزيرة العربية لم تعد تكفي أهلها. قبل ظهور الإسلام، كان الاقتصاد البدوي يقوم في معظمه على الغزو، وبعد ظهور الإسلام، استمر هذا الغزو، وهذه المرة إلى خارج الجزيرة العربية، تحت شعار “الجهاد”. في البداية، جرى التوسع في اتجاه المدن والحواضر التجارية من أجل وضع التجارة تحت السيطرة الإسلامية، ثم بعد ذلك السيطرة على الأرياف ومن يعمل عليها من غير المسلمين لتأمين التزود بالمنتجات الزراعية. من هنا، لم يجر التشدد في فرض الإسلام على “أهل الذمة”، خشية أن تنقص موارد “بيت المال”، والشواهد على ذلك كثيرة.
عندما هبطت العائدات المالية للدولة لإسلامية، بسبب دخول غير المسلمين في الدين الحنيف، أُجبر المنخرطون الجدد في الإسلام على الاستمرار في دفع الجزية، إلى أن قام الخليفة عمر بن عبد العزيز (717 – 720م) برفعها عنهم. ولم تكن سياسة الخليفة المذكور نموذجاً للعهود الإسلامية الأخرى. لكنها كانت دليلاً على أن الجزية التي ذكرها القرآن، كانت في أساس الاقتصاد الإسلامي. وعندما حثّ أحد الحكام المسلمين المسيحيين المصريين على البقاء على دينهم، لم يكن هذا دليلاً على التسامح الإسلامي، بل مسألة اقتصادية، كي لا تهبط عائدات الجزية.
وكلما توسعت الدولة الإسلامية، كلما تراجع “التسامح”، وأصبح وضع “أهل الذمة” أشد هشاشة. فيصبح الشارع أكثر ضيقاً على الأقليات، والإسلام الرسمي أشد فظاظة، والعلماء أكثر بعداً عن التسامح. في عصر الرسول محمد، استفاد “أهل الذمة” الفقراء من أموال “بيت المال”. وعندما أبرم الأقباط معاهدة مع المسلمين الفاتحين لمصر، حُدد حجم الجزية بمقدار فيضان نهر النيل عند وصوله إلى منتهاه، وهذا دليل تسامح اجتماعي – مالي في إطار نظام “أهل الذمة” في العصر الإسلامي الأول. ومع الوقت، جرت الإطاحة بضمانات الخليفة عمر بن الخطاب للمسيحيين في منع هدم كنائسهم أو تحويلها إلى مساجد، وبإعفاء المسيحيين العرب من الجزية، كما فعل بعض الخلفاء الأوائل، والتي كانت تفرض على الرجال البالغين. كما توقفت عملية استفادة الذمي من “بيت المال”.
على كل حال، من الخطأ الاعتقاد أن “أهل الذمة” هم وحدهم من تعرض للظلم والقهر على يد النظام الإسلامي. فالمسألة برأينا سياسية تتعلق بالولاء للسلطة، واقتصادية تتعلق بالموارد المالية للدولة، وشملت المجتمع ككل، حيث كان “أهل الذمة” الحلقة الاجتماعية الأضعف تجاه الدولة والمجتمع الإسلامي. فكانت المصادرات التي تطالهم للاستفادة الشخصية منها في الغالب، تطال كذلك مسلمين. بعد الخليفة عمر بن عبد العزيز، وبين سنتي 739 و772، نشبت ثورات عدة في مصر شارك فيها أقباط ومسلمون، بسبب فرض ضرائب قاسية. إلا أن تعرض المسلمين والمسيحيين معاً للظلم والاضطهاد، لم يؤد إلى كسر الحواجز الاجتماعية بينهما بسبب الانتماء الديني؛ فظلت نظرة المسلم إلى نفسه على أنه وحده المكوّن للأمة الإسلامية صاحبة السيادة في “دار الإسلام”، بينما يندرج الذمي في مرتبة أدنى. وإذا ما حصل أي خلل في هذه المعادلة من ناحية إزالة مظاهر التمايز الاجتماعي والسماح بترميم الكنائس، وحصول المسيحيين على مراكز رفيعة في الإدارات المالية والضريبية في الدولة، كانت الاضطرابات تندلع، ويتعرض “أهل الذمة” للقهر والتعسف. وتبقى الصفحة السوداء في عهود عدد من الخلفاء المسلمين، لاسيما المتوكل على الله (822 – 861 م) الذي اتخذ تدابير قاسية ضد الشيعة، واعتمد سياسة قمعية ضد غير المسلمين، وأرغمهم على التقيد كلياً بـ “الشروط العمرية” في ما يتعلق بوضعهم كذميين، ولاسيما لباسهم ونظهرهم الخارجي. وكذلك الحاكم بأمر الله الفاطمي (985 – 1021 م)، إذ تعرض المسيحيون والمسلمون معاً للظلم والقتل والمصادرة، حتى أن الحاكم بأمر الله أمر بهدم الكنائس والأديرة، ومنها كنيسة القيامة (التي لا تزال تُسمى حتى اليوم في المصادر الإسلامية كنيسة القيامة)، متجاوزاً العهد الشهير لعمر بن الخطاب في كيفية التعاطي مع “أهل الكتاب”. واللافت أنه سمح خلال حكمه للمسيحيين الذين أُجبروا على اعتناق الإسلام أن يعودوا إلى ديانتهم الأولى، من دون أن يعاقبوا على ارتدادهم. فهل كان هذا بضغط من البيزنطيين.
وفي إطار نفي التهم حول عدم التسامح، تركز الأدبيات الإسلامية على أن بعضاً من “أهل الذمة” كانوا مقربين من الحكام المسلمين ومن السلطات، وأنهم أسهموا بجدارة في الحركة العلمية والترجمة، وفي الإدارة النهوض بالحضارة الإسلامية. وقد فعل العثمانيون الشيء نفسه مع اليونانيين والأرمن لجعلهم يخدمون في إدارة العلاقات الخارجية، وهذا ليس مرده التسامح الإسلامي، وإنما ضرورات الحاجة إليهم، حيث كان النقص أو التقصير العثماني واضحاً في مجال الإلمام باللغات الأجنبية وإدارة العلاقات الدبلوماسية.
3- الوجود الصليبيين وبعده: تدهور أوضاع المسيحيين الشرقيين
لقد زادت حروب الفرنج (الصليبيين) من النفور بين المسلمين والمسيحيين في مصر وبلاد الشام، وأصبح الآخرون مشتبهاً بهم بأنهم يتعاملون مع المسيحي الأجنبي الذي يهاجم “دار الإسلام”، مع أن التاريخ يؤكد أن قادة مسلمين تعاونوا مع الفرنج، وأن قسماً كبيراً من المسيحيين الشرقيين لم يقف إلى جانب الفرنج، ورفض أن يشكل حزاماً بشرياً كي يُحكم الفرنج السيطرة على القدس. رغم ذلك، تعرض المسيحيون للإكراه على تمويل الحروب ضد الفرنج من خلال المصادرات والضرائب الباهظة.
بعد انتهاء حروب الفرنج، وجدت المسيحية الشرقية نفسها من جديد وحيدة مع الإسلام. إن هبوط الجزية في مصر وبلاد الشام هو دليل على التحول إلى الإسلام أو هجرتهم. صحيح أن المماليك منحوا تجاراً مسيحيين امتيازات تجارية لغايات اقتصادية، إلا أن حاجتهم الماسة إلى الأموال، جعلتهم يصادرون أموال الأغنياء، مسلمين ومسيحيين، وبما أن التجارة في مصر وبلاد الشام كانت بغالبيتها في أيدي المسيحيين، فقد طالهم الظلم أكثر. كما عمد المماليك إلى هدم الكنائس كنوع من العقاب ومصادرة أملاك كبار رجال الدين المسيحيين، وفرض ضرائب استثنائية جائرة على المسيحيين، مع أن الإسلام يُحرم هكذا ممارسات. إن دعوات البابوية للثأر من المسلمين والإسلام ساعدت على موجة العداء ضد المسيحيين المحليين. فقام المماليك بذلك على خير وجه، علماً أن التجار الإيطاليين استمروا يزودون المماليك ومن قبلهم الأيوبيين بالأرقاء الضروريين لقوة جيشهم، فضلاً عن تزويدهم أيضاً بالحديد والأخشاب التي كانوا يفتقرون إليها من أجل بناء الأساطيل، ما يعني أنه لم يكن للكسب التجاري أية هوية. وبمناسبة سقوط القسطنطينية عام 1453، صادر السلطان المملوكي في مصر أملاك بعض المسيحيين، وسجن بعضهم وهدم بعض الكنائس. وفي بلاد الشام، جرت الاحتفالات بمناسبة الانتصار على “الكفرة”.
4- المسيحيون في الدولة العثمانية: بين “نظام الملة” والمواطنة المرفوضة
لم يتعرض المسيحيون إلى الاضطهاد السافر على أيدي العثمانيين، إذ كان هناك تسامح عثماني في بداية تأسيس الدولة، حتى أن أمراء مسيحيين في غرب آسيا حاربوا إلى جانب العثمانيين للتخلص من الحكم البيزنطي، استمروا يستفيدون من نظام التيمار حتى نهاية القرن الخامس عشر. وعندما أُجبر اليهود على الفرار من إسبانيا، رحبت بهم الدولة العثمانية. فتمتعوا والمسيحيون، في ظل “نظام الملة” العثماني، بوضع مريح، وبشكل خاص بطريرك الروم الأرثوذكس، الذي تبوأ مكانة رفيعة ومميزة في السلطنة. فكانت الدولة العثمانية أكبر مختبر للتعددية الدينية والعرقية. لكن عندما أخذ الأمر يتعلق بالولاء السياسي، وبدأت “عقود الأمن” (الامتيازات الأجنبية) والمسألة الشرقية تسبب خطراً على سلامة السلطنة، ودخل مسيحيو السلطنة في مشاريع الدول الأوروبية، تعرضوا لقهر السلطة ولحملات شعبية، خاصة عندما كانت الهزائم تُلحق بالسلطنة على أيدي الأوروبيين. وهذا ما حصل أثناء الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر. وفي عام 1820، أقدم السلطان محمود الثاني على إعدام بطريرك الأرثوذكس جورجيوس بتهمة التحريض على الثورة في اليونان، في أجواء هياج شعبي عثماني ضد المسيحيين بسبب الثورة في اليونان. وفي عام 1860، كان الحسد الاقتصادي وراء المذابح بين المسلمين والمسيحيين في دمشق وجبل لبنان. كما غضّ السلطان عبد الحميد الثاني الطرف، وربما بأمر منه، عن مذابح الأكراد ضد الأرمن، وحصل الشيء الأسوأ منه خلال الحرب العالمية الأولى.
عندما أتى الحلّ للمسألة الدينية في السلطنة العثمانية على يد أوروبا، بخلق مواطنة عثمانية تقوم على إصلاحات وتؤسس لتسامح متبادل بين المسلمين والمسيحيين، حصل رفض إسلامي – مسيحي مزدوج للتنظيمات العثمانية. فاعتبرها المسلمون ضربة قاصمة لسيادة الأمة الإسلامية، ورفضوا أية مساواة بينهم وبين المسلمين. أما المسيحيون، فلم يعنيهم الوطن العثماني بشيء، وفضلوا البقاء تحت “نظام الملة” والحماية الأجنبية ودفع الجزية، التي نصت مراسيم الإصلاح على إلغائها، لقاء عدم الخدمة العسكرية والحصول على شيء من الحرية في إدارة شؤونهم، وبالتالي إدارة اقتصادهم الخاص والتفوق على المسلمين اقتصادياً وثقافياً. في المقابل، لم يجد المسلم من يحميه، عندما كان يهجر رزقه وأرضه لتأدية الخدمة العسكرية. لقد ركزت الأبحاث على ما تعرض له المسيحيون في الدولة العثمانية من ظلم وقهر، وهذ صحيح، وأغفلت أوضاع المسلمين. وما أريد قوله، أن غير المسلمين كانوا أقل عرضة للاضطهاد العثماني من مواطنيهم المسلمين، جراء تدخل الدول الأوروبية لصالحهم
5- استنتاج:
إن هيمنة المؤسسة الدينية الإسلامية، وعدم الفصل ما بين الديني والدنيوي، وعدم التطور في اتجاه عقلنة الفكر الإسلامي، والضغط الذي يتعرض له الإسلام على أيدي القوى الخارجية، وما يحصل حالياً في أفغانستان والعراق وفلسطين، جعل المسلم يبتعد عن نقد تجربته التاريخية، ولا يريد أن يكون في الوقت نفسه عاملاً فاعلاً في هدم الإسلام من الداخل. إن أي نقد للإسلام سواء أتى من الخارج أو من الداخل، يسبب ردة فعل إسلامية شعبية شديدة الحساسية. فيعتبر المسلم ذلك هجوماً على دينه، الذي أصبح هويته، نتيجة وعي تراكمي يرتكز على الإسلام وعلى القرآن والسُنّة، وعلى ما يقوم به رجال السياسة والدين في هذا المجال. من هنا، بدأنا نرى استخداماً كثيفاً للقرآن للرد على الحملات على الإسلام. وبرأينا، إن تمسك المسلم بدينه والاعتزاز به، يجعله لا يمارس نقداً لتجاربه التاريخية أو السياسية. ويمكم القول، إن المسلم يرى إن من واجبه التصدي لذلك، حتى ولو خضع النقد الموجه إلى التاريخ الإسلامي لمعايير علمية. فهو، أي المسلم، مكبل بنصوص لا يريد إعادة تفسيرها ولا ممارسة الاجتهاد فيها، في ضوء ثقافته الدينية وتغييب سلطة العقل واستهدافه من قبل الغرب، ما يعيقه في حاضره عن مواجهة العصر والمستقبل.
يزعم المسلمون أن الوجود المسيحي في الشرق هو أكبر دليل على التسامح الإسلامي. وإذا كان هذا حقيقة، فلماذا يتلاشى هذا الوجود المسيحي إذن ويُهمش، ونموذج العراق ومصر ولبنان ماثل أمامنا. لكن عدم التسامح الإسلامي تجاه غير المسلمين لا يقارن بما تعرض له المسلمون في أسبانيا، ولا اليهود في روسيا القيصرية وفي ألمانيا النازية. وبمقارنة بسيطة، نستطيع أن نرى بوضوح مدى التسامح الذي يعيش فيه المسلمون اليوم في أوروبا، من ممارسة شعائرهم الدينية وثقافتهم وإقامة دور العبادة، وارتداء الزي الإسلامي، رغم المضايقات في الفترة الأخيرة، حيث يتمتعون بمساحة حرية لا ينعم به المسيحيون في المشرق العربي والبلدان الإسلامية. وقبل فترة قصيرة، سمحت محكمة في برلين لتلميذ تركي بممارسة الصلاة في غرفة منفردة في مدرسته. وأعلن أحد المسلمين عن اعتزازه بوجود نحو مئتي مسجد في ألمانيا. في المقابل، لا نرى موقفاً مشابهاً للتسامح المسيحي الأوروبي في معظم البلدان العربية والإسلامية. ففي معظم دول الخليج لا يُسمح ببناء الكنائس والمعابد، وفي بعضها لا يمكن للمسيحي أن يمارس شعائره الدينية علناً. وفي مصر، ليس مسموحاً بناء كنائس جديدة، أو حتى ترميم القديم منها، من دون مرسوم جمهوري أو قرار من المحافظ. لقد منع الأمن العام اللبناني بتاريخ 9/4/2005، في كتاب موقع من مديره العام الأسبق اللواء جميل السيد إلى السفارة الألمانية في بيروت، بناء على طلب من مدير الشؤون الدينية في دار الفتوى الشيخ أمين الكردي مؤرخ 11 كانون الثاني 2005، ومن دون تقصي الحقيقة، تداول كتاب “تاريخ القرآن” لمؤلفه تيودور نولدكه بذريعة أنه “يطعن بالقرآن الكريم وبالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وبأمهات المؤمنين – زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثير النعرات الطائفية، ويمس بمشاعر المسلمين”, أما سبب المنع الحقيقي، فهو عدم قدرة مرجعيات دينية تحمل وجود اسم مترجمه المسيحي الدكتور جورج تامر على غلاف الكتاب تحت عنوانه “تاريخ القرآن”.
ووأكرر القول: إذا كانت غاية هذا المؤتمر العثور على مسلمين مثقفين وتقدميين، كما تقولون، ينقدون تاريخهم بعلمية ومعايير الحاضر، فأقول لكم أنكم تبحثون عن قوى غير فاعلة. فكلما اشتد ظلم الغرب تجاه المسلمين، كلما قوى ساعد السلفية المتطرفة التي تكفر المسلمين قبل المسيحيين، وتضعف بالتالي من دور المسلمين التقدميين والعلمانيين. وأعتقد أن أهم هدف يجب أن نتوجه إليه اليوم، هو عدم البكاء على الماضي، بل العمل على تقوية سلطة العقل عند المسلمين لتجديد الفكر الديني، وتوسيع قاعدة الحريات والديمقراطية والتلاقي بين الأديان، التي ستؤسس لعملية نقاش موضوعي للقضايا الأساسية الراهنة للوصول إلى نتائج نبني عليها الحاضر. عندها يمكن نقد الماضي من قبل المسلمين، من دون النحيب عليه.
 دار بيبليون
دار بيبليون