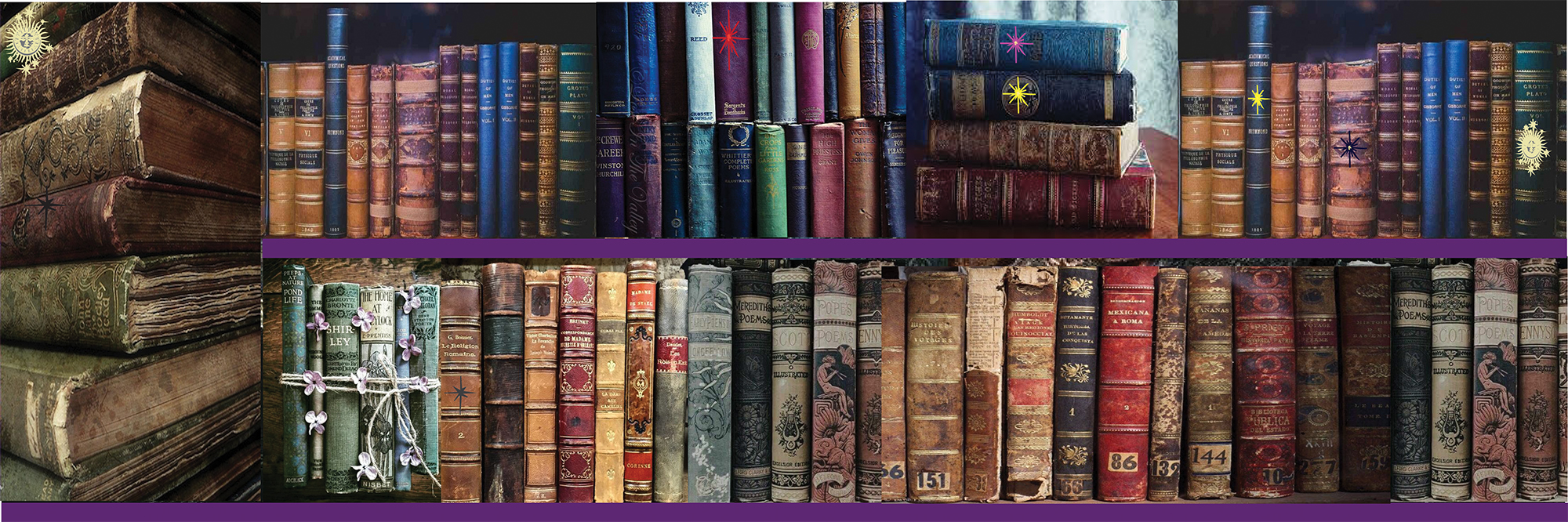عماد يونس فغالي
سأعرض في حديثي الليلة لأمورٍ وصور من حياة الناس، قد تجدونها مألوفة عندكم ومعروفة. وقد تقولون: لا يقدِّم لنا المحاضر شيئًا جديدًا. قد يبدو هذا الأمر في ظاهره صحيحًا، لكنّ الهدف، ليس عرضًا لواقعٍ مُعاش،
إنّما هو تسليط الضوء على قيمة الإنسن وإكرامه من خلال ما اصطُلح عل تسميته: العادات والتقاليد الشعبيّة. وإذا قلنا القيم المسيحيّة في التقاليد والعادات الشعبيّة، فهذه القيم هي إنسانيّة أوّلاً، لأنّ المسيحيّة من شأنها أوَّلاً إعلاء شأن الإنسان، ليطال قامة الله ومجده.
من هنا، أهميّة عادات الناس ومعاملتهم لبعضهم البعض، وتحميل تصرُّفاتهم المعاني النبيلة لأبعادها الإنسانيّة المتجذِّرة في عاديّات الجماعات ولو عن غير إدراك وتفهُّم عند البعض أحيانًا!
وفي مشاهداتكَ االيوميّة، تلاحظ تماشيًا للأفراد والجماعات عبر مسيرةٍ تتوافق مع العادات والتقاليد السائدة في البيئة التي ينتمون إليها، رست مع الأيّام وفي المحيط الجغرافيّ عُرفًا اجتماعيًّا، راح في تعمّقه حدَّ اعتباره قانونًا، بدت مخالفته انتهاكًا لمقدَّسات، أو جرمًا بحقّ المجتمع!
وكم بانَ الرابط وثيقًا بين التقاليد الشعبيّة على بساطتها، والمعتقد الإيمانيّ للجماعة التي تعيش في يوميّاتها، فالعقيدة الإيمانيّة تُطبّق في الممارسة، وفق أدبيّات تنصّ عليها التفسيرات والمعايير الدينيّة الكبرى.
وسنعرض في ما يلي لارتباط التقاليد الشعبيّة المعيوشة بالممارسات الإيمانيّة المسيحيّة.
علمٌ قائم بذاته:
يهمّني في البداية أن أُلفت إلى أنّ العادات والتقاليد الشعبيّة عِلمٌ قائمٌ بذاته له شأنه في عالم الثقافة، لِما لها من فائدة للتاريخ وحضارات الشعوب، فاستحقّت أن تُنشَر فيها المؤلَّفات الشائقة والدراسات الراقية، تَشكّل
معظمها رسائلَ وأطاريحَ للشهادات الجامعيّة العليا.
وقد أطلق الإنكليزيّ “وليم جون طومس” على هذا العلم سنة 1846 اسمًا يُحدّده: فولكلور. وهو لفظة مركّبة من “فولك” بمعنى الشعب، و”لور” الذي يعني علم. هذا اللفظ “فولكلور” اعتُمدَ مصطلَحًا في مختلف اللغات الحيّة، لتحديد مفهوم “العادات والتقاليد الشعبيّة”.
تحديد الكلمات:
العادات: جمع عادة. سُمّيَت كذلك لأنّ صاحبَها يعيدها مرّةً بعد مرّة.
التقاليد: جمع تقليد. قلّد المرأة قلادةً في عنقها، أي أناطها بها وأحكمَ ربطَها حتى تكاد لا تفارقها. وفي تداول التقليد، سواء قولاً أو فعلاً، عَودٌ إليه. وهذا ما يربطه بالعادة.
وللعادات والتقاليد علاقة متينة بالأخلاق، لأنّ تصرّف الناس دليل على أخلاقهم. ما يؤدّي إلى تأثير كبير ومباشر في حياة الأمم والأفراد “لأنّها تقوّي في المرء شعوره بما يربطه بوطنه وقومه وبيئته من علاقات. وتنبّه إحساسه إلى واجبه في التعاون مع مواطنيه… وتدفع المجتمع إلى الانتظام والتناسق في الحركة والاتّجاه والأوضاع…” وفي هذا السياق قول أحمد شوقي:
“وإنّما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا”
تأثير الدين على الحياة العامّة:
يطغى الرابط الدينيّ بشكلٍ ملحوظ على مسلك الأفراد والجماعات الحياتيّ والكلاميّ، في المواقف وردّات الفعل على السواء. وإذ نعرض للحياة المسيحيّة نلحظ:
– عند تفاجؤ امرئٍ بخطْبٍ ما، يهتف: “اسم الصليب”.
– عندما يتعرّض لزلّة قدم: “يا عدرا”.
– عند التحيّة: الله يصبّحَك بالخير، يمسّيك بالخير. الله معك.
– في الأدعية: الله يخلّيك. يطوِّل عمرَك. الله يقوّيك. الله يحفظك.
– في انتظار أمرٍ أو حدثٍ ما: متل ما الله بيريد. الله بيدبّر.
– أثناء عيادة مريض: الله يقدّم الشفا. انشالله عارض بسيط…
– في حال ضيق: الله بيفرجها، على نيّة الله.
هذا في الكلام. أمّا في التصرّفات، فالمسيحيّ ينظِّم مأكله ومشربه وفق التزاماته الدينيّة. فلا يأكل اللحم يوم الجمعة. وفي أيّام الصوم، يغيّر من عاداته اليوميّة كفعل إماتة. ولأجل نجاحٍ في امتحان أو وظيفة، وفي رهانٍ على أمرٍ ما، يقدِّم المسيحيّون النذورات للقدّيسين، ويُطلقون أسماءَهم على أولادهم وفاءً لنذرٍ من أجل ولادة سليمة أو ولادة بعد عقمٍ أو حرمان من صبيٍّ أو فتاة. وفي هذا السياق، القول: “خلقة كاملة نعمة زايدة”.
من ناحية أخرى، عند شراء سيّارة جديدة، يزوِّرونها. أي يتوجّهون فيها إلى مزار قدّيس أو كنيسة على اسمه، ويصلّون له طالبين أن “الله يبعد الضربات”. ويزيّنون السيّارة بصور القدّيس وصلاة تطلب مرافقته لهم في تنقّلاتهم، وتقيهم الحوادث…
زخارف فولكلوريّة:
في المحطّات المسيحيّة الكبرى التي يمارس فيها الناس تقاليدَهم الشعبيّة، أعرض لمناسبتين هما الزواج والمأتم، ولعيدٍ نحتفل به اليوم بالذات: الغطاس.
جديرٌ بالذكر أنّ المناسبات أعلاه، شكّلت كلُّ واحدةٍ منها زخرفًا فولكلوريًّا مستقلاّ في الأدب القصصيّ اللبنانيّ. تناولَ على سبيل المثال لا الحصر، الأديب اللبنانيّ مارون عبّود تقاليد عيد الغطاس من خلال أقصوصته “دايم دايم” الشهيرة في كتابه “وجوه وحكايات”. وتكلّم الدكتور عصام حدّاد على العادات الشعبيّة المسيحيّة عند حصول وفاةٍ ما، في “حلو الموت” من كتاب “مناجم وأهراء”. وأورد الأديب المغمور إميل يوسف عوّاد موضوع الزواج في أقصوصته “العروس” ضمن مؤلَّفه “تراب ضيعتي”.
التقاليد الشعبيّة في الزواج والعرس:
يختلف العرس في مظهره منذ القديم، باختلاف حال المتزوِّجين في الجاه والمقام وذات اليد… فأعراس الأمراء والأشراف كانت ولا تزال واحات بذخ وعظمة، بدءًا بعدد أيّام الاحتفالات التي كانت تطول حتى
أربعين يومًا. فتمتدّ الولائم وتقام الأفراح في داري ذوي العروسين.
وميسورو الحال من أبناء العامّة، وهي الفئة الأكثر عددًا، فيمتدّ العرس عندهم مدّةَ أسبوع أو إثنين، يكون خلالها العروسان الآمِرَين الناهيَين، يحيطهما الجميع بالإكبار ويقومون على خدمتهما.
أمّا في الأوساط الفقيرة، فيعتمد العروسان على أقارب ذوي نفوذ أو مال لإعانتهما. ذلك أنّ العرس في لبنان يخصّ لا العروسين وحسْب، بل الأقارب وأهل البلدة كلِّها!
يوم الإكليل:
الإكليل هو حفلة الزواج، سُمّيَت هكذا لأنّه خلالها يوضع إكليلٌ على رأس كلٍّ من العروسين. فهما يُعتبران ملِكين على بيتهما الزوجيّ وعلى عائلتهما. ويؤثر المسيحيّون الاحتفال بزواجهم يوم الأحد لأجل رمزيّته. هو يوم القيامة والحياة. يوم بركة ونعمة. ومن ناحية أخرى هو يوم عطلة، فلا يشقّ على المدعوّين المشاركة في الأفراح.
لصق الخميرة:
بعد الإكليل، يتوجّه العروسان إلى منزلهما الزوجيّ أو إلى منزل العريس الوالديّ، حيث تُرفع العروس على كرسيّ أو محمولةً أمام باب البيت، وتلصق خميرةً فوقه. تقليدٌ رمزيّته أنّ العروس ستمتزج بأسرتها الجديدة امتزاج الخمير بالعجين، وتعبيرًا عن الوحدة في الحبّ، والخصب الزوجيّ ووفرة البنين.
الموت والمأتم:
قولٌ عربيٌّ مأثور، يُهيمن على طقوسيّة الموت في المفهوم المسيحيّ: “إكرامُ الميت دفنُه”. وفي هذا الإطار، تعابير: حلو الموت بالضيعة. الموت ماعاد إلو قيمة… من هنا نجد كلّ التحضيرات التي تسبق موتَ المسيحيّ والتي ترافق انتقاله وتليه، تصبّ في خانة إقامة دفنةٍ لائقة بالمنتقل، العزيز على قلوب أقربائه والأحبّة.
لذلك، عند دنوّ ساعة الأجل، يُستدعى الكاهن ليمنحه الأسرار الأخيرة، مهيّئًا المحتضر “لملاقاة وجه الله”. وهذا ما يُطلق عليه في النعوة “متمِّمًا واجباته الدينيّة”. فيزوّده الكاهن بسرّ التوبة والمناولة ومسحة المرضى. ويصلّي عليه صلوات ساعة الموت…
من الناحية العالميّة، يُصار عادةً إلى تهيئة الملابس التي ستُخلع على الراحل والتي سيُدفن فيها. وهي ثيابٌ رسميّة تظهره في أبهى حلّة يمكن أن يكون فيها. فإذا كان كاهنًا أُلبس ثيابه الكهنوتيّة الرسميّة وبدلة القدّاس فوقها. وإذا كان راهبًا كاهنًا، يُلبَس ثيابه الرهبانيّة وفوقها البطرشيل. أمّا الرجال، فبدلة رسميّة مع ربطة العنق. والنساء ثوبًا أبيض خاصًّا كونَها عروسًا. وبين يدَي كلّ متوفّى مسبحة من خمسة بيوت.
إعلان الوفاة:
يُعلَم الأقارب الألزمون أوّلاً بإرسال أحد الحاضرين الوفاة إليهم أو بالاتّصال بهم هاتفيًّا، وذلك قبل الإعلان الرسميّ للوفاة. ومن ثمّ يُقرع جرس الكنيسة دقّةً دقّة، ما يُسمّى “جرس حزن”. والذين لا يسمعون الجرس تُرسل إليهم “أوراق النعوة”. ولهذا الإرسال طقوسيّة لن أتطرّق إليها لضيق المجال. أمّا اليوم فلا تُرسل ورقة النعوة إلاّ عموميّةً إلى بعض النواحي باسم الكاهن والرعيّة. واستُبدلت في النعي الخاصّ بالرسائل القصيرة SMS.
والتجاوب مع الدعوة إلى الدفن وتقديم التعازي هو واجبٌ ضروريّ، لا يتقاعس فيه الناس أبدًا. خصوصًا وأنّ الموت يطال الجميع و”الدني مبادلة”. لذلك يهبّ الجميع ويتنادون إلى “بيت الميت” أو صالة الكنيسة اليوم، لتهيئة ما يجب للمأتم والمشاركة فيه. فيترك االجميع أعمالهم ويلغون ارتباطاتهم الأقلّ أهميّة ليكونوا إلى جانب أهل الميت.
عرض الميت والتعزية به:
يعتبر اللبنانيّون بعامّة أنّ عرض جثمان فقيدهم والالتفاف حوله، خصوصًا من قبل النسوة، إكرامٌ له وتعبير عن محبّتهم وتعلّقهم به. لذلك، وبعد غسله وإلباسه، يُقام على سريرٍ أو منصّة بكلّ إكرام، ووجهه نحو الشرق، حيث يُشرق النور رمزًا للمسيح نور العالم. ويتقبّل أهلوه التعازي في الصالون حوله أو في صالةٍ ثانية يؤمّها الرجال.
تعابير للتعازي:
يتقدّم المعزّون من أهل الميت بعبارات خاصّة يدعونها في العاميّة : الأخذ بالخاطر، فيقولون: الله يرحمو. العوَض بسلامتكن. نفسو بالسما. خاطرنا عندكن…
ويجيبونهم: الله يخلّيك. يخلّيلك عيلتك. أو أهلك إذا كان عازبًا. الله يآجركن…
رتبة وضع البخور:
هي صلاة رجاءٍ بالقيامة وإيمان بعقيدة الكنيسة النهيويّة، يرافقها إحراق البخور وتبخير الجثمان والمشاركين. وتُقام فور عرض الجثمان أو انتقاله من مكان الوفاة إلى البيت أو الصالة وقبل إخراجه مباشرةً إلى الكنيسة لصلاة المرافقة والمواراة. وكانت عادةٌ قديمة بإقامة وضع البخور بعد الدفن مباشرة حيثُ كان الجثمان معروضًا في البيت، وقبل ذلك على فترة ثلاثة أيّام، رمزًا لقيامته مع المسيح…
القائمة أو التعاطف:
لأنّ تكاليف الدفن لا يُستهان بها، ولا يمكن التفلُّت منها احترامًا للمتوفّى وأهل بيته، وإكرامًا للمشاركين في العزاء، درجت عادة “القائمة” أو “التعاطف” في القرى. وهي مشاركة العائلات أو الأفراد بمبلغ معيّن يُجمع ويُقدّم لكبير عائلة الميت أو من منهم يهتمّ بالمحفل، كمساهمة في المصاريف.
الإيمان الشعبيّ:
هو الممارسات الإيمانيّة الموروثة والمتناقلة من جيلٍ إلى جيل. عادات معيوشة في الجماعة، يخضع لها الأفراد من دون تفكير أو مناقشة.
وهي في الإجمال غير مبرّرة لاهوتيًّا وعقائديًّا. بتعبير آخر، إذا رحنا في التفسيرات اللاهوتيّة، لا نجد للتصرّفات الإيمانيّة الشعبيّة بمجملها مراجع كتابيّة أو كنسيّة.
هي تصرّفات تنبع من قناعات متجذِّرة في الذهنيّات يميّزها التحجّر العقليّ وعدمالتزحزح في التفاصيل. فلا تقبل بمناقشة أو انزياح. أريدت كذلك في الأساس، لضبط الناس في التمرّس في الواجبات الدينيّة.
– عدم الزيارة بعد المشاركة في المأتم.
– خياطة العروسين في الإكليل. حمل العريس وإنزاله في الكنيسة.
– النذورات.
– السلام السيّديّ…
عيد الغطاس:
هو أحد الأعياد المسيحيّة الكبرى. عيد اعتماد السيّد المسيح على يد يوحنّا المعمدان في نهر الأردنّ بتاريخ 6 كانون الثاني. وكان المسيحيّون يعيّدون فيه عيد الميلاد أيضًا، قبل انتقاله إلى 25 ك1. وفي هذا العيد، تكثر التقاليد الشعبيّة، نذكر واحدًا منها في هذه العجالة: “الدايم دايم”.
يعتقد المسيحيّون أنّ يسوع المسيح يمرّ على المنازل عند منتصف ليل العيد وهو يقول: “دايم دايم”. فمن كان ساهرًا ينتظر، فاتحًا أبوابَ بيته وأنواره مضاءة، نال البركة هو وأفراد عائلته. أمّا الذين أغلقوا أبوبهم وأطفأوا الأنوار، يُعتقد أنَّ اللعنة تحلُّ بهم.
وكان المسنّون في القرى المسيحيّة يقولون إنّ كلّ ما يطلبه المرء من الله تلك الليلة يناله، “لأنّ أبواب السماء تبقى طوال الليل مفتوحة، والملائكة تهبط منها إلى الأرض لاستماع طلبات المؤمنين والعمل على تحقيقها…” وسيّدات البيوت تأتين المؤن في البيت فتحرّكنَها بأيديهنّ قائلةً: “دايم دايم”، معتقِدات أنّ البركة تحلّ فيها فتزداد وتفيض.
هذه معتقدات وإن دلّت على سذاجة الإيمان الشعبيّ وبساطته، إلاّ أنّها تستمطر نِعمَ الله وبركاته على المتمسِّكين بدينهم، لأنّهم، وكما في اعتقاد العامّة، “حسب نواياكم تُرزَقون”.
الخاتمة:
ختامًا نقول: التقليد هو أحد ركائز الإيمان. تعتمد عليه الأديان في صحّة معتقداتها وأسس إيمانها السليم. ألم يحدِّد التقليد في الكنيسة، الكتب المقدَسة القانونيّة، ورفَضَ المنحولةَ منها؟
وفي الحياة العامّة، ركّزت التقاليد الشعبيّة أسس التعاطي الاجتماعيّ بين الناس، وحدّدت الروابط العائليّة والعلائقيّة في محطّات مسيرة الشعوب الأساسيّة بعامّة. فصارت العادات أعرافًا يُستند إليها في التصرّفات المتبادَلة، والواجبات الاجتماعيّة التي تتناقلها المجموعات البشريّة المتقاربة في الزمان والمكان.
وفي هذه جميعِها، يريد الناس من أصول تعاطيهم مع بعضهم البعض، الحفاظ على القيم الإنسانيّة لكلّ جماعة منهم والأفراد فيها، واحترام المبادئ الاجتماعيّة في الأصول واللياقات التي نشأوا عليها. فتُحفظ الكرامات الشخصيّة والجَماعيّة، وتتناقل بالتربية والسلوك العامّ من جيلٍ إلى جيل، فتُحدَّد بذلك الهويّة الخاصّة بكلٍّ من الشعوب، ونخصّ منها الشرقيّة هنا، في انتماءاتها البشريّة وصلتها بعالم الله! وشكرًا.
في 6 كانون الثاني 2014
 دار بيبليون
دار بيبليون