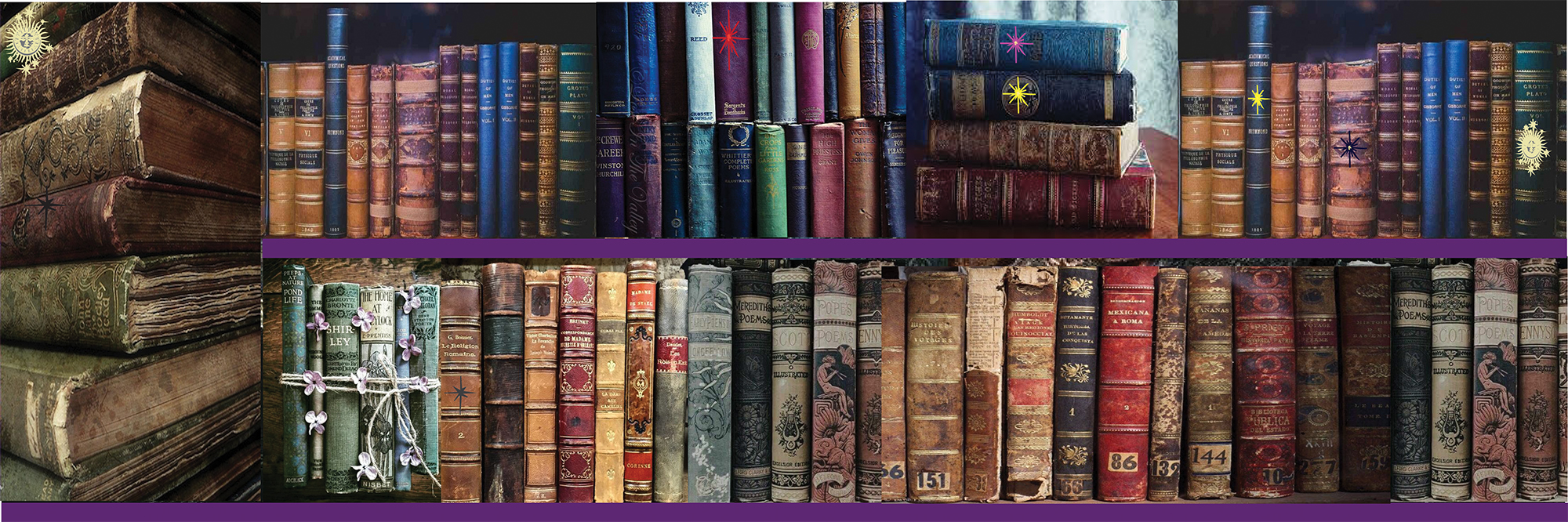محاضرة لويس صليبا في ندوة كتابه “فؤاد شهاب ما له وما عليه”، الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، الفيدار/جبيل، الخميس 20 شباط 2025
هل من شيءٍ جديد بقيَ لي أن أقولَه في فؤاد شهاب الأمير اللواء والرئيس بعد كتابي هذا عنه الذي استغرقَ تأليفه سنوات، وقد سعيتُ جاهداً أن أضغط حجمَه وعددَ صفحاته، فما استطعتُ أن أُنقصها عن 525 صفحة!!
لعلّه يبقى من المفيد أن أذكُرَ، ولأوّل مرّة، بعضَ ما دفعني إلى خوض هذا الموضوع الشيّقِ والشائكِ في آن.
ولدتُ ونشأتُ في بيتٍ جبيليّ يتنازعُه انتماءان: عمّي الخوري فرنسيس صليبا كان معرِّفاً للرئيس الشيخ بشارة الخوري، وعن الكتلة الدستورية ورِثَ الولاءَ للرئيس فؤاد شهاب، وكان من المفاتيح الانتخابية الأساسية للائحة النهج في قضاء جبيل.
وكان والدي طانيوس يتبنّى بالكامل توجّهات عمّي السياسيّة والانتخابية. وبالمقابل فوالدتي هند الزيلع، وبتأثيرٍ من جاراتها في حيّ الشامي الذي سكنّاه في جبيل كانت من مُحبّي خصم الشهابية الأوّل العميد ريمون إدّه ومؤيّديه.
عام 1972 تصالح عمّي الخوري فرنسيس مع العميد إدّه، وزاره هذا الأخير في منزله خلال حملته الانتخابية يومها، وكانت المرّة الأولى التي أرى فيها زعيم الكتلة الوطنية وجهاً لوجه. كنتُ لمّا أزل صغيراً، بيد أنّه لقاءٌ ترك في النفس أثراً لمّا يزل باقياً، لا سيما وأن العميد لم يتعبْ من رواية النِكَت وإمتاع الساهرين بنوادره وتعليقاتِه السياسية في تلك الليلة، وقد أسرَتْني شخصيّتُه الكاريسماتيّة تلك. أمّا عمّي الخوري فرنسيس صليبا فبقيَ حتى أواخر أيّامه (أيار 1996) يذكرُ الأميرَ اللواء بالخير، ويترحّمُ على أيّامه وحكمه، ويعتبرُه مثالَ الرئيس النزيه والعادل.
عام 1979، كنّا مجموعةً من التلامذة في صفّ الرياضيّات أو الثالث ثانوي في ثانويّة راهبات الورديّة في جبيل، نتابعُ كلّ جديد، في مواقف العميد، ونتداولُ اسمَه، ونرمزُ إليه بالرقم 125 (بالأحرف الهندية) فعمدَتْ ميليشيا الأمر الواقع إلى خطفِ عددٍ منّا من ملعب المدرسة في 15/11/1979، في حادثةٍ ضجّت لها منطقةُ جبيل، ورويتُ تفاصيلها في كتابي ذكريات ومشاهد وشخصيّات من لبنان.([1])
وعندما انتقلتُ في التسعينات إلى باريس للدراسةِ والعمل، أُتيحت لي فرصةٌ ذهبيّة للقاء العميد ريمون إدّه في منفاه الاختياري والتحاور معه. وفي زيارةٍ أولى له في 9 كانون الثاني 1993، في أوتيل كوين إليزابت، سألني العميد عن حادثة الخطف تلك، وأبدى تضامنَه التامّ مع من تعرّض ظلماً يومها للخطف. وطالت جلستي عنده، وفي سياق حواري الطويل معه قال لي: “فؤاد شهاب هو أهمّ رئيس جمهورية حكم لبنان”. فسألتُه مستغرباً بما في ذلك والدك؟ فأومأ برأسه، وكأنّه محرَجٌ من أن يُقرَّ بذلك بكلام واضحٍ صريح، أن نعم!!
تصريحُ العميد إدّه ذاك وإقرارُه، وهو ما كرّره بعد ذلك علناً، كان صدمةً لي، وبدايةَ بحثٍ جديد وتفتيش طويل عن أثر وتأثير ذاك الأمير اللواء الذي حكمَ لبنان وكان خيرَ الحاكمين، ما أفضى في النهاية إلى تأليف هذا الكتاب.
ولكن، ما لي أتحدّثُ عن العميد، خصم الشهابية العنيد، في نُدوةٍ عن فؤاد شهاب وكتابي عنه؟ أليس هذا مفارقةً فعليةً ولافتة؟! قد يصدُقُ في العميد قول المثل الفرنسي Qui aime bien chatie bien، من يحبُّ كثيراً يؤنّب كثيراً.
وقد يرى بعضُ القرّاء أنّني، في كتابي هذا، كثيراً ما أحاولُ أن أتصيّدَ نقائص الأميرِ وعيوبَه، أو كما يقول مثلٌ فرنسي آخر Il lui cherche la petite bête أي أنّني أتنمّرُ عليه. ويسألُ بالتالي إذا ما كان ذلك بتأثيرِ نشأةٍ كتلوية ما!
وفي حقيقةِ الأمر، فذلك لا يرجعُ إلى أيّة رغبةٍ في إظهار العيوب وتظهيرها، بل هو مجرّدُ محاولةٍ دؤوبة للإجابة عن تساؤل شغلني ردحاً طويلاً من الزمن، وخلاصته: لماذا عجِزت الشهابية عن كبحِ جماحِ جنوحِ لبنان إلى حربٍ ضروس وبُرَكِ دمٍ توقّعَتْها في رؤيا تنبّوئية جديرة بكلّ تنويه. وهل يُلام فؤاد شهاب بالتالي على زُهده المغالي في العودةِ إلى الحكم؟!
ولعلَّ ذاك العجز/ يعودُ إلى ما أسميتُه “صراع الديوك” بين الزعماء الموارنة في تاريخ لبنان المعاصر. بدءاً من نزاعِ إميل إدّه وبشارة الخوري، امتداداً إلى كميل شمعون وفؤاد شهاب، ثم ريمون إدّه وبيار الجميّل، وصولاً إلى بشير الجميّل وصراعه المرير مع طوني فرنجية تارةً ومع داني شمعون طوراً. ومن ثمَّ الحرب الضروس بين عون وجعجع 1990 والتي لمّا نزل نعيشُ تداعياتِها إلى اليوم. وإذا كانت دراستي المطوّلة قد وجّهت سهامَ النقد واللوم مراراً إلى الرئيس/الخلف شارل حلو، فهي توافقُه القولَ أن هذه الحرب نسفت البنية التحتية المسيحية في لبنان وفي الشرق الأوسط. (ص187).
وصراعُ فؤاد شهاب مع كميل شمعون، بما في ذلك حادثة اغتيال النائب نعيم المغبغب التي سعت هذه الدراسة أن تسلّط أضواءً جديدة عليها وعلى المتّهمين بارتكابها ودوافعِهم، فهذا الصراع كان حلقةً من هذه السلسلة الطويلة والمُضنية بل المُهلكة للوطن الصغير من المواجهات والنزاعات. وإذا كان كتابي هذا قد وضع الإصبع على هذا الجرح، فهو يبقى بمجمله ومختلف لاعبيه، موضوعاً إشكالياً يستحقّ أن يُدرس ويفنَّد في أطروحة كاملة، بل دراساتٍ وأطروحات.
وأيّاً يكن، يبقى فؤاد شهاب مثلاً مضادّاً Contre Exemple ولعلّه الوحيد أو الأبرز بالتأكيد، بوجه الزاعمين أن لبنانَ الكبير بتركيبته وحدوده الراهنة كيانٌ غير قابلٍ للحياة والاستمرار.
والخلاصة، فقد آليتُ جهدي، وعبر سنواتٍ من البحث والتنقيب، أن يحمل كتابي هذا الكثير من الجديد والمفيد ليومنا وللغد، وليس لي أن أحكمَ في مدى نجاحيَ في ذلك. لا سيما وأن صوتَ الباحث المدقّق والمتأنّي والمحايد الرزين في هذا البلد غالباً ما يبقى صرخةً في وادْ وسط ساحةٍ صاخبة تضجُّ باللاعبين والزاعمين والثرثارين.
ولا بدّ من كلمةٍ موجزة لي تتناول الليشيّات أو اللماذات الخمس التي كان يطرحها الرئيس شهاب ويتساءل ويحار بشأنها وهي التالية، وقد نسبتها مصادر تاريخية عديدة إليه، وذكرت أنّها بقيت بدون أجوبة:
1-لماذا يكون اللبناني مستخدماً صالحاً في مؤسّسة خاصّة، فإذا صار موظّفاً في الدولة فسد؟
2-لماذا يعتبر اللبناني مخالفة القانون انتصاراً، والتقيّد بالنظام مذلّة؟
3-لماذا يتفوّق الفرد في لبنان وتتخلّف الجماعة؟
4-لماذا لا يميّز اللبنانيّون بين الحربقة والسياسة؟
5-لماذا ترك اللبنانيّون الدين واعتنقوا الطائفية؟([2])
وهي بمجملها تدور حول معادلة شهيرة للرئيس شهاب وتقول: “لبنان يتألّف من سكّان لا من مواطنين”. ولا نزال مع الأسف الشديد دون مستوى المواطنية، ما حدا بالرئيس شهاب إلى أن يخصّ مادّة التربية المدنية بعناية خاصّة ومميّزة، على أمل أن تعمل على تربية مواطن يليق بالوطن الصغير ويعمل في سبيله، لا في سبيل مصلحته الشخصية، وفرديّته، كما كان دأبه دوماً تربية نشأةً وممارسة. أمّا بشأن إيثار اللبناني عموماً الطائفية والانتماء إلى الطائفة كجماعة سوسيولوجية على الانتماء الديني والإيماني الرحب، فنكتفي بشأنه، بالنادرة التالية: “كتب يوماً الكاتب اللبناني اسكندر شاهين في مجلّة اللطائف المصرية أشاد فيه بمزايا اللبنانيين، وقال أخيراً: يكفي اللبنانيين فخراً أنّهم اخترعوا اللبنة بالزيت، ومسبّة الدين”.([3])
والمتعصّب تلهيه القشور عن الجوهر، والطائفية عن الدين، حتى كانت مسبّة الدين، ولا سيّما دين الآخر، من ميّزات اللبناني. أفلا تكفي هذه الميزة عِبرة لنا، ترجعنا إلى الليشية الخامسة للرئيس شهاب الآنفة الذكر ومدى خطورتها؟
وفي الحقيقة وواقع الأمور، فمؤشّرات “قلّة الدين” عند اللبناني، وتفشّي الطائفية وتفاقمها بالمقابل عديدة. فقد “ابتكر” اللبناني أنماطاً عديدة من “مسبّات الدين”، والأمر لا يقتصر، على ما يبدو، على مسبّة واحدة فقط لا غير. فبالإضافة إلى حرق الدين، وهي المسبّة الأشهر، فإذا قصد اللبناني أن يشتم أحداً، ويؤكّد أنّه محتال وشلمصتي ودجّال فهو يصمه بنعت “أخو ديانة”. فيغدو أخا الديانة عنده الأزعر والمحتا بامتياز. أمّا مسبّة الدين، فهي ليست متداولة وحسب، بل هي محمودة أحياناً، وإذا جاءت في محلّها. وفي ذلك يقول المثل اللبناني: “كلّ شي بوقتو مليح، مسبّة الدين بوقتا تسابيح”([4])
ومن مؤشّرات “قلّة الدين” عند اللبناني قول المثل: “صوم وصلّي بتركبك القلّة” (صليبا، لويس، وجه أمّي، م. س، ص220).
وبالمقابل نجد هذا اللبناني عموماً يحمد الطائفة. وهي في الأساس عنده انتماء اجتماعي، لا بل طبقة أو فئة اجتماعية وليس انتماءً دينيّاً ولا حتى عقائدياً. فخلال نحو أربعة قرون من الحكم العثماني (1516-1918) لم يرد مصطلح الطائفة إلا بهذا المعنى: “أي جماعة وفرقة ورهط مثل طائفة المرابين”.([5])
فكان يقال: “طائفة الحدّادين، وطائفة النجّارين، وطائفة الصيّادين”، إلى ما هنالك من حرِف ومهن. أي أن الطائفة بالمعنى والاستخدام اللبناني كانت أقرب إلى مفهوم الطبقة والفئة الاجتماعية Caste، كما هو سائد في الهند حتى اليوم مثلاً.
والاستخدام القرآني لا يبعد عن هذا المعنى. ففي سورة آل عمران 3/122: {إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا}. ونقرأ في تفسير هذه الآية: “طائفتان منكم: بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وكانا جناحي العسكر”.([6]) أي هما جماعتان وفئتان. وفي آي الذكر كذلك: {فلولا نَفَرَ من كلّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين} (التوبة 9/122). وجاء في تفسير هذه الآية: “فهلا نَفَرَ من كلّ جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة ليتكلّفوا الفقاهة في الدين ويتجشّموا مشاقّ تحصيلها”. (تفسير البيضاوي، م. س، ص442).
وفي لسان العرب: “الطائفة: الجماعة من الناس”.([7])
ولعلّ من مبتكرات اللبنانيين هذا المفهوم الخاصّ للطائفة الذي تطوّر من فئة وجماعةٍ اجتماعيّة وحِرفيّة إلى جماعة عقائدية ودينية بقيت تحتفظ بمفهوم الجماعة/الطبقة والعصبية العشائرية والقبلية.
وتبقى ليشيّات شهاب الخمس علامات استفهامٍ كبرى بوجهنا، وعلينا لا أن نجتهد للإجابة عنها وحسب، بل أن نعكس مسارها كي نكون مواطنين ونستحقّ وطناً ورقعة من الأرض تحت الشمس.
وبشأن ما جاء في هذه الندوة على لسان السادة المحاضرين من ملاحظات، فإنّني أعتبرها عموماً بمثابة هدايا لي تحثّني على المزيد من التدقيق والتنقيب، لا سيما وأن الكلمة الفصل في تجربة رائدة وملهمة كتلك التي قادها الرئيس شهاب لم تُقَلْ بعد، وقد يمضي زمنٌ طويلٌ قبل أن تقال.
وبالنسبة أوّلاً إلى تساؤل الوزير جان لوي قرداحي: لماذا فؤاد شهاب لا يزال يثير الانتباه بعد مرور ستّين عاماً على نهاية عهده؟!
فإنّني أرى، جواباً على ذلك أن اللبنانيين لا يزالون يعيشون في حالة حنين إلى فؤاد شهاب وعهده، لا سيما وأنّه هو من نقلهم من حربٍ أهلية وطائفية 1958 إلى سلمٍ أهلي، ومرحلة بناء دولة الاستقلال. وهو الوحيد بين رؤساء لبنان، ولا سيما في مرحلة ما بعد الاستقلال الذي استلم دولة مفكّكة مشلّعة، وفي حالة حربٍ داخليّة، وسلّم خلَفه دولة استعادت تماسكها وسلمها الأهلي، فلهذا السبب أولاً ولغيره لا يزال فؤاد شهاب برأيي يثير الانتباه والاهتمام. ولا يزال اللبنانيّون عموماً، والقوى الخارجية كذلك يتطلّعون إلى كلّ قائدٍ للجيش بأملٍ ورجاء أن يفعل ما فعله فؤاد شهاب!!
وإنّني لأوافق الوزير جان لوي قرداحي الرأي في ما ذهب إليه بشأن الحلف الثلاثي، وهو ما ذكرتُه بالحري في كتابي، ناقلاً عن الوزير غسّان التويني أن هذا الحلف كان طليعة دولة النصارى (ص145). وفي دراسة أخرى لي، بيّنت بالوثائق والأدلّة أن ثمّة حدثين محوريّين في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر ساهما مساهمة حاسمة في تأجيج الانقسام وبالتالي الصراع الطائفي.
1-الأوّل كان حرب البشيرَين الأمير بشير شهاب الكبير والشيخ بشير جنبلاط 1825([8])([9]) إذ كان اللبنانيّون في عهد الإمارة المعنية وردحاً من عصر الإمارة الشهابية ينقسمون في السياسة وصراعاتها بين قيسيّين ويمنيّين. وكانت كلّ فئة من الاثنتين تضمّ في ومكوّناتها مجموعاتٍ وأحزاباً من كلّ الأطياف والطوائف اللبنانية، فجاءت حرب البشيرَين لتقسم الجبل عموديّاً إلى مسيحيين ودروز، ممّا أدّى بالنتيجة إلى سلسلة حروب طائفية 1840 و 1845 بلغت أوجها في مذبحة 1860.
2-والظاهرة عينها تكرّرت منذ إعلان لبنان الكبير أيلول 1920. إذ كان محور الصراع على السلطة يدور بين تجمّعين سياسيين: الكتلة الوطنية بزعامة إميل إدّه، والكتلة الدستورية برئاسة بشارة الخوري. وكلٌّ من التجمّعين يضمُّ زعماء ومكوّنات وفئات من مختلف الطوائف اللبنانية. فكنّا نجد في الكتلة الدستورية مثلاً الرئيس رياض الصلح ومشايعوه السنّة والرئيس صبري حماده ومؤيّدوه السنّة إلى جانب بشارة الخوري. ونلقى ما يوازي ذلك في الكتلة الوطنية. واستمرّت الحال على هذا المنوال في العهد الشهابي والذي ورثت فيه كتلة النهج الكتلة الدستورية وتابعت مسيرتها. وبقي التنافس والصراع على هذا الطابع حتى تأليف الحلف الثلاثي 1968، فكان أوّل تجمّع لأحزاب وقوى لبنانية من لونٍ واحد وطائفة واحدة. ممّا سرّع الخُطى نحو الحرب الأهلية الطائفية 1975. والمصيبة أن الحلف الثلاثي كان سابقة لتحالفات مماثلة أشدّ وقعاً وتداعيات طائفية كالتحالف الرباعي في انتخابات 2005، والثنائي المذهبي الراهن.
وأوافق الوزير قرداحي كذلك على أنّ محاولة لصق مسؤولية اتّفاق القاهرة بفؤاد شهاب، كما جاء في بعض الدراسات، تعسّفٌ ومجرّد تحامل. والوثائق والشهادات التي بين أيدينا وقد ذكرت غالبيّتها وحلّلتها في كتابي: ب2/ف3: “اتّفاق القاهرة وسياسة اللاموقف” (ص72-76)
كما أنّني أوافق الوزير الصديق قرداحي الرأي بشأن دقّة وأمانة نُقول وروايات الأب يعقوب السقّيم في كتابه “بين راهبٍ وأمير”، وهذا ما حدا بي إلى أن أجعله مصدراً رئيسيّاً لكتابي.
ولا أخالفه في قوله إن حكم فؤاد شهاب هو المحاولة الوحيدة المبرمجة للإصلاح السياسي في لبنان. ومن بعده فسائر المحاولات أجهضت في المهد.
أمّا قول الوزير قرداحي: “كلّ طرفٍ كتب عن الرئيس شهاب لم يكن موضوعيّاً منّي وجرّ”، فيجب أقلّه برأي أن يميّز في الكتبة هؤلاء بين أقلّه فئات ثلاث: السياسيّون والصحافيّون والمؤرّخون. فالسياسيّون لا يُنتظر منهم موضوعية ولا حياد في ما يقولون ويزعمون ويكتبون، لأن المصلحة الشخصية هي ما يحكم دوماً أقوالهم. والصحافيّون، وإن كان هامش الحرّية عندهم أوسع، فأكثرهم يبقى أسير ما أعلن من مواقف مسبقة وأحكام. ويبقى المؤرّخون، وهم لا يكتبون إلا وهم على مسافة أقلّها زمنية من الحدث، وعليهم أن يقرنوا المسافة الزمنية هذه بأخرى مكانية تتيح لهم أن يكونوا كالناظر إلى الجبل من السهل لا من قمّته. وقد اجتهدتُ في كتابي هذا أن أحافظ على مسافة كهذه، وعساي أكون قد وفّقت إلى ذلك.
وأمّا ما قاله عن اختيار شارل حلو للرئاسة، وأنّه جاء بضغطٍ من الفاتيكان وفرنسا ودول غربية أخرى، ولم يكن لفؤاد شهاب دور أساسي أو يدٌ فيه، فهي فرضيّة تفتقر إلى وثائق أو حتى شهاداتٍ تؤيّدها. والملحوظة عينها تنسحب كذلك على زعمه أن المكتب الثاني ورئيسه خرجوا في عهد الرئيس حلو عن سلطة شهاب، فهي الأخرى فرضيّة يتيمة، وما بين أيدينا حتى الآن من شهادات ووثائق يذهب بالحري باتّجاه نقضها. وإذا كان لدى الوزير الصديق شهادة تؤيّد قوله، وهو ما سمعته منه شفاهة، فأتمنّى عليه أن يوضحها في مقالة أو مقابلة، وهذا ما سبق أن اقترحته عليه.
ويبقى ما ساقه الوزير قرداحي بشأن طريق القمم التي طالت عدداً من قرى جرود كسروان، وقوله إن هذه الرواية مجرّد مزاعم من عنديّات العميد ميشال ناصيف. فدعوى الوزير قرداحي هذه تنفيها شهادات أخرى أكّدت رواية ميشال ناصيف كمثل شهادة المعاون حنا بو ملهم (ص41)، والتي نقلها نقولا ناصيف بنصّها كما يلي: “يقول أحد العسكريين من مرافقي الرئيس فؤاد شهاب هو المعاون حنا بو ملهم إنّه سأله يوماً من عام 1968 بينما كان في نزهة وزوجته على طريق بكفيّا التي تربط قضاء كسروان بقضاء المتن، عن سبب إهدار مال لشقّ طريق بين قرى نائية قد لا تكون مفيدة للسكّان. ردّ: “عندما نصل إلى هذا المكان إجمع العسكريين المرافقين، وأعد طرحَ السؤال عليّ”. ولمّا وصل الموكب، كرّر طرح السؤال، فقال الرئيس السابق: شُقّت هذه الطرق وسواها من ضمن شبكة واسعة شملت المناطق اللبنانية كلّها، وهي لا تربط قرى بعضها ببعض فحسب، وإنّما تؤمّن اتّصال الناس بعضهم ببعض كذلك. لكن هذه الطريق بالذات هي للحؤول دون أن تكون كسروان مِقبرة للمسيحيين إذا بقيت معزولة عن سائر المناطق”.([10])
ولا يُضير الرئيس شهاب في شيء أن يكون قد استشرف بحسّه الاستراتيجي المرهف أيّ عزل محتمل للبنان الصغير، أو لبنان المتصرّفية ومنطقته كسروان تحديداً، كما حصل فعلاً في الحرب الكونية 1914-1918، وكما سيحصل كذلك في الحرب الأهلية 1975-1990، فشاء أن يستبقه ويكسره بطريق القمم، وبمرفأ جونيه الذي أتى إنشاؤه من ضمن المنظور عينه.
وأنتقل إلى محاضرة معالي الوزير الدكتور شربل نحّاس. وأشكره على اعتباره أنّني في كتابي وقفتُ من فؤاد شهاب موقف المحاسب، فأحصيتُ ما له وما عليه. ولعلّني اتّخذت موقف المحاسب المحايد Audit الذي ينظر إلى الأرقام وما هو محسوس وملموس Concret أو من ينظر إلى الأعمال لا الأقول طبقاً لتعبير الرئيس شهاب نفسه. وهو ما عبّرت عنه باختصار مستشهداً المثل العربي القائل: حسبُ المرء أن تعدّ عيوبه، أي أن تكون معدودة، ومن هو ذاك الذي يخلو من أيّ عيب؟! وهذا ما يقودني حكماً إلى معادلة أخرى للوزير نحّاس، والقائلة بوجوب الالتزام بالامتناع عن التقديس والشيطنة. وهو ما يجب أن يكون دأب المؤرّخ وديدنه: أن يشرح ويوصّف ويوضح، ويمتنع قدر الإمكان عن إطلاق الأحكام، لا سيما ما يتّخذ صفة المبرم منها.
أمّا عن تساؤل الوزير نحّاس عن ظاهرة أن يصل في أيّامنا أربعة قادة للجيش إلى سدّة رئاسة الجمهورية، وأسباب ذلك. فهي برأيي مؤشّر على إفلاس الطبقة السياسية في لبنان، وانعدام الثقة بها داخليّاً وخارجيّاً. وهي كذلك تعبير ما عن أملٍ ظاهر ومخفيّ يحدو أهل الداخل والخارج بأن يكون قائد الجيش الذي يلي الحكم “فؤاد شهاب” آخر.
وعن إشارة الوزير نحّاس إلى ما وسم عقلية الرئيس شهاب ونهج حكمه من طابع فرنسي أو ثقافة فرنسية، وهو الذي كان خرّيج المعاهد الفرنسية، فإنّني أوافقه في ذلك، وأعتبره نقطة قوّة فيه، لا ضعف. وهو الذي كان يستوحي تجربة الجنرال ديغول الذي عرفه عن كثب، ويستلهمها. وذكرتُ في كتابي أن ميشال أبو جودة وغيره سمّوه “ديغول لبنان”. ولا تزال هذه التسمية متداولة حتى اليوم. فعندما كتبتُ إلى المفكّر المغربي المعروف منذ أيّام (في 9/2/2025) عن هذه الندوة، أجابني بالعبارة الموجزة التالية: “فؤاد شهاب هو ديغول لبنان”.
أما بشأن تساؤل الوزير نحّاس عمّا نستتفيد من تجربة فؤاد شهاب اليوم، وقوله إن لبنان الذي نشأ بعد الحرب الأهلية ليس له علاقة بتاتاً بلبنان فؤاد شهاب ولا حتى بأيّ شيء. فإنّني أرى أن هذه المقولة النحّاسية الأخيرة مجرّد شطحة مبالغة وقوانين تطوّر المجتمعات تتّجه بالحري إلى نفيها. ففي كلّ مجتمع أيّاً يكن ثوابت ومتغيّرات أو الثابت والمتحوّل. فلو أخذنا الليشيّات أو اللماذات الخمس التي كان يطرحها الرئيس شهاب ويتساءل بشأنها، وسبق أن ذكرناها كلّها، فهل تغيّرت بفعل الحرب؟! إنّها بالحري زادت تفاقماً. فاللبناني غدا بالأحرى أكثر فساداً لا سيما في أداء الوظيفة العامّة، وأكثر مخالفةً للقانون، وأكثر حربقة في السياسة، وأكثر طائفية. وهذه بمجملها ليشيّات الرئيس شهاب، وهي لا تزال قائمة، بل هي أكثر رسوخاً ممّا كانت عليه في زمنه. وبالتالي للزعم بأن لبنان ما بعد الحرب لا علاقة له بتاتاً بلبنان زمن فؤاد شهاب. فهناك متغيّرات كثيرة طرأت، ولكن بالمقابل هناك ثوابت لمّا تزل باقية، بل بالأحرى زادت رسوخاً.
وأنتقل إلى محاضرة الدكتور محمد سلهب. وإنّني لأوافقه الرأي في تركيزه على أهمّية الإنماء الذي قاد الأمير اللواء مسيرته، والاهتمام بالريف من جميع النواحي. وهي نقطة قوّة في نهجه الإصلاحي، رغم بعض الآثار الجانبية السلبية التي أشار إليها الوزير شربل نحّاس، وفي طليعتها أنّها عملت أحياناً على تحفيز النزوح من الريف إلى المدينة. فالريفي الذي إذا ما تعلّم بعد أن أمّنت له مدرسة رسمية في قريته، فهو سينتقل حكماً إلى المدينة للعمل أو متابعة الدراسة. فليس هناك من علاجٍ مثالي يخلو من آثارٍ جانبيّة. ومفاعيل الإنماء الشهابي للقرى وللأطراف فاقت مفاعيله الإيجابية الآثار الجانبية.
وكذلك فإن تشديد الرئيس شهاب على المشكلة الاجتماعية في لبنان واعتبارها أشدّ وطأة من المشكلة الطائفية مسألة فيها نظر، وتستحقّ إلى يومنا هذا أن تطرح على طاولة البحث.
وتبقى إشارة د. سلهب إلى أن الخطة الخمسية التي طرحتها واقترحتها بعثة إيرفد في أواخر عهد الرئيس شهاب بقيت عديمة الجدوى و Caduque لأن الرئيس شهاب رفض أن يجدّد ولايته، وأن يبقى في السلطة كي ينفّذ مشروع بعثة إيرفد. وهو تساؤل مشروع، وسبق لي أن طرحته في كتابي ولا سيما في مبحث: هل تخلّى شهاب عن السفينة في عرض البحر؟! (ص399-400).
وأنتقل إلى مداخلة الأستاذ هشام ابن شقيق الصحافي ميشال أبو جودة. وأبرز ما فيها شهادة والده وعمّه القائلة إن البطريرك المعوشي لم يكن عارفاً بانقلاب القوميين وحسب، بل كان من المخطّطين له. وقد استقبل النقيب فؤاد عوض وهو بصحبة ميشال أبو جودة وشقيقه وزوجته يوم عيد الميلاد في 25 كانون أول 1961، وغمر البطريرك النقيب وقال له: “الله يوفّقك باللي رح تقوم فيه”.
إنها بالحري رواية مهمّة تكشف جديداً، ولا تتناقض مع ما ذُكر في كتابي عن معرفة البطريرك بالانقلاب قبل وقوعه. (فق: أسباب الخلاف بين المعوشي وشهاب، ص105-106). بل هي تنسجم مع هذه الروايات الأخرى وتعزّرها.
أما تساؤل هشام أبو جودة عن حقيقة أسباب الخلاف بين المعوشي وشهاب، وتشكيكه بما أوردتُ من خفايا وخلفيّات وأسباب فإنّني أعود لأكرّر أنّني سلّطت الأضواء على الجانب المالي والضرائبي لهذا الخلاف (ص106-107)، وكذلك الطبع المشاكس لهذا البطريرك الذي اختلف مع كلّ الرؤساء الذين عاصروه: بشارة الخوري، كميل شمعون، فؤاد شهاب، شارل حلو، وسليمان فرنجية (ص120-131)، ولم يكن خلافه مع الرئيس شهاب شواذاً على هذه القاعدة “المعوشية”!
وقول الأستاذ هشام أبو جودة إن الاعتداء على عمّه ميشال إثر كتابته مقالة “وداعاً أيها اللواء” في كانون أول 1959، كان محاولة اغتيال حقيقية وفاشلة، وليس مجرّد ترهيب وحسب، فهو رواية تستحقّ التوقّف عندها. بيد أنّنا لا نملك ما يؤكّدها أو يعزّزها على الأقلّ. لا سيما وأن عمّه لم يشر في ما كتب إلى شيء من ذلك، على حدّ ما نعلم. فلماذا بقي صامتاً وامتنع عن فضح المعتدين وغاياتهم؟!
وبشأن تكذيب هشام أبو جودة لروايات شنطة المصاري وبارودة كمال جنبلاط وسائر ما روي من تفاصيل انقلاب القوميين، فهي مسألة تحتاج برأينا إلى المزيد من التحقيق والتدقيق، وإذا كان يملك المزيد من التفاصيل في هذا الشأن فإنّني أدعوه إلى كشفها. وإنّني لأوافقه الرأي بأن محاولة الانقلاب القومي 1961 لا تزال بحاجة إلى المزيد من البحوث لكشف خفاياها وحيثيّاتها وتداعياتها والمشاركين فيها، لا سيما وأنّه سمّى منهم البطريرك الماروني نفسه وكذلك جريدة النهار!! وهي بكلّ ذلك تستحقّ أن تكون موضوع أطروحة بحدّ ذاتها.
أمّا إشارة الأستاذ هشام أبو جودة إلى أنّه لم يجد في كتابي تحليلاً لقانون الستّين الانتخابي، فالجواب على ذلك بسيط وبديهي. فالكتاب لم يدرس كل تفاصيل العهد الشهابي وأحداثه وإنجازاته. وقد تجنّب عن عمد التطرّق والتعمّق في الجانب الإصلاحي والمراسيم الاشتراعية الإصلاحية والتي بلغت نحو 162 مرسوماً، والقانون الانتخابي 1960، ذلك لأنها بمجملها كانت مدار أبحاث سابقة، ولا جدوى حقيقية ترتجى من تكرار كهذا!
وإنّني لشاكر للأستاذ هشام تنويهه يتحليلي لمقالتَي عمّه “في حمى الأمير”، و”وداعاً أيّها اللواء”. وأعتبر شهادته هذه وساماً يعلّق على صدري. وأدعوه إلى كشف المزيد من خفايا العلاقة بين ميشال أبو جودة وغسّان تويني، ممّا أشار إليه في مداخلته تلميحاً لا تصريحاً.
وختاماً كنتُ، ومنذ ردحٍ من الزمن، قد أحجمتُ عن إعداد ندواتٍ ولقاءات حول مؤلّفاتي، وقد بلغت اليوم بهذا المولود الجديد التسعين كتاباً، وكلٌّ منها ولدٌ عزيز فأيُّها أختار؟! لكن بادرة الأستاذ مرسيل حنين نائب رئيس الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT لم تترك لي مجالاً للاعتذار، فله ولهذا الصرح الأكاديمي الذي تعتزّ به منطقة جبيل جزيل الشكر.
والشكرُ موصولٌ للمحاضرين في هذه الندوة، ولكل الحاضرين.
«»«»«»«»«»([11])
[1] -صليبا، لويس، ذكريات ومشاهد وشخصيّات من لبنان في الستّينات والسبعينات 1960-1980، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2023، ب3/ف8، فق: اختطاف ثلاثة تلامذة من مدرسة الوردية 15/11/1979، ص385-389.
[2] -الراسي، سلام، في الزوايا خبايا، بيروت، مؤسّسة نوفل، ط1، 1974، ص227.
[3] -الراسي، سلام، لئلا تضيع: أحاديث وأحداث، قصص وأخبار، طرائف وأمثال جمعتها عن ألسنة الناس، بيروت، مؤسّسة نوفل، ط1، 1971، ص175.
[4] -صليبا، لويس، وجه أمّي وجه أمّتي، حكم وأمثال ونوادر ووجوه وأزجال من التراث اللبناني، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2024، ص228.
[5] -المنجد في اللغة العربية المعاصرة، إشراف صبحي حموي، بيروت، دار المشرق، ط3، 2008، ص925.
[6] -البيضاوي، الإمام ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر (ق7هـ)، تفسير البيضاوي المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق الشيخ محيي الدين الأصفر، بيروت، دار المعرفة، ط1، 2013، تفسير سورة آل عمران 3/122، ص199.
[7] -ابن منظور، جمال الدين محمّد بن مكرم (630-711هـ)، لسان العرب، بيروت، مؤسّسة الأعلمي، تحقيق يوسف البقاعي وآخرين، ط1، 2005، ص2/2430.
[8] -صليبا، لويس، صدام الأديان والمذاهب في لبنان، شهادة من الماضي وعبرة للآتي دراسة وتحقيق لـ مشهد العيان بحوادث سوريّة ولبنان لميخائيل مُشاقة (1799-1888)، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط4، 2022، ب1/ف2، ص66-70.
[9] -صليبا، لويس، في تاريخ لبنان المعاصر وكتابة تاريخه (1900-1975)، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2025، ص26
[10] -ناصيف، نقولا، جمهورية فؤاد شهاب، تقديم فؤاد بطرس، بيروت، دار النهار، ط1، 2008، ص297.
[11] –
 دار بيبليون
دار بيبليون