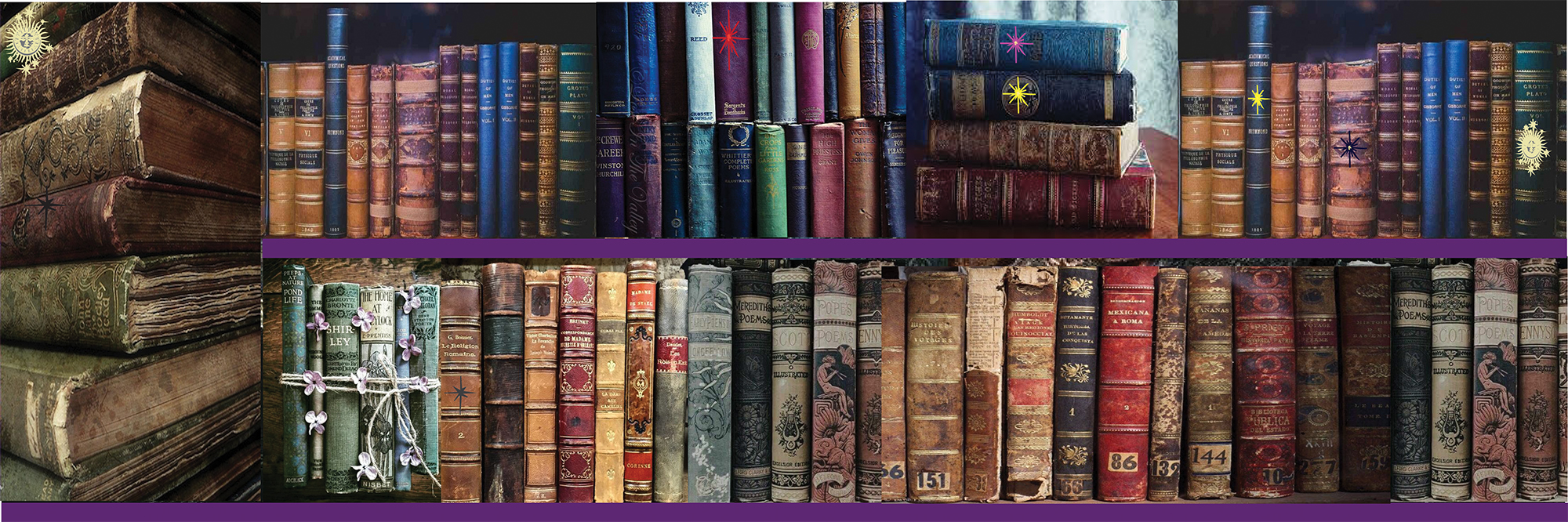غلاف ومقدّمة كتاب “الماسونية وأثرها في الأديان الإبراهيمية”/ تأليف لويس صليبا
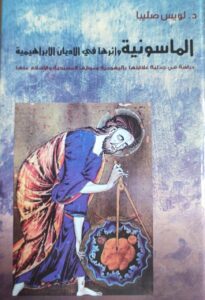

المؤلف Author: بروفسور لويس صليبا Pr Lwiis Saliba
عنوان الكتاب : الماسونية وأثرها في الأديان الإبراهيمية
دراسة في جدلية علاقتها باليهودية وموقف المسيحية والإسلام منها
Title :The Freemasonry and its impact on Abrahamic Religions
عدد الصفحات: 425ص
سنة النشر: طبعة ثانية 2018، ط1: 2018.
لوحة الغلاف : مهندس الكون الأعظم/لوحة ق 13ً المتحف الوطني-النمسا
الناشر : دار ومكتبة بيبليون
طريق المريميين-حي مار بطرس/جبيل
ت: 540256/09- 847633/03 ف:546736/09
Byblion1@gmail.com www.darbyblion.com 2018-جميع الحقوق محفوظة
يمنع تصوير هذا الكتاب بأية طريقة كما يمنع وضعه للتحميل على الإنترنت
ديباجة الكتاب
مدخل إلى بحوثه وعمارته
مباحث الديباجة:
-المؤامرة ثالث الغول والعنقاء
-الماسونولوجيا لا أثر لها في المكتبة العربية
-القارئ مرهق من الأحكام المسبقة
-معلومات تكتنفها الأوهام
-من أراد أن يقرأ السياسة لا يمكنه جاهل الماسونية
-الماسونية كالاستشراق
-تاريخ العلم هو تاريخ تصحيح الأخطاء
المؤامرة ثالث الغول والعنقاء
“نحن في هذا الشرق التعِس مسكونون بنظرية المؤامرة”
يقول الباحث (كاتب هذه السطور)، ويكرّر. مؤامرة الغرب على الإسلام، ومؤامرة الصهيونية عليه، ومؤامرة الاستعمار على البلدان العربية…إلى ما هنالك من تعابير في القاموس السياسي والديني. فتكاد المؤامرة تقف بين الرجل وامرأته، والأب وبنيه، بل حتى بين المرء ونفسه. فالكلّ عرضة للمؤامرة، بل وضحيّة لها. وشبح المؤامرة جاثم في كلّ مكان، وكلّ دأبه وديدنه التصدّي لها. حتى غدت المؤامرة كطواحين الهواء في رواية سرفانتس، والكلّ كبطلها دون كيشوت يصرف العمر ملاحقاً طواحين المؤامرة ومسكوناً بهاجس مجاهدتها.
وبحوث هذا الكتاب، وكلّ ما يتعلّق بالماسونية في المشرق مثلٌ بيّن ونموذجيّ على *وهم* المؤامرة هذا: مؤامرة الصهيونية العالمية، و*شقيقتها وأداتها* الماسونية العالمية على العرب والمسلمين. وكثيراً ما يستخدم الحكّام والمسؤولون نظرية المؤامرة لتغطية فشلهم الذريع، وأخطائهم. وحظر الماسونية في سوريا آب 1965 مثل على ذلك (را: ب5/ف2).
الماسونولوجيا لا أثر لها فـي المكتبة العربية
ووسط هذا الركام الهائل من الأحكام المسبقة كيف لباحث أن يدرس الماسونية المشرقية من دون أن يصاب بشظايا قصف الخاصّة والعامّة عليها، ومن دون أن ينال *حصّته* من هذا القصف العشوائي؟!
يعرف المؤلف أنه في كتابه هذا يركب مركباً وعراً. فهو يخرج فيه عن المألوف والمتداول. فالكتب عن الماسونية إمّا مادحة أو قادحة. أما الدراسات المحايدة والموضوعية فتكاد تكون غائبة تماماً ولا أثر لها في المكتبة العربية!
فما هو متوفّر في هذه المكتبة من مصادر يمكن تقسيمه إلى فئتين:
1-مصنّفات كتبت بأقلام ماسونية.
2-مؤلّفات وضعها كتّاب من خارج الماسونية، أو خارجون عليها. وهم في الغالب معادون لها.
والمصادر التي كتبها ماسون أمثال شاهين مكاريوس وإدريس راغب وغيرهما، تهدف إلى إظهار محاسن هذه الحركة، وتستميت في الدفاع عنها، فتفنّد ما يُوجّه إليها من تُهم من دون أن تفشي شيئاً مهمّاً من أسرارها. لذا تكون معلوماتها ومعطياتها ناقصة وأحادية الجانب والتوجّه، ولا يمكن بالتالي الاعتماد الكلّي عليها.
أما البحوث التي كتبها غير الماسون، فهي، بطبيعة الحال، لا تحتوي على حقائق كافية عن الماسونية لأن أصحابها ليسوا ممّن يُسمح لهم الاطّلاع على أسرار الماسونية. لذا فغالباً ما تقوم كتاباتهم على الحدس والتخمين، وتُبنى على الفرضيات والاستنتاجات التي تصيب حيناً وتخطئ.أحياناً، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها أيضاً. وغالبية هذه الفئة من المؤلفات تنطلق من أحكام مسبقة، وتركّز على علاقة مزعومة للماسونية باليهودية والصهيونية والاستعمار. وتحشد كلّ ما بوسعها من أخبار تدينها من دون التثبّت من صحّتها وغربلتها وتفنيدها. وقد كفانا الباحث الرصين د. علي الوردي مؤونة وصف هذه الكتب، فقال عنها في بحثه الموجز في الماسونية: “كُتِبتْ بروح غير علمية، إذ هي مليئة بالسباب المقذع وقذف التهم بلا حساب. وقد ضاعت الحقيقة من جرّاء ذلك. فالقارئ الذي يقرأ تلك المؤلّفات لا يستطيع أن يتبيّن الحقائق من بين هذا الركام الهائل من الشتائم والتهم.” ([1](
القارئ مرهق من الأحكام المسبقة
أجل، تعبَ القارئ العربي وملّ من هذا الانحياز المسبق الذي يعمي صاحبه عن رؤية الكثير من الحقائق والمعطيات، ومن هذه الأحكام الجاهزة والمسبقة التي تقوّض أسس المنطق والمنهج العلمي والموضوعي. والوردي محقّ في قوله إذ يردف: “ومن المؤسف أن نجد الكثيرين من كتّابنا لم يتعلّموا بعد أسلوب البحث العلمي الحديث. فإذا كتب أحدهم في أي موضوع اتّخذ موقف الخطيب المتحمّس، وأخذ يصبّ اللعنات، أو ينشد المدائح.” ([2](
وبكلمة مختصرة مفيدة فالماسونولوجيا (علم الماسونية Maçonologie) التي عملت ولا تزال على دمج الظاهرة الماسونية ودرسها في العلوم الإنسانية، لا أثر لها في العربية وكتّابها. ولعلّ أحداً لم يسمع بها في هذا المشرق حتى اليوم. ومؤلف هذا الكتاب يخاطر ليقدّم بحثاً ودراسة في الماسونولوجيا، ولا غرض له في امتداح الماسونية، ولا في هجائها. وإذا كان كلّ من يؤلف كتاباً يسعى إلى أن يُثنى عليه ويُمدح، فحسبه هو أن ينجو من اللوم … والذمّ. فهو يعي تماماً أن: “هذه الطريقة لا يرضى عنها بعض القرّاء لأنهم اعتادوا على الأسلوب الخطابي في ما يقرأون.” طبقاً لتعبير علي الوردي.([3](وهو لا يملك سوى أن يضمّ صوته إلى صوت الباحث العراقي الرصين إذ عبّر عن أمنية حارّة يتوق إليها كلّ الباحثين الأكادميين: “ونرجو أن يقلّ عدد هؤلاء القرّاء بمرور الأيام. فنحن لا نتوقّع من أنفسنا أن نسير في سبيل الحضارة الحديثة ما لم نتّبع أساليبها”([4](
ولم يدر في خَلَد الباحث بداية أن يضع دراسة متكاملة ولا حتى مصنّفاً في الماسونية. بيد أن الفكرة راودته تدريجيّاً، ومع تورّطه في البحث والتنقيب. كانت الخطوة الأولى محاضرة بل مداخلة في ندوة (أشير إليها في هامش في مطلع ب1/ف2) أثارت العديد من التساؤلات والإشكاليات. ممّا أتاح له أن يعاين وطأة الأفكار المسبقة والأحكام المتسرّعة والمتجنّية على الماسونية عند العامّة والخاصّة على السواء. فدفعته هذه المعاينة إلى التوسّع في التفتيش والتنقيب. فتحقّق من افتقار المكتبة العربية إلى مصنّف واحد في الماسونولوجيا، رغم أنها تذخر بالمؤلّفات المعادية والمؤيّدة لها في آن.
وهو لم يشأ أن يخوض في مقدّمات ومعلومات عامّة عن الماسونية وتاريخها وطقوسها، وغير ذلك ممّا قد يجده القارئ في مصنّفات أخرى. ولكن البحث ألزمه بالعديد من التعريفات والهوامش التوضيحية التي من دونها يصعب فهم المتن. فالمعلومات والمعطيات التاريخية عن نشأة الماسونية وتطوّرها في الغرب ثم في الشرق مثلاً يجدها متصفّح هذا السِفر في هوامش ب1/ف2 وهي مُستقاة، في الغالب، من مصادر ومؤلّفات غربية رصينة ومحايدة. وقد اعتاد قرّاء الباحث على التعريفات والتراجم في الهوامش، وأثنى عدد منهم على هذا المجهود الذي من شأنه أن يعين على قراءة سطور المتن…وما بين السطور.
معلومات تكتنفها الأوهام
وكان التركيز بداية على المنهجية، لا سيما وأن المصنّفات العربية في الماسونية تفتقر إليها. ولكن اعترضت البحث صعوبات جمّة أبرزها عدم توفّر المعطيات الثابتة والتاريخية بشأن هذه العشيرة. فالمعلومات حولها اكتنفها الكثير من الأوهام والأحكام المسبقة بفعل ما تعرّضت له من حملات متلاحقة. وفي ظلّ هذا النقص الفادح في المعطيات، وغموض ما توفّر منها عمد الباحث إلى النصوص ولا سيما الماسونية منها وما كتبه الماسون، فهي الوثائق الأساسية التي من شأنها التعويض. والكتاب بمجمله بحثٌ يستقرئ النصوص ويحلّلها ويستنطقها ويستخرج منها الدلائل والبيّنات ليبني على الشيء مقتضاه. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى مشكلة أساسية كان على الباحث أن يواجهها، وهي عدم توفّر مصادر تورد النصوص والوثائق بدقّة وتؤرّخ لها بأمانة. ومثل على ذلك كتاب حسين عمر حماده *الماسونية والماسون في الوطن العربي* فهو، على ما حوى من وثائق قيّمة، يخبط خبط عشواء، فيورد نصّاً، أو وثيقة، من دون ذكر المصدر. فينقل مثلاً فتوى المفتي عام الأردن في الماسونية من دون أن يذكر تاريخها ولا اسم المفتي!
وحتى د. علي الوردي في بحثه الموجز الرصين عن الماسونية يورد الفتوى عينها، ويشدّد على أهمّيتها كونها: “أول فتوى دينية صدرت في الإسلام عن الماسونية، إذ لم يكن صدر قبلها أية فتوى صريحة في هذا الموضوع” على حدّ قوله.([5](
ورغم ذلك فهو لا يذكر اسم المفتي، ولا تاريخ الفتوى!! ويكتفي بذكر المصدر الذي نقل عنه. وأية قيمة لفتوى أو حتى وثيقة غير مؤرّخة؟!
وهو كذلك يذكر حدثاً مهمّاً وقع إثر إلغاء عقد المؤتمر الماسوني في بيروت آب 1965، فيقول حرفياً التالي: “اضطّر المحفل الأكبر اللبناني تجاه هذا القرار أن يدعو عدداً من أقطاب الماسونية في العالم لزيارة بيروت. وقد وصل هؤلاء إلى بيروت في أوساط آب، فاستقبلهم [نائب رئيس مجلس النوّاب] أديب الفرزلي، وذهب بصحبتهم إلى السراي، حيث زاروا رئيس الوزراء رشيد كرامي”([6](
ورغم أهمّية هذا الحدث ودلالاته، فهو لا يذكر تاريخه، ولا المصدر الذي نقله عنه!!
وإذا كانت هذه حال بحث رصين كالذي كتبه الوردي، فما القول في سائر البحوث والمصنّفات العربية!؟ حدّث عندها ولا حرج.
ماذا الآن عن عمارة هذه الدراسة وأبوابها وفصولها ومباحثها؟
الباب الأول: *الماسونولوجيا: نحو دراسة علمية للماسونية* يأتي بمثابة مدخل عام في الموضوع ومنهجية دراسته.
والفصل الأول (ب1/ف1) يروي المؤلف فيه كيف عرف الماسونية. وقد يسأل سائل لِمَ يستهلّ بحثه بتجربته مع الماسونية، وهي تجربة سالبة، إذ لم يدخل محفلاً في حياته!؟
سبق للباحث أن روى تجارب عديدة له في مستهلّ دراساته، كتجربته في المسيحية([7](والإسلام([8](والهندوسية([9](والبوذية،([10](أما سرد حكاية تعرّفه إلى الماسونية فله سببان:
1-الأول سبب عامّ، فأكثر أبحاثه تنبثق من معرفة اختبارية. وقد عرّف بها وبحث في أهمّيتها في دراسة آنفة.([11](لا سيما وأنه ينتمي إلى نهج دراسة الدين من الداخل، كما سبق له أن أوضح مراراً. ([12](([13](
2-أما الثاني فخاصّ بهذه الدراسة وموضوعها. فالقارئ العربي لم يعتد نبرة محايدة في الماسونية، كما سبق وذُكر. وهو ما أن يشعر أن الكاتب لا يهاجم هذه العشيرة، ويرشقها بوابل من التهم، حتى يخاله مدافعاً عنها وواحداً من أفرادها. فالأمر بالنسبة إليه إما أسود أو أبيض، وما من منزلة بين الاثنتين. فكان لا بدّ من توضيح هذه النقطة دفعاً لأي التباس. وإذا كان الباحث مولعاً بدراسة الأديان والظواهر الروحية والشيَع والمذاهب من الداخل، فالماسونية تأتي هنا شواذاً على هذه القاعدة، كما يخلص في خاتمة ب1/ف1. فالمسافة بين الباحث وموضوعه تبدو في هذه الحال ضرورية، بل وإلزامية لتأمين الحياد وهو غير مألوف في هذا الموضوع.
والفصل الثاني (ب1/ف2): *مدخل إلى الماسونية ومنهجية دراستها* قد يكفي عنوانه دلالة على محتواه. فهو يعرّف بالماسونية وعلمها: الماسونولوجيا، ويتناول علاقتها بالدين ويورد معطيات إحصائية عن مدى انتشارها في مختلف أرجاء العالم وبلدانه. ويخصّ في الهوامش تاريخها في مصر ولبنان كلّ بنبذة.
والفصل الثاني من الباب الأول (ب1/ف2) يدخل في صُلب الموضوع: *جذور معاداة الماسونية في الغرب والشرق* وأبرزها الروابط الوطيدة بين العشيرة وسائر الحركات الباطنية *إيزوتريك* وهذه الأخيرة معادية دوماً، وعلى خطّ مستقيم، للأديان الظاهرية Exotérique أي الأديان الأكثر انتشاراً في العالم، وعلى رأسها المسيحية والإسلام.
ويبدأ ب1/ف3 بما سيُعتمد في سائر الفصول: دراسة النصوص الماسونية وتحليلها ونقدها. فيورد نصّاً لجرجي زيدان يحلّل فيه أسباب معاداة الماسونية. ويعيد ذلك إلى سرّيتها ومبالغة أعضائها في الحفاظ على هذه السرّية، وهو لا يرى مبرّراً لكلّ ذلك. ويؤكّد أن هذه السرّية بات ضررها يفوق الفوائد. ويناقش ب1/ف3 طروحات زيدان هذه ويحاول سبر أغوارها وفقه خلفيّاتها.
والباب الثاني (ب2) يتناول *محطّات من تاريخ الماسونية في المشرق*
والمحطّة الأولى في الفصل الأول (ب2/ف1)، وهي الصراع الذي احتدم بين *الماسون واليسوعيين في الشرق*. وهو يقارب هذا الموضوع المهمّ والحيويّ في التاريخ الماسوني عبر نصّ طويل لشخصية ماسونية بارزة في ق19: شاهين مكاريوس. وعنوان مقالته: *الماسون الأحرار والجزويت المنافقون*. وبعد تحشية نصّ مكاريوس بما يلزم من شروحات وتوضيحات، يتوقّف ب2/ف1 عند العداء التاريخي بين الفريقين: كان للماسون يد طولى في حلّ الرهبانية اليسوعية، ولم يغفر لهم هؤلاء فعلتهم هذه، فردّوا لهم الصاع صاعين في مناطق عديدة من العالم، ومنها لبنان وسوريا ومصر. ولكن عداوة الأمس انقلبت حواراً قُبيل الحرب العالمية الثانية، ولا تزال قنوات الاتصال والحوار مفتوحة. واليسوعيون الذين كانوا صقور الكنيسة في صراعها مع الماسونية هم اليوم روّاد الحوار الكاثوليكي/الماسوني. ويتوقّف هذا الفصل عند النزعة الماسونية المعادية للإكليروس: أيٌّ سبق: معاداة الإكليروس أم معاداة الماسونية، وأي منهما كانت سبباً للأخرى؟ أم أن بين الاثنتين علاقة جدلية، ويصعب تحديد من بدأ، وقد يستحيل!
ويفنّد ب2/ف1 الكثير من مزاعم مكاريوس وطعونه في اليسوعيين. فقد كانوا روّاد الطباعة في عصر النهضة. ولا صحّة لما ادّعاه من أنهم كانوا يطبعون كتباً معادية للإسلام، فهو تحريض ودسّ رخيص. والماسون بدعمهم الكامل والدائم للاحتلال الإنكليزي لمصر هم آخر من يحقّ له رشق الآخرين بتهم العمالة للاستعمار.
ويستخرج ب2/ف1 الكثير من المعطيات والوقائع التاريخية من نصّ مكاريوس هذا. فهو معاصر للأحداث، والقراءة النقدية له من شأنها الكشف عن الكثير من الحقائق والثوابت الماسونية.
وينتهي الفصل بذكر الرسالة التي بعثها يعقوب صرّوف إلى الأب لويس شيخو اليسوعي، بعد وفاة مكاريوس، داعياً فيها إلى مهادنة بين الفريقين اللدودين، ونافياً المزاعم القائلة إن الماسونية معادية للمسيحية. ومبيّناً أن من شأن العشيرة حماية المسيحيين، وهم أقلية في الشرق، وجعل إخوانهم الماسون المسلمين يحترمونهم ويقرّون بحقوقهم. وللرسالة هذه شأن كبير ودلالات عديدة. والباحث لن يتوانى عن عرضها وتحليلها يوم يقع على نصّها الكامل.
والفصل الثاني ب2/ف2: *الماسونية المصرية وموقفها من المطامع الصهيونية* يورد نصّاً، لعلّه من أهمّ الوثائق في تاريخ الماسونية المشرقية. إنه نداء المحفل الأكبر الوطني المصري إلى أهالي فلسطين في 2/4/1922. والغريب في الأمر أن ما من واحد ممّن اتّهم الماسونية بأنها أداة طيّعة بأيدي الصهيونية، وما أكثرهم، توقّف عند هذا النداء.
يدعو نداء المحفل أهالي فلسطين إلى استقبال اليهود “الذين يطمحون للرجوع [إلى فلسطين] لفائدة وعظمة الوطن المشترك” وفق تعبيره. إنها حقاً دعوة/فضيحة. فهل كان المحفل الأكبر المصري ألعوبة بيد الصهاينة ينفّذ لهم رغباتهم ويعينهم على تحقيق أهدافهم؟!
ويدرس ب2/ف2 بداية شخصية إدريس راغب رئيس المحفل، ومهندس النداء وموقّعه الأول. ويفنّد المزاعم القائلة بأثر يهودي بيّن في فكره ومؤلّفاته ومؤلّفات صديقه شاهين مكاريوس الآنف الذكر. ثمّ يتوقّف متبصّراً في البصمات الصهيونية في النداء وخلفيّاتها ودلالاتها. ليتبسّط بعدها في عرض وتحليل ردود الفعل على النداء. وأوّلها بيان محفل الشفق الماسوني/يافا. وهذا الأخير رفض دعوة النداء ومزاعمه جملة وتفصيلاً. وموقف محفل يافا هذا لوحده بيّنة تكذّب ما يشاع عن الروابط الوطيدة بين الصهيونية والماسونية وعمل الأخيرة على تنفيذ مخطّطات الأولى ومؤامراتها.
وكان لردود الفعل العنيفة على النداء، والتي جاء أكثرها من ماسونيي مصر، أن جعلت المحفل المصري يتراجع عن موقفه، ويُصدر بياناً توضيحيّاً إلى أهالي فلسطين في 28/4/1922. ويورد ب2/ف2 النصّ الكامل لهذا البيان، ويقرأه قراءة نقدية من الداخل. ثمّ يتبسّط في عرض تداعيات نداء المحفل وتحليلها. وأوّلها معركة حامية في الصحف. بيد أن أبرزها ما أسفر عنه من انقسام داخلي في الماسونية المصرية أدّى إلى إزاحة إدريس راغب عن رئاسة المحفل. وما عقب ذلك من صراعات. وهو يروي كل هذه الأحداث وما نتج عنها من شرخ ماسوني عمودي، ويتوقّف عند دلالاتها: فهي تؤكّد أن الخرق الصهيوني للماسونية المصرية قد تمّ تطويقه والقضاء على ذيوله، وأن ما يُحكى عن تأثيرات صهيونية أخرى لا يعدو كونه مزاعم واهية.
والباب الثالث مخصّص لموضوع حيويّ أثار، ولا يزال، الكثير من الجدل والنقاش: *الماسونية واليهودية*.
والفصل الأول منه ب3/ف1: *اليهودية في النصوص والأساطير الماسونية* يغوص بحثاً عن أسباب الربط، في أذهان العامّة وحتى الخاصّة، بين الماسونية واليهودية. فيلحظ بداية أن الأولى هي التي ربطت تاريخها المفترض ونشأتها المتخيّلة بالثانية. ويستعرض ما يروي الماسون من أخبار أو بالحري أساطير تأسيسية عن نشأة عشيرتهم. وأوّلها وأشهرها بناء هيكل سليمان. فيرى أن الماسونية صادرت هذه الرواية التوراتية وجيّرت شخصية المهندس الصوري الماهر حيرام أبي لحسابها، بحثاً عن شرعية كتابية بيبلية. فبذلك تقف على قدم المساواة في الأقدمية مع الأديان، ولا سيما المسيحية منافستها وخصمها. وهذا الربط بين حيرام أبي والماسونية نشأة وتعليماً مجرّد أسطورة. ومثله الزعم أن مؤسّس الماسونية هو الملك هيرودس أكريبا (37-44م) حفيد هيرودس الكبير. وأن هدفه من تأسيس هذه الجمعية السرّية كان محاربة المسيحية: الديانة الناشئة والخارجة على اليهودية والمنافسة لها.
ثمّ يستعرض ب3/ف1 نظريات المؤرّخين في نشأة الماسونية فيرى أن قلّة منهم لا تتجاوز نسبتها 3% ترى للعشيرة أصولاً يهودية. أما الماسونولوجيا فقد أسقطت كلّ الأساطير التأسيسية ولا سيما تلك التي حكت عن علاقة وروابط وشيجة بين اليهودية والماسونية وخصوصاً في زمن البدايات *المتخيّلة*.
فإلى ماذا يعود إذاً هذا الربط الوطيد في الأذهان بين الديانة العبرية والعشيرة؟ يتساءل ب3/ف1 في الخلاصة/الخاتمة. ويجيب: لا شكّ أن ما يعرف بِ *بروتوكولات حكماء صهيون* قد رسّخ هذه المعادلة المتخيّلة. وهو بذلك يمهّد لدراسة هذه البروتوكولات.
والفصل الثاني ب3/ف2 *بروتوكولات حكماء صهيون الوثيقة المفبركة* هو، في الحقيقة، مدخل تعريفي وتمهيدي: كيف ظهرت هذه البروتوكولات؟ وأين؟ ومتى؟
يروي ب3/ف2 كيف ظهر هذا النصّ في روسيا في بدايات ق20 أي في زمن مأزوم ونقمة وثورة على الحكم القيصري. فرأى رجال المخابرات القيصرية أن يضربوا أعداء النظام، على تناقضهم والخصومات في ما بينهم، ضربة واحدة: اليهود والمحافل الماسونية بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً الكنيسة الكاثوليكية والرهبنة اليسوعية. فبذلك يحوّلون نقمة الشعب على القيصر إلى كراهية لليهود والماسون، ويجعلونه يلتفّ حول هذا الأخير. فوضعوا نصّ البروتوكولات المشبوه هذا وسرّبوه.
وفي البروتوكولات عناصر عديدة تفضح الوضع، وتبيّن أن كاتبها ليس بيهوديّ، بل ولا يعرف عن اليهودية والتوراة والمطامع الصهيونية شيئاً مهمّاً. وهي لا تتضمّن آية بيبلية واحدة، ولا أيّة عبارة تلمودية . وتصبّ اهتماماتها على مواضيع ومسائل روسية/قيصرية صرف كالدفاع عن الاستبداد المطلق، وعمّا يسمّى *الأرستقراطية الطبيعية الوراثية*، والهجوم على التيّارات المعادية للقيصر كالليبرالية والاشتراكية وكذلك الكنيسة الكاثوليكية، (غريمة الكنيسة الأرثوذكسية)، ورأس حربتها الرهبنة اليسوعية. وهل من المنطق في شيء أن توضع كنيسة روما ورهبنتها في خندق واحد مع عدوّتها اللدودة: الماسونية؟!
هذه العناصر، وكثير غيرها ممّا يعرض ب3/ف2 ويحلّل، تفضح زيف وثيقة البروتوكولات التي انتشرت في أوروبا انتشار النار في الهشيم، وأجّجت تيارات معاداة السامية، ومعاداة الماسونية كذلك والتي تجسّدت في الأحزاب التوتاليتارية كالنازية والفاشية وغيرها.
والفصل الثالث ب3/ف3 يتوقّف تحديداً عند المسألة الأخيرة هذه: تواريخ انتشار البروتوكولات وجغرافيته وآثار كل ذلك والتي لمّا تنتهي فصولاً بعد، ولا سيما في المشرق. فحتى هجمات 11 أيلول 2001 يزعم بعض العرب أن حكماء صهيون هم من نسّقها وخطّط لها!! إنها نظرية المؤامرة المعشعشة في عقول الكثيرين، ولا سبيل لتطهير هذه العقول والأذهان منها.
أما الفصل الرابع ب3/ف4 فيستعرض نصّ البروتوكولات، ولا سيما ما تعلّق منه بالماسونية ومحافلها، ويقرأه قراءة نقدية. والسرّية المعتمدة في المحافل سهّلت إلصاق شتى التهم المتضاربة بهذه الأخيرة. فهي مجرّد أداة يتحكّم بها اليهود ويستغلّونها لتنفيذ مخطّطاتهم ومؤامراتهم للسيطرة على العالم، ولإقامة حكومتهم المنشودة، ومركزها أوروبا!! وذلك خلافاً للمطامع والمخطّطات الصهيونية في إقامة هذه الحكومة في فلسطين أرض الميعاد. ويبدو أن كاتب البروتوكولات لا يعرف شيئاً عن حقيقة هذه المطامع والمخطّطات وطبيعتها. فكيف يصحّ الزعم القائل إن كتّاب هذه البروتوكولات هم حكماء صهيون؟!
والخلاصة فالبروتوكولات وليدة كراهيتين: معاداة السامية، وشقيقتها معاداة الماسونية. وهي المشاعر والأجواء المسيطرة في الأوساط القيصرية في بدايات القرن المنصرم ونهايات ما قبله، زمن تلفيق هذا النصّ المزيّف.
أما استناد العرب إلى البروتوكولات واستغلالهم لها في الصراع العربي/الإسرائيلي، وفي حربهم ضد الصهيونية ومطامعها، فهم فيه أشبه بالهرّ الذي يلسح المبرد، ويستمتعّ بدمه النازف. فما بُني على باطل يبقى باطلاً، و{إن الباطل كان زهوقا} (الإسراء/81).
والباب الرابع ب4، يتناول تحديداً هاتين المعاداتين، فمعاداة الماسونية ما هي سوى وجه من وجوه معاداة الساميّة في المشرق. وقد نقلت أوروبا عدوى هذا المرض إلى هذه المنطقة لتستريح هي منه. أما كيف نجحت في نقل العدوى، فعبر زرع الكيان الصهيوني الدخيل ودعمه المتواصل.
والفصل الأول: ب4/ف1: *اختلاق الأساطير لمعاداة الماسونية* يتناول نماذج من المؤلّفات التي تصنّع نظريات المؤامرات السرّية الخطيرة والعالمية وتروّجها. وأوّلها كتاب *حكومة العالم الخفيّة* والمؤلف أحد أشراف روسيا القيصرية ويستعيد طروحات البروتوكولات في اليهودية العالمية وأداتها الطيّعة الماسونية.
ويبقى أن الطامّة الكبرى تكمن في أن الباحثين العرب أمثال الزعبي وطعيمه وغيرهما استعاروا هذه الطروحات وكرّروها ببغائياً. ولا يتّسع المجال لتفنيد ما ورد في كل هذه المؤلّفات العربية ولا حتى في أكثرها، وهي متشابهة، ونقد واحد منها يغني عن تخصيص كل واحد منها بالتشريح والتفكيك والنقد. لذا اختار ب4/ف1 أحد هؤلاء الباحثين: الزعبي وفنّد ما ورد في كتابين له في الماسونية وعلاقتها باليهودية. وعمد إلى تفكيك منهجيّته وعناصر خطابه، وآليات منطقه وتفكيره.
والخلاصة فالعالم العربي وشقيقه الإسلامي أصيبا بعدوى معاداة السامية، وكانا بغنى عن هذا المرض الغربي الذي يتبرّم الغرب اليوم منه ويتبرّأ، وخلطاه، بوحي وتأثير من البروتوكولات، بآخر هو معاداة الماسونية. ولا يزالان حتى اليوم يقعان ضحية هذا الخليط.
والفصل الثاني ب4/ف2: *الماسونية والقومية السورية* يورد ثلاثة نصوص *ماسونية*:
1-استقالة أنطون سعاده زعيم الحزب القومي السوري الاجتماعي من محفل نجمة سوريا الماسوني.
2-استقالة والده د. خليل سعاده الرائد النهضوي من المحفل عينه.
3-بلاغ الزعيم سعاده بشأن الماسونية.
ويعرّف ب4/ف2 بالزعيم ووالده ونشاط كلّ منهما الماسوني.
وسعاده وحزبه مثل نموذجي على الأثر الماسوني في الجمعيات والأحزاب في المشرق. فقد استوحى الزعيم من العشيرة مفاهيم وآليات عمل عديدة لحزبه، فسرّية العمل والبنية والهرمية في الحزب منقولة عن الماسونية. وكذلك القَسَم ومبادئ التعاضد والتآخي بين الأعضاء وغير ذلك من العناصر. وكما في سائر الفصول يقرأ ب4/ف2 نصّ استقالة سعادة قراءة تحليلية نقدية، ويستخرج منه فلسفة الزعيم لتاريخ الماسونية وهي في الواقع تختصر فلسفته لحزبه القومي السوري. فهذا الأخير هو *ماسونية سعادة الخاصّة* إذا صحّ التعبير. وطالما أنه قد عمد إلى تأسيس ماسونيّته، فهل من جدوى بعد للحركة الماسونية؟! ومن هنا، وفي هذا السياق، يمكن إدراج بلاغ الزعيم عن الحركة الماسونية في أيار 1949. فبين نصّ الاستقالة والبلاغ بون شاسع، بل هما على طرفي نقيض! فالماسونية تحوّلت من *عشيرة مقدّسة* إلى *منظّمة انترناسيونية ذات أهداف هدّامة ويهودية النفوذ والرموز*.
كيف انقلب موقف الزعيم من الشيء إلى نقيضه؟! وهل شرب من البئر، ثم عاد ليرمي فيه حجراً، بل ركاماً من الأحجار؟!
يسبر ب4/ف2 غور هذه المواقف المتناقضة، ويسعى لجلاء خفاياها وخلفيّاتها. و”تعاليم الحركة القومية تُغْني عن شعارات الماسونية” يقول الزعيم. لأنها في الحقيقة مستوحاة منها، بل وأكثرها منقول عنها!!
والباب الخامس والأخير ب5:*المسيحية والإسلام في مواجهة الماسونية* وكما يدلّ عليه عنوانه، وبعد تفحّص مسألة علاقة الماسونية الجدلية باليهودية، يبدو من البديهي دراسة علاقتها بالديانتين الإبراهيميّتين الأخريين. وهذا ما يكرّس الباب الخامس والأخير له مباحثه.
والفصل الأول ب5/ف5: *الكنيسة والماسونية: حرمٌ فحوار* يعرض وثائق الكنيسة الكاثوليكية المتعلّقة بالماسونية، كما في سائر الفصول ويحلّلها ويدرس ظروفها من مختلف جوانبها.
وأولى الوثائق براءة البابا إكليمندس 12ً أو الحرم الأول 1738. ويروي ب5/ف1 ظروف هذا الحرم: مرض البابا وتحكّم الكوريا بقراراته. ولكن الحرم الأول عاد ليتأكّد ويتجدّد بثانٍ أصدره الخلف المباشر بندكتوس 14ً سنة1751. وقد استهدف خصوصاً محفل نابولي وكان يؤمّه كاثوليك وغير كاثوليك، وكانت الكنيسة تخشى هذا الاختلاط.
أما براءة لاون 12ً أو الحرم الثالث فقد صوّبت بوجه خاصّ باتجاه جمعيات الفحّامين Carbonari المقرّبة من الماسونية والتي عاثت فساداً، ونشرت العنف والذعر في أرجاء عديدة من أوروبا.
ونلمح عند بيوس التاسع أول إشارة تربط بين الماسونية واليهودية، فقد سمّى المحافل *كُنُس الشيطان*. ولعلّها الاشارة الوحيدة واليتيمة في وثائق الكنيسة الرومانية التي تندرج في هذا السياق.
ويبقى لاون 13ً أكثر الأحبار الرومانيين تشديداً للنكير على الماسونية. ولكنه يميّز بين الحركة وأفرادها، فيشمل هؤلاء بعطفه. وجاء المجمع المقدّس ليشرح موقف لاون 13ً وتوجيهاته التي تُعتبر الإدانة العقائدية الأولى للماسونية.
ورغم مباشرة الحوار بين الفريقين، وتطوّره بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، وسعي الماسون الحثيث إلى رفع الحرم عنهم، وتجاوب بعض الجهات الكنسية مع هذا السعي، إلا أن موقف مجمع عقيدة الإيمان ورئيسه الكاردينال راتسنغر جاء حاسماً. فقد أعلن 1983 أن حكم الكنيسة على الجمعيات الماسونية يبقى هو هو من دون تغيير. وصادق البابا يوحنا بولس الثاني على هذا الإعلان. وهذا الموقف الذي اعتبره الماسون متشدّداً لم يحل دون مواصلة الحوار بين الفريقين اللدودين، “فإن عدم التوافق بين انتماءين لا يمنع السعي المشترك نحو السلام” يقول يوحنا بولس الثاني.
والملاحَظ أنه رغم العداء المستفحِل بين الفريقين فإنّنا لا نجد اتّهاماً من الكنيسة الكاثوليكية للماسونية بأنها يهودية الصبغة والأهداف. أما عبارة بيوس التاسع الآنفة الذكر، فمجرّد توصيف عام، وليست اتّهاماً. وبالمقابل نجد النصوص والمواقف العربية ترشق الاتهامات في هذا السياق بلا حسيب ولا رقيب ولا بيّنة أو دليل، كما سيرد في الفصل التالي.
والفصل الأخير من الكتاب ب5/ف2: *الدول العربية والإسلامية تحظّر الماسونية* يحوي كمّاً كبيراً من الوثائق العربية والإسلامية في الماسونية. فهو يستطلع مواقف الدول العربية من العشيرة، وأكثرها حظّر الماسونية ومحافلها على أراضيه. وأول هذه الدول كان عراق الثورة 1958.أما السبب فيبقى إيّاه: الماسونية جمعية تعمل على تحقيق المشاريع والمطامع الصهيونية. ووصل الأمر بالعراقيين إلى إصدرا قانون يعاقب بالإعدام كلّ منتمٍ إلى هذه الحركة!! والموقف العراقي المتشدّد هذا مثال نموذجي على ذهنية التحريم التي لمّا تزل سائدة في العالمين العربي والإسلامي.
أما القرار المصري بحلّ المحافل الماسونية ومنعها 1964، فوراء الأكمة فيه ما وراءها. فلِمَ يحظّر عبد الناصر المحافل الماسونية وكان رئيساً فخرياً لعدد منها؟! لعلّ قرار الحظر يعود إلى هذا السبب تحديداً. ففي صراعه الطاحن مع الإخوان المسلمين روّج هؤلاء اتهاماً للرئيس المصري بالماسونية، ما جعله، على الأرجح، يقضي على الوجود الماسوني على الأرض المصرية دحضاً لهذه التهمة.
وماذا عن قرار الحظر السوري 1965؟ يخيّم عليه شبح الجاسوس الإسرائيلي كوهين وقد أُعدم قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من صدور القرار. وكان مقرّباً من الرئيس السوري أمين الحافظ ومطّلعاً على خزائن أسراره. فبحظر الماسونية أراد الرئيس أن يلهي الناس بحدث آخر ويقدّم لهم كبش محرقة يكفّر به عن خطاياه!!
وبشأن الماسونية في الأردن، فقد غلِط ماسونه غلطة الشاطر، في خضمّ المعمعة العربية المناوئة للعشيرة، فأصدروا بياناً أقرّوا فيه بأن الصهيونية العالمية استغلّت الماسونية استغلالاً مجرماً. ودعوا إلى “تطوير حركتهم في شكلها الماسوني العربي الجديد”.
فكان مفتي عام الأردن لهم بالمرصاد، فدفعوا ثمن إقرارهم بجرم لم يرتكبوه، ولا ارتكبه الماسون العرب، فتوى محرِّمة هي الأولى الصادرة عن مرجع إفتائي إسلامي رسمي 1964.
أما ماسون لبنان، فكانوا أكثر حذقاً من إخوانهم الأردنيين. ففكّوا كل ارتباط بين الماسونية واليهودية وزعموا أن الماسونية دين فينيقي وخلاصة الحضارة الكنعانية، وأن للماسون على اليهود ثأر لقتلهم حيرام أبي!!
وتكرِّر توصية مؤتمر مقاطعة إسرائيل 1977 المزاعم المتداولة عينها في علاقة الماسونية بالصهيونية العالمية، ولا تستند في ذلك إلا على شائعات وأوهام!
ويورد ب5/ف2 النصّ الكامل لقرار المجمع الفقهي بمكّة بشأن الماسونية. ويناقشه ويفنّده بنداً بنداً. وهو، كسائر الفتاوى الوهّابية، تكفيري بامتياز يحلّل دماء الناس ويستبيح رقابهم!
ويختم بفتوى أزهرية لا تحوي أي جديد!
من أراد أن يقرأ السياسة لا يمكنه تجاهل الماسونية
وفي الخلاصة لا يجب على الإنسان العربي أن يقف من الماسونية ولا أن يتعامل معها وكأنها الطاعون الذي يجب أن يفرّ منه بأي ثمن، وكأن أعضاءها مصابون به. فلا يغربنّ عن باله أن الأمير عبدالقادر الجزائري والأفغاني ومحمد عبده وسعد زغلول ومارون عبود وغيرهم كثير من رجالات المشرق والإسلام كانوا من الماسون.
ولا يجب على الإنسان العربي كذلك أن ينظر إلى الماسونية ويتعامل معها وكأنها وحدة عالمية مركزية لا تتجزّأ وتهدف إلى السيطرة على العالم ومقدّراته، فهذا وهم محبِط غالباً ما روّجه الحكّام العرب ليغطّوا فشلهم وسلسلة خيباتهم التي لا تنتهي. فالماسونية تعدّدية الطابع والمحافل، ولا ترتبط بسلطة واحدة موحَّدة. وتتّسم في كل بلد بطابع وطني وقوميّ. وقد اختلط تاريخها في المشرق بتاريخ هذه المنطقة بحيث يصعب الفصل بين الاثنين. فهي ليست مجرّد جمعية طارئة ولا هي دخيلة على هذه المنطقة من العالم كما يروّج أعداؤها، بل هي من صلبها، وكان لها أثر حاسم في أحداثها وسياستها وتاريخها، ولا سيما في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا. وكي يقرأ المرء السياسة جيّداً في هذه البقعة من العالم يجب أن يعرف هذه الحركة ومبادئها، ولا يمكنه أن يتجاهلها.
الماسونية كالاستشراق
أما من حيث ارتباط الماسونية بالاستعمار، فقد كانت في السابق كالاستشراق جزءاً من أدوات الشغل في الدول الاستعمارية، فاستخدمتها كما استخدمته لاستقصاء حال هذه المنطقة واستطلاع أوضاعها وأحوال شعوبها. وهل الاستشراق اليوم أداة استعمار كما استُخدم في القرنين 17 و18؟!
وختاماً قد يرى قارئ هذا السفر فيه الكثير ممّا طالما اعتبره باطلاً ونقيض الحقّ والحقيقة. ولا يملك المؤلف هنا سوى أن يذكّره بمقولة لافتة للفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار (1884-1962) Gaston Bachelard: “إن تاريخ العلم هو تاريخ تصحيح الأخطاء” ([14](
بيد أن الباحث لا يزعم ولا يدّعي فصل المقال في مسألة الماسونية التي أثارت ولا تزال الكثير من الجدل، وأهرقت بحوراً من الحبر. حسبه أن يمهّد الطريق لمزيد من البحوث الجادّة والرصينة في الماسونولوجيا، وأن تكون دراسته حافزاً لطرح الأسئلة والإشكاليات. فهذا هو السبيل الأساسي للتطوّر العلمي، وكما يقول باشلار: “باختصار فالإنسان الذي يحرّكه العقل العلمي يرغب بلا ريب أن يعرف، ولكن لكي يطرح المزيد من الأسئلة”([15](
Q.J.C.S.T.B.
باريس في 14/9/2017
[1] -الوردي، علي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، بغداد، 1972، ج3، ص329.
[2] -الوردي، م. س، ص329.
[3] -الوردي، م. س، ص330.
[4] -الوردي، م. س، ص330.
[5] -الوردي، م. س، ص3/381.
[6] -الوردي، م. س، ص3/383.
[7] -صليبا، د. لويس، اليوغا في المسيحية دراسة مقارنة بين تصوّفين، تقديم د. بيتسا استيفانو، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2016، ب1/ف2: من المسيحية إلى الإلحاد فاليوغا حكاية مسار واختبار، ص71-85.
[8] -صليبا، د. لويس، حدّ الرِدّة ركن التكفير بحث في جذور الأصوليّات التكفيرية في الإسلام، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2017، ب1/ف1: دراسة الإسلام من الداخل قصة تجربة، ص21-45.
[9] -صليبا، د. لويس، الصمت في الهندوسية واليوغا تعاليمه واختباراته في الڤيدا وسيَر الحكماء المعاصرين، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2016، ب1/ف2: الصمت في التصوّف الهندي، ص39-61.
[10] -صليبا، د. لويس، الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني دراسة في فكر ميخائيل نعيمه، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2018، ب1/ف1: نعيمه طريقاً إلى بوذا، ص29-37.
[11] -صليبا، د. لويس، جدلية الحضور والغياب بحوث ومحاولات في التجربة الصوفية والحضرة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2018، ب1/ف1: من المعرفة الاكتسابية إلى التفكّرية فالاختبارية، ص17-27.
[12] -صليبا، د. لويس، السنة والشيعة مذهبان أم ديانتان؟ بحث في الخلافات بينهما لا سيما في المتعة، تقديم عماد الهلالي، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2017، فق: حكاية دراسة للإسلام من الداخل، ص22-27.
[13] -صليبا، د. لويس، زرادشت وأثره في الأديان الخمسة الكبرى إيران المجوس جسر عبور بين أديان الشرقين الأقصى والأوسط، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2017، فق: دراسة الدين من الداخل، ص402-404.
[14]-Bachelard, Gaston, La formation de l’esptit scientifique contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Vrin, 1938, p8.
[15]-Ibid.
 دار بيبليون
دار بيبليون