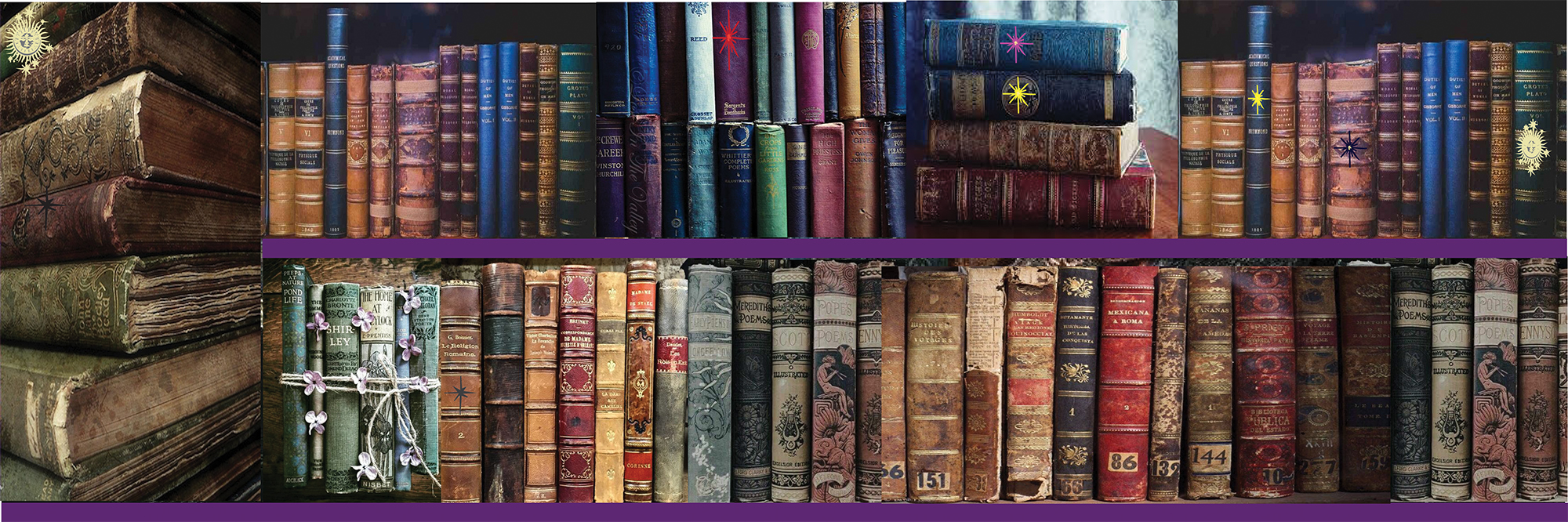مقدمة وغلاف كتاب “المسرح المعاصر في لبنان”/ تأليف لويس صليبا
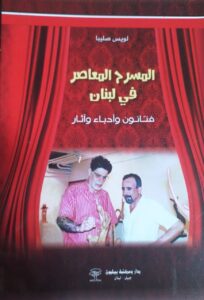
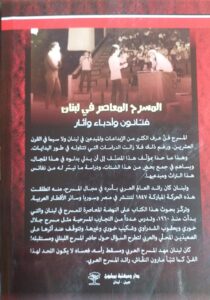
المؤلّف/Auteur: أ. د. م. لويس صليبا Lwiis Saliba
مستهند وأستاذ محاضر ومدير أبحاث في علوم الأديان والدراسات الإسلامية
عنوان الكتاب: المسرح المعاصر في لبنان: فنّانون وأدباء وآثار
Title:Theater in Lebanon: Artists writers & works Contemporary
عدد الصفحات: 280ص
سنة النشر: طبعة أولى 2022
الناشر: دار ومكتبة بيبليون
طريق الفرير، حي مار بطرس، شارع 55، مبنى 53، جبيل/بيبلوس-لبنان
ت: 09540256، 03847633، ف: 09546736
Byblion1@gmail.com www.DarByblion.com
2022©-جميع الحقوق محفوظة، يُمنع تصوير هذا الكتاب، كما يُمنع وضعه للتحميل على الإنترنت تحت طائلة الملاحقة القانونية.
تراث مسرحي وفنّي عُرضة للضياع
المسرح والفنون التشكيلية مجالان في الفنّ عرفا الكثير من الإبداعات والمبدعين في لبنان ولا سيما في الحقبة المعاصرة، أي في القرن العشرين. ورغم ذلك فلا زالت الدراسات التي تتناولهما في طور البدايات. ولا تزال المكتبة العربية تفتقد للمصادر والمراجع الوافية فيهما. ولا تزال المسرحيات واللوحات والمنحوتات اللبنانية مشرورة هنا وهناك وهنالك، تنتظر من يجمع شتاتها. وهي معرّضة الآن وكلّ آن لخطر الضياع!
وهذا ما حدا بمؤلّف هذا المصنّف وكاتب هذه السطور، إلى أن يدلي بدلوه في هذا المجال، ويساهم ضمن ما تُتيحه له إمكاناته في جمع بعضٍ من هذا الشتات، ودراسة ما تيسّر له من نفائس هذا التراث ومبدعيها. والخطوة الأولى كانت أن استحدث في مجلّة الأمن/بيروت زاوية “مبدعون من لبنان” ركّز فيها خصوصاً على المسرحيين والرسّامين.
المسرح اللبناني هو الأقلّ حُظوة بالدراسة
فمنذ مارون النقّاش (1817-1854) ([1]) رائد المسرح في العالم العربي عرف لبنان عدداً وافراً من المؤلّفين المسرحيين الذين كتبوا مئات المسرحيات، لكن إبداعاتهم كانت ولمّا تزل عُرضة للإهمال والضياع. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن المسرح في لبنان كان بين سائر الأنواع الأدبية من شعر ورواية ومقالة وقصة وغيرها الأقلّ حظوة بالدراسة والاهتمام.
وما يقال عن المسرح ينسحب على الرسم والنحت والفنون التشكيلية عموماً. فأين هي المتاحف التي تجمع نفائس اللوحات والمنحوتات وتصونها من الضياع؟! على الصعيد الرسمي لا شيء يذكر. وتبقى المبادرات الفردية في هذه المحلّة أو تلك عاجزة عن أن تفي بالغرض. وأين الدراسات والموسوعات والكتب المزوّقة والمزيّنة باللوحات beaux livres؟! يبقى ما صدر عن المطابع ودور النشر في هذا المجال غير وافٍ ولا يحفظ سوى النذر اليسير من هذا التراث الفنّي النفيس.
700 مسرحية لبنانية في قرن وربع
قام العالِم البيبلوغرافي يوسف أسعد داغر([2]) بإحصاء شامل للحركة المسرحية اللبنانية بين عاميّ 1848 و 1972، أي منذ انطلاق المسرح اللبناني والعربي مع مارون النقّاش وحتى سنة إحصائه، فكانت النتيجة ما يلي: “يتبيّن من التدقيق في هذا الثبت، أن 227 كاتباً أو مؤلّفاً لبنانيّاً، وضعوا للمسرح تأليفاً أو ترجمة نحواً من 705 مسرحيّات. ونحن على يقين من أنّه قد فاتنا في عملية الجرد هذه، عدد من هؤلاء المؤلّفين تتراوح نسبتهم بين 8 و 12%”([3])
نتاجٌ ثقافي ضخم في وطنٍ صغير. ورغم أن هذه المساهمات الفكرية والفنّية والثقافية هي من أبرز مبرّرات وجود لبنان وديمومته واستمراره، فهي عُرضة للضياع. تراثٌ كاملٌ قيّم مهدّدٌ بأن يُفقد، ولا من يسأل!!
ومن هنا فما كُتب وصدر في المجالَين المذكورَين يحتاج إلى أن يُرفد بالمزيد من التحقيقات والبحوث والدراسات والحوارات وتسليط الأضواء بالتالي على الكثير من النفائس القابعة في الأدراج والصالونات والتعريف بمبدعيها.
لبنان رائد العالم العربي في المسرح
ولبنان كان رائد العالم العربي بأسره في مجال المسرح، منه انطلقت هذه الحركة المباركة 1847 لتنتشر في مصر وسوريا وسائر الأقطار العربية. ويوسف أسعد داغر العالِم البيبلوغرافي، والذي وضع معجماً للمسرح العربي هو حتى اليوم الوحيد في مجاله، يؤكّد على ريادة لبنان في هذا الحقل. يقول في بحث مخصّص للمسرح اللبناني: “وهكذا سجّل عام 1848 [بالحري 1847] بدء نهضة أدبية ونقطة انطلاقٍ لحركة علمية فنّية، وانطلاقة جديدة في تطوّر فنون الأدب العربي الحديث، طلعت أوّل ما طلعت على العالم العربي، من لبنان، موئل العربية طوال عصر الانحطاط، يوم كان العثمانيّون يسيطرون على الأقطار العربية ويشدّون عليها الخناق. (…) وقد حمل لبنان مشعل النهضة الحديثة ولواء حركة البعث العلمي بما قدّمه للعربية ولبلدان الشرق العربي من مشاهير الكتّاب والأدباء” (داغر، الأصول، م. س، ص381).
اللبنانيون روّاد المسرح المصري
ولم تقتصر المسألة على مارون النقّاش رائد المسرح في العالم العربي، فابن أخته سليم هو من نشر هذا الفنّ في وادي النيل، وفي ذلك يقول داغر راوياً ومقيّماً هذه الظاهرة اللافتة: “توفّي مارون النقّاش سنة 1855 وهو لم يتجاوز الثامنة والثلاثين. غير أن ابن أخيه سليماً أخذ عنه أصول هذا الفنّ وتدرّب على يدَيه، وبواسطة سليم انتقل فنّ التمثيل من لبنان إلى وادي النيل، حيث كان مجال العمل أوسع وأرحب” (داغر، م. س، ص383).
كانت مصر، تحت حكم سلالة محمد علي باشا، بعيدة عن الرقابة العثمانية الثقيلة الوطء ما أتاح لها أن تكون ملجأً لكلّ المفكّرين والأدباء والقطر الذي شهد انبعاث النهضة العربية الحديثة. وكان للبنانيين الذين هاجروا إلى مصر مثل سليم النقّاش وغيره من الأدباء والمفكّرين دور رائد في هذا المجال. يتابع داغر مبيّناً دور اللبنانيين الطليعي في مجال المسرح المصري: “فكأن لبنان الذي غرس هذه الغرسة في الأدب العربي الحديث، لم يشأ أن يتخلّى عنها حتى تنمو أصولها، وتغرس في الأرض، وتؤتي ثمارها في أقطار الشرق العربي” (داغر، م. س، ص383).
وعن دور سليم النقّاش الريادي في تأسيس أوّل فرقة مسرحية في مصر مدعومة بجوقة موسيقية يروي داغر: “لم يقنع سليم النقّاش، وهو يعمل للمسرح في مصر، أن يعتمد على بعض أشخاصٍ هاوين أو متطوّعين، بل راح ينشئ في مصر الفرقة الأولى للتمثيل، يعضده كاتب لبناني مشهور هو أديب إسحق. (…) وأضاف سليم إلى فرقته التمثيلية جوقة موسيقية دخلها يوسف خيّاط (1876)” (داغر، م. س، ص383).
أوّليات الدور اللبناني في المسرح العربي
وبعد عرضٍ مستفيض وتحليل يلخّص داغر دور لبنان الطليعي في مجال المسرح العربي في الأوّليات التالية:
1-أوّل من أدخل فنّ المسرح الحديث إلى العالم العربي هو اللبناني مارون النقّاش عندما مثّل أوّل مسرحية له هي مسرحية البخيل.
2-أوّل من أدخل فنّ التمثيل والمسرح العربي إلى مصر هو سليم النقاش ابن أخي مارون نفسه.
3-أوّل من تخصّص بفنّ المسرح في العالم العربي المركيز دي فريج اللبناني، كما كان أوّل من تخصّص بفن المسرح، في مصر، هو اللبناني جورج أبيض.
4-أوّل فرقة تمثيلية نشأت في العالم العربي هي فرقة سليم نقاش في بيروت.
5-أوّل امرأة عملت في فنّ التمثيل محترفة هي أستير مويال اللبنانية.
6-أوّل فرقة حملت هذا الفنّ إلى شمالي أفريقيا (تونس) هي فرقة سليم نقّاش. (داغر، م. س، ص387).
أوّلياتٌ بالغة الأهمّية بلا ريب. بيد أنّها ليست موضع فخر واعتزازٍ وحسب، بل هي ترتّب مسؤوليّات جمّة على لبنان واللبنانيين في المحيط العربي. فأين لبنان اليوم من لبنان الأمس؟! وما هو موقعه في المسرح العربي؟!
كان لبنان مهد المسرح العربي ومسقط رأسه، فعساه لا يكون اللحد لهذا الفنّ كما تنبّأ مارون النقّاش، ممّا سيلي عرضه!
جلال خوري وموقعه في المسرح اللبناني
وزاوية “مبدعون من لبنان” في مجلّة الأمن/بيروت الآنفة الذكر كان بودّ المؤلّف أن يفتتحها بحوارٍ شاملٍ وفي العمق مع صديقه المخرج والكاتب جلال خوري (1934-2017)، بيد أن القدر سبقه وضرب ضربته وغيّب هذا المبدع قبل أن يبدأ الحوار!! فاستعاض الكاتب عنه بدراسةٍ موجزة عن هذا المسرحي المبدع أُتبعت بمجموعةٍ من المقالات عمّا وصله من نصوص مسرحيّاته، وهو لم يصله في الحقيقة سوى نذرٍ منها. والدراسة هذه تمّ توسيعها في هذا الكتاب، فأُلحقت بها تحليلات وروايات لم يتح للمؤلّف يومها أن يتوسّع في عرضها إمّا لعدم توفّر المصادر، أو لضيق الحيّز المخصّص لنشر الدراسة.
لِمَ خُصّ جلال خوري دون غيره من المسرحيين بمزيدٍ من عناية الباحث؟! قد يسأل سائل. لهذا “التخصيص” أسبابٌ عديدة أبرزها ثلاثة:
1-علاقة المؤلف الشخصية بجلال خوري والصداقة التي ربطته به وامتدّت لنحو 35 عاماً أتاحت له أن يعرف عنه ما لا يعرفه عن سائر زملائه، وأن يرافق ويشهد ولادة الكثير من إبداعاته المسرحية والفكرية، وأن يعاين خصوصاً هذه النقلة في مسرح جلال من السياسي إلى الصوفي، وخلفيّاتها وأسبابها. ودراسته هنا تأتي مزيجاً من تحليلٍ للنصّ الجلالي، وشهادة شاهد عيان.
2-وعى جلال خوري، ومنذ بدء نشاطه المسرحي، ما عانى منه المسرح اللبناني ولا يزال أي فقدان النصوص المسرحية، فحافظ على نصوصه، وصان أكثرها من الضياع، فنشرها بالطبع، ووضعها بالتالي بتصرّف محبّي المسرح والمهتمّين به. وكان المؤلّف من بين هؤلاء، وصلته بعض مسرحيّات جلال، واقتنى بعضها الآخر من السوق، وفاته بعضٌ ثالث لم يستطع تأمينه رغم جهوده الحثيثة في هذا المجال. والمهمّ أن ما توفّر بين يديه أمّن له المادّة الأساسية الخام لدراسته، في حين تعذّر عليه الحصول على نصوص مسرحيين كبار من روّاد النهضة المسرحية الثانية في لبنان أمثال منير أبو دبس (1932-2016)، وريمون جبارة (1/4/1935-14/4/2015) ما حال دون دراسته لمسرحهم. بل إن هذه الصعوبات التقنيّة جعلته في النهاية يُقلع عن إتمام بحثه في المسرح اللبناني، ويكتفي بما كتب، تاركاً لغيره من الدارسين مهمّة مواصلة البحث، متمنّياً لهم أن يكونوا أكثر حظّاً منه!
3-الأثر الهندوي البارز في المسرح الجلالي، لا سيما في الجانب الصوفي من هذا المسرح شجّعه على التوسّع في هذه الدراسة كجزءٍ من مشروع كبير باشره منذ أوّل أطروحة له، ألا وهو تتبّع الأثر الهندي أو أثر أديان الهند وفكرها وفلسفتها في الفكر العربي واللبناني. فأصدر سلسلة “أديان الهند وأثرها في المشرق وأرض الإسلام”
وقد ضمّت هذه السلسلة حتى الآن أربعة كتب:
واحد عن جبران خليل جبران([4]).
وثانٍ عن البيروني([5])،
وثالث عن ميخائيل نعيمه([6])،
ورابع عن كمال جنبلاط([7])
وهكذا تأتي دراسته للمسرح الصوفي عند جلال خوري حلقة من هذا المشروع.
ماذا الآن في دراسته للمسرح الجلالي من ميّزات؟
[1] -مارون النقاش (1817-1854): الرائد الأوّل للمسرح وفن التمثيل في العالم العربي. ولد في مدينة صيدا، ونشأ في بيروت، وفيها أتقن العربية، وحذق في علم الحساب ولا سيما التجاري منه. ثم رغِب في السفر، فرحل إلى حلب ودمشق والإسكندرية والقاهرة. وانتقل بعد ذلك إلى إيطاليا حيث اقتبس فنّ التمثيل. ولما عاد إلى بيروت كان قد أتقن اللغات التركية والإيطالية والفرنسية. فعُيّن رئيساً لكتابة الجمرك. بيد أنه استقال بعد فترة وانصرف إلى التجارة. وأثناء عمله جمع بعضاً من أصحابه، ولقّنهم مبادئ التمثيل، ووضع مسرحية البخيل وهي كوميديا غنائية من خمسة فصول، مثّلها في بيته 1947. فكان ذلك حدثاً تاريخيّاً في الشرق. ثم وضع مسرحيّته الثانية “أبو الحسن المغفّل وهارون الرشيد” وهي كوميديا ملحّنة من ثلاثة فصول مستوحاة من ألف ليلة وليلة، مُثّلت أولاً في بيته سنة 1849، ثم على مسرح خاص في حديقة منزله قدّم عليه مسرحيّته الثالثة “الحسود السليط”، 1951. يروي جرجي زيدان (14/12/1861-21/7/1914) عن عمل النقّاش الرائد: “ضمّ إليه جماعة من أصدقائه الشبّان النجباء، وأخذ يعلّمهم التمثيل، وألّف لهم رواية “البخيل” وهي أوّل رواية تمثيلية أُلّفت في اللغة العربية، فعلّمهم أدوارها ومثّلوها في بيته في ليلة حضرها قناصل المدينة وأعيانها، فأعجبوا بما شاهدوا من دقّة التمثيل وإتقان التأليف مع حداثة هذا الفنّ. فشاع خبر ذلك حتى تناقلته الصحف الإفرنجية. فزاد نشاطاً وإقداماً. فألّف رواية “أبي الحسن المغفّل”، مثّلها في بيته أيضاً (…) ودعا إليها والي سوريا، وبعض الوزراء ورجال الدولة، وكانوا يومها في بيروت، فأعجبوا به، وأثنوا على نشاطه. فلمّا تحقّق نجاح عمله أنشأ مسرحاً خاصّاً بالتمثيل، بجانب منزله، خارج باب السراي بفرمان سلطاني، وقد تحوّل بعد موته إلى كنيسة عملاً بوصيّته” (زيدان، جرجي، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، بيروت، دار مكتبة الحياة، د. ت، ج2، ص275). توفّي مارون النقّاش شابّاً وهو في سفرة إلى طرطوس 1855، فخسر المسرح بموته ركناً عزيزاً من أركانه. جمع شقيقه نقولا نقاش مسرحيّاته الثلاث في كتاب وأصدره بعنوان “أرزة لبنان”، بيروت، 1869، واستهلّه بمقدّمة ضافية عن سيرة مارون النقاش، وذيّله بمجموعة من منظوماته ومقطوعاته الشعرية.
[2] -يوسف أسعد داغر (1899-1981): عالِم بيبليوغرافي واسع الاطّلاع، وبحّاثة مدقّق من أعظم الاختصاصيين العرب في علم المكتبات. ولد في قرية مجدلونا/قضاء الشوف-لبنان. تلقّى دروسه الأولى في مسقط رأسه وتعلّم العربية والفرنسية والإنكليزية. وفي أيلول 1909 أُرسل إلى إكليريكية الصلاحية في القدس، فبقي فيها نحو عشر سنوات، وتخرّج منها بعد أن أتقن، إلى ما كان يجيده من لغات، اللاتينية واليونانية القديمة. بدأ حياته العملية بالتعليم في عددٍ من المدارس 1924-1929. وأرسل 1929-1931 في بعثة علمية للتخصّص بعلم المكتبات في باريس، إلى جانب علم المخطوطات وعلم التوثيق. ولمّا عاد إلى لبنان عُيّن أميناً مساعداً لدار الكتب الوطنية 1932-1950. وفي 1950-1951 انتُدب للعمل في الجامعة اللبنانية وإعداد قوائم لمكتبتها الناشئة. ثم دُعي 1951 لزيارة لندن وبريطانيا واطّلع على ثروات المكتبات في تلك البلاد، وعاد بنحو ثلاثة آلاف كتاب هدية للمكتبة الوطنية في لبنان. دُعي 1952 إلى الولايات المتحدة الأميركية فزار مكتبة الكونغرس، وعمل فيها زهاء سبعة أشهر، كما زار مكتبات عدد من الجامعات في تلك البلاد. وحصّل هناك لصالح المكتبة الوطنية ومكتبة الجامعة اللبنانية الناشئة ما لا يقلّ عن ألفين وخمسماية كتاب. وفي زيارة أخرى قام بها إلى المكسيك حصل أيضاً على مجموعات كتب بالإسبانية. عمل 1954 أميناً مساعداً في مكتبة الجامعة الأميركية. ومحرّراً في قسم الصحافة والأنباء في السفارة الأميركية في بيروت 1955-1962. وأمين مكتب المركز الإقليمي لتدريب كبار موظّفي التعليم في الدول العربية 1962-1966. وخبيراً من قبل الأونسكو لدى وزارة التربية والتعليم في السودان بمهمّة إنشاء مركز للتوثيق التربوي في الوزارة. كما عمل موثّقاً وخبيراً للبيبليوغرافيا لدى المعهد الألماني للأبحاث الشرقية/بيروت 1972-1975. من مؤلّفاته المطبوعة: 1-الشرق في الأدب الفرنسي بعد الحرب (1918-1932)، بالفرنسية، بيروت، 1937. 2-فهرس المكتبات في الشرق الأدنى، بالفرنسية، حريصا، مطبعة القديس بولس، 1951. 3-تقنية التوثيق العلمي وفقاً للقواعد المتّبعة (بالفرنسية)، باريس. 4-350 مصدراً في دراسة أبي العلاء المعرّي، بيروت، 1944. 5-الأدب المقارن، القصّة الروسيّة وأثرها في الأدب العربي، صيدا، 1946. 6-بولونيا في الماضي والحاضر، بيروت، 1947. 7-وجهاً لوجه مع الاتّحاد السوفياتي، لفلادمير بتشوفسكي، (ترجمة)، بيروت، 1948. 8-الدعاوى والنشر على ضوء علم النفس الحديث، حريصا، 1947. 9-فهارس المكتبة العربية في الخافقين، بيروت، 1947. 10-دليل الأعارب إلى علم الكتب وفن الكاتب، بيروت، 1948. 11-العذراء مريم في المكتبة العربية، بيروت، 1954. 12-إنهلِّي، رواية مترجمة لمؤلفها البولوني جول سلوفاتسكي، بيروت، دار الأحد، 1948. 13-الاغتراب والهجرة في المكتبة العربية، بيروت، 1953. 14-الديموقراطية في المكتبة العربية، بيروت، 1959. 15-هزيمة الشيوعية، ترجمة، 1951. 16-خواطر حول المؤتمر الثقافي الإسلامي-برنستون 1953، حريصا، 1954. 17-التوثيق التربوي، وزارة التربية/الخرطوم، 1967. 18-الأصول العربية للدراسات السودانية، بيروت، 1968. 19-محاضرات في علم المكتبات الحديث وفنّ تنظيمها، بيروت، 1963. 20-الأصول العربية للدراسات اللبنانية، بيروت، الجامعة اللبنانية، 1972. 21-مصادر الدراسة الأدبية، في 4 أجزاء، مطبعة دير المخلّص ومنشورات الجامعة اللبنانية،1950-1983. 22-قاموس الصحافة اللبنانية، بيروت، الجامعة اللبنانية، 1978. 23-تاريخ الحضارة العامّ، 7 مجلّدات، ترجمة بالاشتراك مع فريد ميخائيل داغر، بيروت، منشورات عويدات، 1963-1967. 24-فهارس تاريخ ابن خلدون، بيروت، دار الكتاب اللبناني. 25-فهارس كتاب مروج الذهب للمسعودي، بيروت، دار الأندلس. 25-معجم المسرحية العربية والمعرّبة. بغداد، منشورات وزارة الثقافة والفنون، 1978. 26-معجم الأسماء المستعارة وأصحابها، بيروت، مكتبة لبنان، 1982. 27-قاموس داغر، فرنسي عربي، بيروت، 2002. 28-يوسف أسعد داغر: مراحل حياته وآثاره الفكرية والأدبية، سيرة ذاتية، 1977. 29-له مقالات وأبحاث صدرت في عددٍ من المجلّات: الأديب، الثقافة، الحديث، الحكمة، العرفان، المشرق، الطريق، المسرّة، المكشوف، المعارف، النهار، وغيرها.
[3] -داغر، يوسف أسعد، الأصول العربية للدراسات اللبنانية: دليل بيبلوغرافي بالمراجع العربية المتعلّقة بتاريخ لبنان، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، ط1، 1972، ص389.
[4] -صليبا، د. لويس، أديان الهند وأثرها في جبران: قراءة جديدة لأدب نابغة المهجر، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2015، 386ص.
[5] -صليبا، د. لويس، اليوغا في الإسلام مع دراسة وتحقيق وتفسير لكتاب باتنجلِ الهندي للبيروني، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2020، 350ص.
[6] -صليبا، د. لويس، الهندوسية وأثرها في الفكر اللبناني دراسة في فكر ميخائيل نعيمه، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2018، 440ص.
[7] -صليبا، د. لويس، حوار الهندوسية والإسلام والبوذية: جنبلاط اليوغي وعلاقته بنعيمه والحايك، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط2، 2020، 500ص.
جلال خوري رائدٌ مُغفَل في الدراسات العربية
جلال خوري هو رائد المسرح السياسي، والمسرح الصوفي، والمسرح البرختي (أو البريشتي) في لبنان. وعن الجانب الأخير يقول عبيدو باشا: “يبقى جلال خوري طفل المسرح وهو على مشارف الثمانين. يبقى الرجل صاحب المساهمة الأبرز في تقديم بريشت إلى المسرح اللبناني والعربي، إلى المشاهد اللبناني والعربي” (عبيدو، هكذا، م. س، ص540).
ورغم ذلك نراه مهمّشاً مهملاً، بل مغفلاً، في الدراسات التي تناولت المسرح البرختي في العالم العربي.
الباحث السوري د. الرشيد بوشعير([1]) الذي درس مسرح بريخت في العالم العربي([2]) في أطروحة دكتوراه لا يأتي على ذكره سوى مرّة واحدةٍ ويتيمة في طول أطروحته وعرضها. وهو يخلطُ خلطاً عجيباً مؤسفاً عند ذكره له، فيقول: “أمّا في بيروت، فأكثر من عشر مسرحيّات اقتُبست عن بريخت وقُدّمت إلى الجمهور. منها السيد بونتيلا وتابعه ماتي التي أعطيت عنواناً آخر هو “جحا في القرى الأمامية”. وكلا هاتين المسرحيّتَين من اقتباس جلال خوري” (بوشعير، م. س، ص76).
أهي مسرحية واحدة أم مسرحيّتان؟ المسرحية التي اقتبسها جلال اقتباساً حرّاً عن “بونتيلا” لبريخت هي بالأحرى “سوق الفعالة” كما سيرد لاحقاً في ب1/ف1، أما “جحا في القرى الأمامية” فهي من تأليفه وليست اقتباساً. وقد عُرضت في مهرجان دمشق 1972، كما سيرد في ب1/ف1، وأثارت عاصفة من النقد يومها. فكان على الباحث د. الرشيد بوشعير أقلّه أن يتحرّى عن ذلك، ويدقّق في ما سيكتب!
أمّا د. جميل حمداوي([3]) أستاذ الأدب المسرحي في تطوان/المغرب، فهو في دراسته عن تأثير بريشت في المسرح العربي([4]) الصادرة مؤخّراً لا يأتي بتاتاً على ذكر جلال خوري. وفي الفصل المخصّص لأثر بريخت في المسرح اللبناني (حمداوي، م. س، ف2: مسرح الحكواتي والتغريب البريشتي، ص28-39). يكتفي بتناول مسرح الحكواتي لروجيه عسّاف!!
وما هذه سوى نماذج معبّرة للإهمال وعدم الاكتراث المتعمّد الذي يتعرّض له الإبداع اللبناني فكراً وفنّاً وأدباً من الجانب العربي!!
ويركّز ب1/ف1 خصوصاً على مسار جلال خوري من الماركسية إلى اليوغا: خلفية ذلك، والصداقة التي جمعته بروبير كفوري أبرز دارس ومعرّب للتراث الهندي والسنسكريتي في لبنان والعالم العربي. وكان لهذه النقلة الجلالية أن تنعكس على المسرح. فالمسرحيّات الخمس الأخيرة ذات طابع صوفي وهندوي واضح. ويتوسّع ب1/ف1 بدراسة رحلة مُحتار إلى شري نغار ويبيّن أثر التأمّل التجاوزي فيها. أمّا خدني بحلمك مستر فرويد فتحمل طابع سيرة ذاتية لكاتبها. وفيها يحمّل التوحيد والذي بدأ مع أخناتون وزر التكفير والإرهاب الديني الذي استشرى منذ بداية الألفية الثالثة. فالتوحيد من منظورٍ جلالي هو دكتاتورية الإله الواحد، وهو الذي زرع بذور التكفير الذي قاد إلى الإرهاب والتفجير.
و”هندية راهبة العشق” تُعيد الاعتبار إلى راهبة متصوّفة لبنانية اضطُهدت في زمنها، وتناقضت فيها الأحكام والمواقف بين قدّيسة ومشعوذة.
والفصل الثاني (ب1/ف2) يدرس مسرحيّاً طليعيّاً آخر “يعقوب الشدراوي رائد المسرح التجريبي في لبنان“. وإذا كان جلال خوري من مدرسة بريخت، فالشدراوي هو بالأحرى على مذهب ستانسلافسكي في المسرح مفهوماً وإخراجاً. وهذا الفصل يسلّط أضواءً على سيرته وخصوصاً على نتاجه المسرحي. ويتوقّف ليقارن بينه وبين زميله جلال خوري. ثم يتوسّع في دراسة واحدة من مسرحيّاته هي بالحري النصّ الوحيد الذي وصل للمؤلّف من نتاج هذا المسرحيّ المبدع. إنها مسرحية “ميخائيل نعيمه“. وقد برع الشدراوي في تصوير تناقضات ناسك الشخروب، وفي تظهير المواجهة بينه وبين جبران خليل جبران، رغم أن المسرحية هي في الأساس جزء من مهرجان تكريمي لنعيمه وتحمل طابع هذا المهرجان. وقد أحسن الشدراوي فعلاً تكريم نعيمه مظهراً ميّزات أدبه وفكره المسكوني، ولكن دون أن يتغاضى عن بعض الثغرات والهنّات في عمارته الأدبية ومسيرته الفكرية. وهكذا يكون التكريم الحقّ، فهو ليس مجرّد تبخير كما يفهمه الكثيرون ويمارسوه.
والفصل الثالث (ب1/ف3) يتناول رائداً مسرحيّاً آخر. إنه “شكيب خوري رائد الطقوسية في المسرح اللبناني“. ولمّا كان هذا المسرحي لا يزال حيّاً يرزق آثر المؤلف أن يحاوره في مسرحه ومفهومه له ورؤياه. وأتبع هذا الحوار بدراسة موجزة عن المسرح الشكيبي، ومفهومه الخاصّ للإخراج والذي يعتبره تحويلاً مستمرّاً للنصّ. وتناول مسرح النخبة الذي كان رهان شكيب خوري منذ بداياته، وتفحّص مدى نجاحه في هذا الرهان. ثم قيّم الطابع الطقوسي في هذا المسرح، مورداً رأي عددٍ من النقّاد العرب في الطقوسية الشكيبية وموقعها في المسرح اللبناني والعربي عموماً. وآخر مبحث في هذا الفصل دراسة موجزة لأحد مؤلّفات شكيب خوري.
واستكمالاً للمشهد المسرحي اللبناني أجرى المؤلّف حواراً مع أحد أبرز دارسيه ومؤرّخيه صديقه د. نبيل أبو مراد. ونقل وقائع هذا الحوار في الفصل الأول من الباب الثاني (ب2/ف1). ناقشه في آرائه في مسرح الأخوين رحباني ومسرح زياد الرحباني، وفي التراث المسرحي اللبناني لا سيما في حقبته الأولى 1847-1960. ودوره في حفظ الكثير من نفائس هذا التراث ونشرها ودراستها.
ويدرس ب2/ف1 عدداً من مؤلّفات د. أبو مراد وتحقيقاته. لا سيما موسوعته التي أرّخ فيها للمسرح اللبناني، وهي عملٌ ميداني وأرشيفي قيّم، وكان من أبرز مراجع هذا الكتاب ودراساته. كما يتناول نماذج من دراسات أبو مراد وتحقيقاته لمسرحّيات لبنانية مثل مسرحيّات الأب أبي هيلا والحدّاد وغيرهما.
والفصل الثاني(ب2/ف2) “منى طايع من التمثيل إلى كتابة الدراما“، يتناول نموذجاً ناجحاً في كتابة الدراما للشاشة الصغيرة. فيحاور الكاتبة منى طايع في تجربتها ونقلتها من التمثيل إلى التأليف. ويعالج الحوار واقع الدراما التلفزيونية في لبنان: تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً، وموقعها في العالم العربي. ويتطرّق كذلك إلى دور المرأة في مختلف مجالات الدراما ومدى حضورها ومساهمتها فيها، والذكورية التي لمّا تزل مؤثّرة بل وفاعلة في هذه المجالات. ليخلص إلى تقييم عام للحداثة في المجال الإعلامي وخصوصاً التلفزيوني والتي لا مفرّ من الدخول فيها.
والفصل الثالث (ب2/ف3): “الأخت مارانا سعد” يحاور راهبة شابّة في مسيرتها الناجحة في الموسيقى والمسرح والغناء، وفي التدريس الموسيقي والجامعي. ويتطرّق إلى الفولكلور اللبناني ومدى تأثّره بالتراث السرياني، وكذلك إلى الموسيقى الدينية والتراتيل. ليختم بأن الفنّ ليس إغراءً ولا نرجسيّة مهما وسمه بعض هواته وممارسيه بهذا الطابع.
فقدان النصوص يعيق دراسة المسرح اللبناني
ولا يزعم المؤلّف، كاتب هذه السطور أنّه استوفى في هذا المصنّف دراسة المسرح اللبناني في حقبته الثانية والتي بدأت منذ 1960. وكان بودّه، كما أشار في هذه المقدّمة، وفي أكثر من فصل من هذا الكتاب، أن يدرس روّاداً آخرين أمثال منير أبو دبس (1932-تمّوز2016) والذي افتتح إثر عودته إلى لبنان 1960 الحقبة الثانية والمعاصرة من تاريخ المسرح اللبناني. وزميله ريمون جبارة (1/4/1935-14/4/2015) وأنطوان ملتقى (1933-…) وغيرهم. بيد أنّه رأى، وبعد طول تفكّر وتبصّر، أن حظوظه في أن يقول شيئاً جديداً في الموضوع ضعيفة، وذلك لأسباب عديدة أبرزها عدم توفّر النصوص كما سبق أن ذُكر في هذه المقدّمة. وهي مسألة تستحقّ أن تُعرض بشيء من التفصيل. ومن أوائل من عُني بالتأريخ للمسرح اللبناني في نهضته الثانية الباحث المصري د. علي الراعي([5]). كتب مصنّفه، كما يشير في المقدّمة، إبّان استعار حرب لبنان 1977. وشكى عدم توفّر النصوص بين يديه. وممّا قال: “فيما تقدّم من معلومات عن المسرح اللبناني الحديث اعتمدتُ كلّية على (…) بعض البحوث ومقالات الصحف والمجلّات، وذلك لغياب أيّة مصادر أخرى عن المسرح اللبناني. ونظراً لأن أحداث لبنان الدامية قد حالت دون حصولي على المسرحيّات التي ورد ذكرها في هذا الفصل حتى أتولّاها بالدراسة. (…) وهكذا فضّلتُ أن أعتمد على الغير بدلاً من أن أهمل المسرح اللبناني كلّية، وهو إهمال يمكن أن يحاسَب عليه المؤلّف، أي مؤلّف، حساباً عسيراً، نظراً لأهمّية ما دار في الساحة اللبنانية وخاصّة منذ السبعينات. وكلّي أمل، مع ذلك، في أن أنجح في توفير النصوص في وقتٍ مناسب”([6])
بيد أن آمال الراعي في الحصول على نصوص المسرحيّات تبدّدت، لأنّها، على الأرجح، ضائعة أو غير متوفّرة.
المسرحيّون لم يطبعوا ودور النشر لم تهتمّ
ويوضح دارس المسرح اللبناني ومؤرّخه د. نبيل أبو مراد هذه الإشكالية تحت عنوان عدم وجود نصوص مسرحية مطبوعة، فيقول ما يلي: “المسرحيّون اللبنانيّون الحديثون لم يطبعوا مؤلّفاتهم أو ترجماتهم، وذلك لأسباب تجارية في جوهرها وخارجة عن إرادتهم، إذ كانت دور النشر تستنكف عن ذلك لأن المسرحيّات المكتوبة باللغة العامّية اللبنانية لن تجد لها أسواقاً في العالم العربي، فضلاً عن أن قرّاء المسرح قلائل” (أبو مراد، المسرح، م. س، ص27).
الناشرون اللبنانيون لم يهتمّوا، ولا المسرحيّون طبعوا على حسابهم، وحده جلال خوري كما ذُكر آنفاً غامر وطبع. بل إن بعضاً من المؤلّفين والمخرجين لم يهتمّ بالحفاظ على ما كتب وصونه من الضياع. يشهد المؤلّف والمخرج ريمون جبارة قائلاً: “ومن المسرح أيضاً لا أنتظر شيئاً، حتى إني لا أعرف إذا كان ما كتبته ما زال محفوظاً في التخشيبة في بيتنا أم لا”([7])
أما النتيجة فضياعٌ لتراثٍ نفيس، وغيابٌ للبحوث والدراسات في هذا المجال. وفي ذلك يقول أبو مراد متابعاً: “ولا ندري ما سيفعله الباحثون في المسرح اللبناني مستقبلاً عندما يودّون دراسة هذه الحقبة من تاريخ المسرح إذا بقيت هذه النصوص من دون طباعة أو نشر، وكان مصيرها الضياع” (م. ن)
مذبحة للتراث المسرحي يشارك فيها الجميع
والمصير الأسود الذي تخوّف منه أبو مراد وحذّر، هو تحديداً ما حصل ويحصل اليوم وكلّ يوم!! ومحمّد كريّم([8]) الذي أرّخ للمسرح اللبناني في النصف الأوّل من القرن العشرين يشكو من المعضلة إيّاها. يقول في مقدّمة كتابه القيّم: “وممّا زاد البحث صعوبة عدم توفّر النصوص التي قُدّمت في تلك الفترة [1900-1950]. صحيح أن بعض هذه المسرحيّات قد طُبع، إلا أن كثيراً منها، وخصوصاً المسرحيّات التي لعبتها الفرق التي سوف نتحدّث عنها، مفقود تماماً. فقد كانت هذه المسرحيّات تُكتب بخطّ اليد: نسخة لمنسّق العمل الذي يكون عادة المؤلّف، وفي حال وجود كاتب ومنسّق فثمة نسختان واحدة لكلّ منهما. أما الممثّلون فكان كلّ منهم يكتب دوره بخطّ يده على دفتر خاصّ، ثم يهمله، أو يتلفه في أغلب الأحيان بعد تقديم المسرحية. وهكذا ضاع كمٌّ كبير من التراث المسرحي كان يمكن أن يُعتمد عليه في عملية التقويم”([9])
واضحٌ من كلام كريّم المنبثق عن معاناة واقعية أن المسألة لا تقتصر على إهمال الدولة والقطاع العام في هذا المجال. فليس في لبنان من تنشئة ولا ثقافة ولا اهتمام على الصعيد الفردي والشخصي بصون التراث وحفظه. وهو يتابع موجّهاً أصابع الاتّهام إلى المدارس والمؤسّسات التربوية المفترض أن تكون حصناً حصيناً لحفظ التراث، فإذا بها تضيّع حتى إرثها الخاص، يقول: “أما بالنسبة للنشاطات المسرحية في المدارس، فإن معظم المدارس التي تمّ الاتّصال بها بطريقةٍ أو بأخرى، أفادت بأن محفوظاتها وسجلّاتها قد ضاعت أو أُتلفت خلال الحرب اللبنانية، حتى إن بعض الإدارات نفت علمها بوجود مثل هذا النشاط في مدارسها، ثم اتّضح لنا بأن هذه المدارس كان لها نشاط مسرحي مميّز في آخر كلّ عامٍ دراسي” (كريّم، م. س، ص21).
أفلا تكفي هذه الشهادة العيانية دلالة على فداحة الكارثة، بل المذبحة التراثية التي يتآزر على اقترافها القطاع الخاصّ بمؤسّساته التربوية وغيرها، والقطاع العام، بل وحتى الأفراد كذلك؟!
تجربة مريرة في مجال حفظ التراث
وكانت لكاتب هذه السطور تجربة مريرة في هذا المجال. إذ بقي شهوراً طويلة يلاحق ويتابع أهل وورثة بعضاً مِن أبرز مَن درسهم في هذا الكتاب بغية الحصول على نصٍّ مسرحي مطبوع أو أكثر لتحليله والتوسّع في الدراسة. ولم يكن نصيبه في النهاية سوى وعود عرقوبيّة لم تتجسّد واقعاً. وكل ما توفّر له كان حصراً بجهده الخاصّ أو بماله!!
وتجربة ثانية مؤلمة للمؤلّف، فخلال حوارٍ له مع صديقة جمعتهما زمالة منذ دراستهما في كلّية الإعلام والتوثيق (الفرع الثاني/الفنار)/ الجامعة اللبنانية في الثمانينات، شكى لها ما يلقى من صعوبات في أيجاد مصادر وموادّ لدراسة المسرح اللبناني المعاصر. فأفادته أنّها خلال عملها محرّرة ومحقّقة في القسم الثقافي من جريدة لبنانية احتجبت منذ نحو عقدَين أجرت مقابلات في التسعينات مع روّاد المسرح اللبناني أمثال جلال خوري ومنير أبو دبس وغيرهما، ونشرتها في تلك الجريدة. وعندما طلب منها نصوص هذه الحوارات أجابت أنّها لم تحتفظٍ بأيّ منها!! ويا لفداحة الخسارة!! فحتى الكاتب لا يبذل جهداً لحفظ ما كتب وصونه من الضياع!!
وتجربة ثالثة مُرّة وأخيرة للمؤلّف، والشيء بالشيّء يذكر، فعندما كان طالباً في كلّية الإعلام والتوثيق عينها كتب مقالة نُشرت في المجلّة الصادرة عن طلّاب الكلّية عام 1982، واحتفظ بمسودّة هذه المقالة ومخطوطتها. وعندما كان بصدد جمع مقالاته وكتاباته الأولى لإصدار مختارات منها ضمن كتاب هو بمثابة سيرة فكرية له([10]) رغب في العودة إلى العدد من المجلّة الطلّابية التي نَشرت تلك المقالة لتوثيقها والمقارنة بين مخطوطته وما نشر فيها، وبعد اتّصالات عديدة بالكلّية، وبمكتبتها وبحافظة المكتبة وزيارات أجريت أواخر سنة 2010 وقبل نشر الكتاب المذكور في الهامش أفادته المسؤولة أن مكتبة الكلّية قامت بإتلاف أعداد هذه المجلّة بإيعاز من الأساتذة لضيق المكان، وكي لا تتيح للطلّاب الجدد أن ينقلوا عن القدامى Plagia كما زعمت نقلاً عن هؤلاء الأساتذة!! فإذا كانت كلّية الإعلام والتوثيق التي يفترض فيها أن تعلّم طلّابها أرشفة الوثائق وحفظها، لا تحفظ وثائقها هي ولا تكترث بها وتتلفها، أي تتلف تراثها وإرثها وتاريخها وكتابات الطلّاب الذين درسوا وكتبوا على مقاعدها، وأكثرهم اليوم من كبار الإعلاميين في البلد، فهل من عتبٍ بعد على الآخرين من دولة وقطاعٍ عامّ أو خاصّ!! وهذا ما يذكّر بقولةٍ مشهورةٍ للصوفي أبي يزيد البسطامي: “أكثر الناس إشارة إليه [الحقّ]، هم أكثرهم بعداً عنه”([11])
لكأنّه مكتوب على هذا البلد أن يبقى “حاميها حراميها”([12]) كما يقول المثل اللبناني المرّ والمعبّر.
وما هذه سوى صورٍ ونماذج واقعية عن معاناةٍ مستمرّة غالباً ما يقع ضحيّتها من يحاول جمع التراث في هذا الوطن التعيس!
فإذا كان أهل المبدع الراحل في لبنان لا يعبأون بالحفاظ على تراثه ونشره وتشجيع الاطّلاع عليه ودراسته، فهل من عتبٍ بعدها على الدولة في تقصيرها في هذا المجال؟! فحالة التراخي وعدم الاكتراث والاستلشاق سائدة هي على كلّ المستويات!
وصرخة المُخرجة نضال الأشقر في الاحتفال التكريمي لجلال خوري تعبّر عن وجعٍ ومعاناةٍ مُرّة، ولا سيما في مجال صون التراث المسرحي اللبناني: “ليس هناك إرث في لبنان. ما من شيء يبقى. (…) يمكنك أن تعتبرنا جهلة ونزرع الجهل في لبنان. للأسف ماذا سيحصل لهذا الإرث في لبنان”([13])
[1] -الرشيد بوشعير: باحث وناقد سوري، وأستاذ الأدب الحديث والأدب المقارن في جامعة الإمارات العربية المتّحدة. من مؤلّفاته: 1-الواقعية في أدب يوسف إدريس، أطروحة بإشراف د. أحمد سليمان الأحمد (1926-1993)، دمشق، 1979-1980. 2-دراسات في القصّة القصيرة: مقاربات في الرؤية والشكل، دمشق، 1995. 3-دراسات في الرواية العربية، دمشق، 1995. 4-المرأة في أدب توفيق الحكيم، دمشق، 1996. 5-الشعر العربي الحديث في منطقة الخليج: عوامل تطوّره اتّجاهاته وقضاياه، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1997. 6-مدخل إلى القصّة القصيرة الإماراتية، الشارقة، 1998. 7-أثر غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية، دمشق. 8-أدب الخليج العربي الحديث والمعاصر، الإمارات، دار العلم العربي للنشر، 2011. 9-مساءلة النصّ الروائي في السرديّات العربية الخليجية المعاصرة، أبو ظبي، 2010. 10-هواجس الرواية الخليجية، دبي، 2012. 11-الخطاب البيتي في الثقافة الكلاسيكية والمعاصرة: الأدب نموذجاً، الشارقة، 2012. 12-العلاقة بين الأدب والفنون الأخرى، الشارقة 2013. 13-منهج الميتاسرد في الرواية الخليجية وبحوث أخرى، الإمارات، 2017.
[2] -بوشعير، الرشيد، أثر برتولد بريخت في مسرح المشرق العربي، أطروحة دكتوراه بإشراف د. حسام الخطيب، دمشق، جامعة دمشق/كلّية الآداب، 1983، 386ص.
[3] -جميل حمداوي: باحث مغربي ولد في 8/11/1963 في مدينة الناظور/المغرب. حصل على إجازة في الأدب العربي من كلية الآداب/وجدة 1990. وإجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة القرويين، 1998. ودبلوم دراسات عليا من جامعة تطوان، 1996. ودكتوراه في الأدب العربي الحديث، من جامعة محمد الأوّل، 2001. من مؤلّفاته: 1-منهج القرائن في تدريس النحو العربي، الكويت، 1996. 2-مقاربة بنيوية سردية لرواية أوراق لعبدالله العروي، المغرب، 1996. 3-مقاربة النصّ الموازي في رواية الريح الشتوية لمبارك ربيع، المغرب، 1996. 4-قراءة في مسرحية شهرزاد لتوفيق الحكيم، المغرب، 1997. 5-بنية الزمان في رواية بداية ونهاية لنجيب محفوظ، المغرب، 1996.
[4] -حمداوي، جميل، بريشت وتأثيره في المسرح العربي، تطوان/المغرب، دار الريف، ط1، 2020. 114ص.
[5] -علي الراعي (1920-1999): ولد في محافظة الإسماعيلية في مصر. تخرّج من قسم اللغة الإنكليزية في جامعة القاهرة 1943. ثم تابع دراسته في جامعة برمنغهام في إنكلترا فنال شهادة الدكتوراه 1955 عن أطروحته “مسرح برنارد شو”. عمل مذيعاً ومخرجاً إذاعيّاً في الإذاعة المصرية 1943-1951. كما عمل لعدّة سنوات محرّراً أدبيّاً لصحيفة المساء القاهرية، ورئيساً لتحرير مجلّة المجلّة الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، وترأس مؤسّسة المسرح والموسيقى في هذه الوزارة. عمل أستاذاً لمادّة الأدب المسرحي المعاصر في جامعة عين شمس ومعاهد أكاديمية الفنون في القاهرة، ثم أستاذاً للأدب المسرحي في جامعة الكويت 1973-1982. وعاد إلى مصر 1982 فكتب في مجلّة روز اليوسف، ثم في مجلة المصوّر، ففي جريدة الأهرام. شارك في عددٍ من المؤتمرات والمهرجانات المسرحية الدولية مثل: مهرجان بوخارست 1958، و1962. مؤتمر طوكيو، 1963، مؤتمر دلهي، 1966، مؤتمر بيروت، 1967 و1970، وهي مؤتمرات عُقدت بإشراف الأونسكو. من مؤلّفاته وصدرت كلّها في القاهرة: 1-فن المسرحية، 1959. 2-الكوميديا المرتجلة، 1968. 3-توفيق الحكيم، 1968. 4-فنون الكوميديا من خيال الظلّ إلى نجيب الريحاني، 1971. 5-مسرح الدمّ والدموع، 1973. 6-مسرحيّات ومسرحيّون، 1970. 7-دراسات في الرواية المصرية، 1964. 8-الرواية في الوطن العربي، 1992. 9-شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية، 1985.
[6] -الراعي، د. علي، المسرح في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، منشورات المجلس الوطني للثقافة، ط1، كانون الثاني 1980، ص237-238.
[7] -كامبل، الأب روبرت اليسوعي، أعلام الأدب العربي المعاصر: سيَر وسيَر ذاتيّة، بيروت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، ط1، 1996، ج1، ص415.
[8] -محمّد كريّم: كاتب ومخرج مسرحي لبناني. مؤسّس ومدير إذاعة صوت الوطن التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت 1984-2000. أستاذ محاضر في كلّية الإعلام والتوثيق، ومعهد الفنون في الجامعة اللبنانية. رئيس سابق لدائرة البرامج في الإذاعة اللبنانية. رئيس سابق للمركز اللبناني للمسرح التابع للمؤسّسة الدولية للمسرح (الأونسكو). حائز على وسام الاستحقاق اللبناني. صدرت له الكتب التالية: 1-المسرح اللبناني في نصف قرن: 1900-1950، بيروت، دار المقاصد، 2000. 2-في البال يا بيروت، 2005. 3-اللحن الثائر: سيرة الأخوين فليفل ودورهما في النهضة الموسيقية اللبنانية، 2014. 4-كما عرفتهم: محمد شامل (1909-1999)، عمر الزعني (1895-1961)، توفيق الباشا (1924-2005)، حسن علاء الدين: شوشو (1939-1975)، بيروت، دار نلسن، 2015.
[9] -كريّم، محمد، المسرح اللبناني في نصف قرن 1900-1950، تقديم د. فاروق سعد، بيروت، دار المقاصد، ط1، 2000، ص20.
[10] -صليبا، د. لويس، الديانات الإبراهيمية بين العنف والجدل والحوار مع بحوث في التصوّفَين الإسلامي والهندوسي، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2019، نشرت المقالة المذكورة ص264-267.
[11] -صليبا، د. لويس، إشارات شطحات ورحيل: أناشيد ومختارات صوفية مع أبرز شطحات البسطامي والحلّاج ولوحات لعددٍ منها ودراسة لها، تقديم المستشرق بيير لوري، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2013، ص40.
[12] -Freyha, Anis, A Dictionary of Modern Lebanese Proverbs: collated, annotated and translated into English, Beirut, Librairie du Liban, 1974, p253, No1329.
[13] -بو جابر، جوزف، نضال الأشقر وآخرون استذكروا جلال خوري المعلّم، مقالة على موقع الفن وضعت بتاريخ السبت 1/12/2018.
روّاد ومغيّبون!!
وتبقى كلمة عامّة في الروّاد المسرحيين الثلاثة الذين دُرسوا في هذا المصنّف: رائد المسرح السياسي والصوفي، ورائد المسرح التجريبي، ورائد المسرح الطقوسي. فكثيراً ما نجدهم مغيّبين في عدد من المصنّفات. وفي ما يلي مثل على ذلك. فالدكتور كمال ديب([1]) الذي يزعم كتابة “تاريخ لبنان الثقافي من عصر النهضة إلى القرن الحادي والعشرين”([2]) يخصّ المسرح اللبناني بفصلين من كتابه في أكثر من ستين صفحة (ص327-392). وهو لا يأتي على ذكر جلال خوري إلا في معرض حديثه عن آخرين، وبصورة عابرة لا تتخطّى مجموع كلماتها السطر الواحد. فيخطئ في المرّة الأولى في عنوان المسرحية، وجُلّ ما يقوله: “جلال خوري “جحا في الحدود [القرى] الأمامية” (ديب، م. س، ص330). وفي الثانية يذكر “جلال خوري في مسرحية أورتورو أوي” (ديب، م. س، ص389).
ولا يذكر شكيب خوري سوى مرّة واحدة مع عنوانٍ مبتور لمسرحيّته: “مع شكيب خوري في “غودو” [في انتظار غودو] (ص389).
والشدراوي يذكره مرّة واحدة ويتيمة في معرض حديثه عن شوشو: “حيث تدرّب شوشو مع يعقوب شدراوي [الشدراوي] والفرقة” (ص346).
أما ذكره لريمون جبارة وعنوان مسرحيّته فيأتي عجيباً غريباً: “قدّم ريمون جبارة لطمات [لِتَمُتْ] دزدمونة 1970” (ديب، م. س، ص330).
فأي تاريخ ثقافي هذا؟ بل أية انتقائية، أو بالأصح إقصائية هذه؟!
والخلاصة اكتفى المؤلّف، كاتب هذه السطور، بدراسة تجارب مسرحية لثلاثة روّاد لبنانيين، إضافة إلى استطلاع رأي مؤرّخ لهذا المسرح ومحاورة كاتبة دراما. وجلّ ما يتمنّاه أن تكون مساهمته المتواضعة هذه خطوة جدّية في الطريق لتأريخٍ وافٍ للمسرح اللبناني وصون تراثه النفيس من الضياع.
مصادر ثلاثة لدراسة المسرح اللبناني
ولا بدّ من كلمة موجزة عن المصادر التي استقى منها الكاتب بحوثه، ولا سيما في مجال المسرح. وهي تكاد تنحصر في أعمالٍ موسوعية ثلاثة هي التالية مرتّبة بحسب تسلسل صدورها زمنياً: 1-خالدة السعيد “الحركة المسرحية في لبنان([3])، 2-نبيل أبو مراد: “المسرح اللبناني في القرن العشرين”([4]) 3-عبيدو باشا: “هكذا”([5])
كتاب أبو مراد تناوله المؤلف بالتحليل والتقييم والتنويه في ب2/ف1، فلا مبرّر للتكرار هنا.
كتاب خالدة سعيد حجر زاوية في تاريخ المسرح
وكتاب خالدة سعيد([6]) وهي أستاذة المؤلّف في الجامعة اللبنانية/كلية الآداب، عملٌ موسوعي قيّم، وأكاديمية مؤلّفته لا غبار عليها. فهي تحيط بموضوعها من كلّ جوانبه، تتقصّى وتتحرّى وتفتّش وتستقصي وتتسقّط الأخبار من منابعها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. ولا تهمل تفصيلاً أو مقالة أو معلومة من شأنها أن تسلّط ضوءاً على موضوعها. وهي لا توفّر مجهوداً أرشيفياً أو ميدانيّاً إلا وتبذله كي تنجز عملها على أكمل وجهٍ ممكن. وكتابها الموسوعي الموثّق هذا هو بلا ريب حجر زاوية في مكتبة المسرح اللبناني تاريخاً وبحوثاً ومصادر ونصوصاً.
وعن تأليفها لهذا الكتاب، ومن كلّفها بذلك تقول خالدة سعيد: ” كنتُ، منذ ستينيات القرن العشرين، أتابع المرحلة الحديثة في المسرح اللبناني. وفي السبعينيات بدأت أكتب عن أقطاب فيها، بل كنتُ أُعدّ كتاباً حول المسرح، عندما كلّفتني لجنة مهرجانات بعلبك الدوليّة، بشخص السيدة الراحلة سعاد نجار، كتابة بحث حول المسرح الذي رَعَتْه، وما كان يمكن أن أُقصِر البحث حول مسرح المهرجانات وحده. وهكذا، شملت الدراسة كل ما عُرِف بالمسرح الحديث”([7]).
أمّا عن طريقتها في جمع المعلومات والعمل الميداني فتقول خالدة سعيد في مقابلة أخرى: “كتابي عن المسرح اللبناني أعطاني فرصة عظيمة للاقتراب من الفنّانين المسرحيين. حاورتهم ودرستُ أعمالهم، وتكرّموا عليّ بملفّاتهم وذكرياتهم وتحدّثوا عن تجاربهم. كان المشروع في البداية أقلّ أو أبسط ممّا صار عليه بفضل غزارة المعلومات وغنى التجربة وعمقها، أي بفضل المسرحيين. فقد تعاونوا بحماسة شرّفَتْني حقّاً. وأسعدني صدور هذا الكتاب قبل وفاة بعض سيدات المهرجان ولا سيما سعاد نجار وجانين ربـــيز. وأنا في الحقيقة اغتنمتُ الفرصة لأعمّق الموضوع، فلا يأتي إخباريّاً، وطالبتُ بالمهلة بعد المهلة، واستغرقتُ سنوات حتى بات النّصّ مُرْضِياً لهيامي بالمسرح والحركات الفنية وبلبنان”([8]).
وتقول الناقدة يمنى العيد في تقييم لعمل أستاذتها خالدة سعيد الموسوعي هذا: ” هي خالدة أخيراً وليس آخراً التي أنجزت موسوعتها الضخمة والقيّمة «الحركة المسرحيّة في لبنان 1960-1975»، والتي قدّمتْ فيها معرفة موثّقة ودقيقة بالمسرح وهويّته، كما بالمسرحيّين ممثلين ومخرجين، بمبدعي النصوص وناقليها إلى العربيّة، بالمسار وعناء تحقيق الأماني والأحلام… أي ما يشكّل مرجعاً، لا غنى عنه، لكل باحث أو طالب معرفة بما قدمه المسرح والمسرحيون في لبنان فترة تأسيسه ونهوضه”([9]).
مناقشة بعض المآخذ على كتاب خالدة سعيد
في حين سجّل بعض الباحثين والنقّاد مآخذ على هذا العمل التوثيقي والتحليلي الضخم، وليس الأمر بمستغرب، فالكمال لله كما يقولون. ولا تتيح حدود هذا البحث عرض كل هذه النقود ومناقشتها، لذا يكتفي المؤلّف بما ساقه د. كمال ديب في كتابه الآنف الذكر من مآخذ على عمل د. سعيد. يقول ديب في مستهلّ حديثه عن المسرح اللبناني الذي خصّه بفصلين طويلين: “حتى أن كتاباً ظهر لخالدة السعيد [سعيد] بمنحة من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية من 700 ص عن المسرح اللبناني م 1960 إلى 1975 (وهي الفترة التي ظهرت فيها معظم أعمال الرحباني) لم يُشر إلى مسرح الرحابنة إلا قليلاً وبشكل عابر رغم أنه كان الأبرز في تلك الفترة. واكتفت خالدة السعيد [سعيد] بالقول إن الأعمال الفولكلورية التي قدّمها الرحابنة في مهرجانات بعلبك “يمكن اعتبارها خطوة أولى نحو تطوير مسرح محلّي لبناني” لا أكثر ولا أقلّ. وأضافت أن ثمّة ميّزاتٍ لمسرح الرحابنة هي خارج مهام النقد المسرحي الجاد، وتحتاج معالجتها النقدية إلى كتابٍ آخر” (ديب، م. س، ص329).
فهل يصحّ اعتبار تحاشي خالدة سعيد الغوص في دراسة المسرح الرحباني وتحليله مأخذاً على كتابها؟!
طالما أنها أشارت بوضوح إلى هذا المسرح، ونوّهت بدوره في تطوير مسرحٍ محلّي لبناني، وبرّرت إحجامها عن الغوص في دراسته وتحليله تاركة ذلك إلى كتابٍ أو بحثٍ مستقلٍّ، فهي معذورة، لا سيما وأن الدراسات عن المسرح الرحباني كانت في أيّامها ولا تزال متوفّرة ومتعدّدة. فخيارها على أن تركّز على جوانب ومؤلّفين ومسرحيين وفنّانين آخرين لم ينالوا بعد حقّهم من الدراسة يصعب الطعن فيه. وجديرٌ بالذكر هنا أن خالدة سعيد أتت على ذكر عاصي ومنصور الرحباني في كتابها هذا نحو ثلاثين مرّة كما تبيّن للمؤلّف في عملٍ إحصائي أوّلي، ما يؤكّد أن لا نيّة عندها بتاتاً في إغفالهما. في حين أن ما يلومها عليه د. كمال ديب هو تحديداً ما فعله هو مع جلال خوري ويعقوب الشدراوي وشكيب خوري كما سبق وبُيّن في هذه المقدّمة.
هذا وعادت خالدة سعيد إلى دراسة عمل الأخوين رحباني المسرحي في كتابها “يوتوبيا المدينة المثقّفة” الصادر 2012([10]) في فصل خاصّ([11])، وبذلك تكون قد وفت بوعدها، وبما أشارت إليه في موسوعتها :”الحركة المسرحية في لبنان”.
يبقى أن ما يأسف له الباحث إثر اعتماده على هذا الكتاب القيّم وعوداته المتكرّرة إليه أن تحديد الفترة المدروسة بحقبة قصيرة نسبيّاً 1960-1975 حدّ من الفائدة المرجوّة والمنتظرة منه. فمعظم المسرحيين المدروسين، مؤلّفين كانوا أم مخرجين أم ممثّلين أم غير ذلك، واصلوا نشاطهم المسرحي بعد 1975 وإن كان هذا العام تاريخ اندلاع الحرب اللبنانية. فدراسة مسرح كلّ من جلال خوري ويعقوب الشدراوي وشكيب خوري وغيرهم مثلاً تبقى منقوصة ومبتورة إذا حُدّت واقتصرت على الحقبة المذكورة. فكي نعي أهمّية مساهمة أيّ مسرحي وموقعه ودوره لا بدّ من دراسة مجمل نتاجه، وليس الاكتفاء بحقبة معيّنة واحدة مهما كانت أهمّيتها!
وليت د. خالدة أتبعت مصنّفها هذا بجزءٍ آخر له درست فيه حقبة أخرى كمثل 1975-2000، لكانت عندها استوفت موضوع بحثها من مختلف جوانبه وحقباته. وهذا ما استدركه د. نبيل أبو مراد في كتابه الآنف الذكر. فهو يقول في الفاتحة: “هذا الكتاب كان في الأساس دراسة لنيل شهادة الدكتوراه وكانت بعنوان المسرح في لبنان 1900-1975، (…) لكنّي عندما قرّرتُ طبعها في كتاب، رأيتُ من الأفضل أن تكون شاملة القرن العشرين بأكمله، فعدتُ إليها ونقّحتها وأضفتُ إليها المعلومات والموضوعات اللازمة، وغيّرتُ عنوانها فأصبح: “المسرح اللبناني في القرن العشرين إلخ” (أبو مراد، المسرح، م. س، ص17). وحسناً فعل.
كتاب عبيدو باشا في المسرح اللبناني
ماذا الآن عن ثالث الأثافي أي كتاب عبيدو باشا([12]) الآنف الذكر “هكذا”؟
إنه بلا ريب كتاب جليل الفائدة في موضوعه. لا سيما وأن الكاتب مسرحي ممثّل ومخرج، إذاً فمشارك في الحركة المسرحية اللبنانية، وبمقدوره أن يتحدّث عنها من الداخل ويشهد لكثير من الأحداث والمواقف شهادة عيانية قيّمة. وروايته عن رفض يعقوب الشدراوي للمساعدة المالية التي قدّمتها له منظمة التحرير الفلسطينية خلال الحصار الإسرائيلي لبيروت 1982 مثلٌ على ذلك (باشا، م. س، ص284-286)، لا سيما وأنّه كان شاهد عيانٍ على هذه الحادثة.
بيد أن ما يؤسف له عند العودة إلى هذا الكتاب، أن الطابع الأكاديمي غائب عنه. فهو يخلو تماماً من المراجع والهوامش. وليس هذا وحسب، بل ليس فيه حتى عناوين رئيسية ولا فرعية للمباحث داخل الفصول الاثني عشر والتي خُصّص كلّ منها لمسرحي بدءاً بروجيه عسّاف، وانتهاءً ب برج فازيليان مروراً بشكيب خوري ويعقوب الشدراوي وجلال خوري وغيرهم.
لا هوامش، ولا عناوين للفقرات والمباحث، ولا فهارس للأعلام والأمكنة وغيرها. وكتاب عبيدو باشا هذا أشبه برواية طويلة Roman fleuve من عدّة فصول أو مسلسل تلفيزيوني مؤلّف من حلقات عديدة. يكتب عبيدو بحثه كمن يكتب سيناريو مسرحي أو تلفزيوني: لا مراجع ولا توثيق ولا حتى إسنادٍ للروايات، وفي ب1/ف1 نماذج عديدة من رواياته كمثل ما ذكر عن مسرحية “عريسين مدري من وين”، فلا ضرورة للتكرار أو لإيراد نماذج أخرى هنا. وعليك في نصّ عبيدو أن تفكّ رموز سرديّة روايته أو بالأحرى مسرحيّته إذ تخال نفسك تشاهد مسرحاً داخل المسرحDu théatre dans le théatre. وكثيراً ما تخال أن هذا الباحث يكتب على طريقة مَن يطلق رصاصاتٍ عديدة من رشّاش ويتوقّف، فأسلوبه ذو نبرة اقتحامية كي لا نقول استفزازية، وكثيراً ما يَبعُد عن الوضوح ويُغرق في الترميز والتمعين فيحوجك إلى تفكيك رموزه. أمّا إذا احتجتَ إلى العودة إلى تفصيل أو رواية سبق وقرأتها، فهناك الطامة الكبرى: فما من عنوانٍ رئيسي ولا فرعي ولا من فهرس أو قائمة محتويات موسّعة تسعفك في ذلك!!
وبكلمة ملخّصة مكثِّفة لما سبق يصحّ في هذا الكتاب ما قاله مؤلّفه في مسرح الشدراوي: “لا سبيل للخلاص من الموت إلا بقراءة النصّ بروح نقدية” (باشا، م. س، ص334). فلا سبيل للإفادة من مصنّف عبيدو باشا هذا وضخّ الحيوية والحياة في شرايينه وبين سطوره إلا بقراءته بذهنية نقدية عالية.
محمّد كريّم مؤرّخاً للمسرح اللبناني
تبقى كلمة لا بدّ منها تنوّه بجهدٍ وعملٍ قيّمٍ أنجزه المخرج والباحث محمّد كريّم، وإن كان موضوعه لا يتناول مباشرة الحقبة من تاريخ المسرح التي يدرسها هذا السِفر. إنه كتابه الآنف الذكر المسرح اللبناني في نصف قرن 1900-1950.
ومحمّد كريّم مفضلٌ بلا ريب على المسرح اللبناني وتاريخه بهذا الكتاب القيّم. فهو يسدّ ثغرة في تاريخ هذا المسرح ويربط النهضة المسرحية الثانية التي بدأت 1960، بالأولى. يقول كريّم في مستهلّ مقدّمته للكتاب: “درج المهتمّون بقضايا المسرح في لبنان، ممّن رافقوا الحركة المسرحية الحديثة على التأريخ للمسرح في لبنان بدءاً من سنة 1847 حين قدّم مارون النقاش مسرحية البخيل، ثم ينتقلون إلى سنة 1960 حين عاد منير أبو دبس من باريس وأنشأ مدرسة للتمثيل خرّجت مجموعة من الممثّلين شكّلوا مع العائدين من المدارس والأكاديميّات الخارجية فيما بعد نواة النهضة المسرحية الحديثة” (كريّم، م. س، ص19).
وهنا يطرح كريّم إشكاليّة بحثه: “لكن ماذا عن الفترة الواقعة بين التاريخَين 1847-1960؟ هل من المعقول أن ينقطع فيها أي نشاطٍ مسرحي خلال ما يزيد على مئة عامٍ ليُبعث المسرح فجأة في نهضة حديثة مكتملة العناصر؟” (كريّم، م. س، ص19).
وعن طريقة عمله وجمعه للمعطيات والمعلومات يروي كريّم: “طوال أربع سنوات وأنا أعمل جدّياً لتحضير هذا الكتاب، وقد عانيتُ من أجل تجميع المعلومات عناءً شديداً. فالموضوع بحثه شاقّ، وأكثر مصادره لا يمكن أن تؤخذ إلا من ذاكرة مشارك أو مشاهد، ومَن بقي من هؤلاء على قيد الحياة بدأت تخونه الذاكرة وفي هذا ما يزيد من صعوبة التحقيق” (كريّم، م. س، ص20).
ويبدو أن عمل كريّم الميداني تزامن مع عمل د. أبو مراد الذي ناقش أطروحته في 6/4/1998 (أبو مراد، المسرح، م. س، ص17). ورغم أن هذا الأخير، وكما ذُكر أعلاه، عاد ونقّح الأطروحة وأضاف إليها، ونشرها كتاباً 2002، فإنّنا لا نجد في كتابه أي ذكر لمصنّف كريّم!!
علوم الأديان والمسرح
وفي خاتمة المطاف: ما شأن باحث وأستاذٍ في علوم الأديان بالمسرح؟ قد يسأل سائل.
سؤالٌ كهذا يغفل أن كلا الفنّين المسرح والرسم ارتبطا ولا يزالان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالدين.
سبق لكاتب هذه السطور أن بحث في علاقة الدين ولا سيما المسيحية والإسلام بالرسم والتصوير.([13]) فلا يرى ضرورة للتكرار هنا.
أمّا العلاقة بين الدين والمسرح فكانت غالباً صدامية أكان ذلك في المسيحية أم في الإسلام. ذلك في الغالب، وكما يقول جلال خوري (ب1/ف1) لأن المسرح منافس للدين ويجيب عن أسئلته.
المسيحية والمسرح
ففي المسيحية لم تكن يوماً العلاقة بين الكنيسة والفنون المسرحية سهلة. فالمسرح مثير بصورة مباشرة لأنّه بفعل تمريره أفكاراً وأفعالاً بشرية قد تعتبرها الكنيسة هدّامة يوقظ انتباه الرقابة ويثير الانتقادات. وهكذا تعرّض المسرح لإدانة عددٍ من آباء الكنيسة مثل ترتليانس، وأغسطينوس وباسيليوس ويوحنا فم الذهب”([14])
يقول الذهبي الفم مثلاً في عظةٍ في إنجيل متى عن المصارعين والمسرحيين: “هو الشيطان، أجل هو الشيطان وحده، الذي صنع من هذه الألعاب وهذه التسليات فنّاً، لكي يجتذب تحت لوائه جنود يسوع المسيح، ويضعف حماستهم، ويوهن فضائلهم”. ويؤكّد فم الذهب في عظةٍ أخرى: “إن من يجعل نفسه مهرّجاً يتنكّر لكرامة اسم المسيح” Lendger, op. cit, p1684
والمسألة الأخلاقية هذه والتي كانت دافعاً أساسيّاً عند يوحنا الذهبي الفم، سترخي بثقلها في المشرق ولبنان مع ظهور فن المسرح مع مارون النقّاش. فقد أثار ذلك الكثير من التحفّظات والانتقادات التي أثارها الإكليروس، وعبّر عنها الأب لويس شيخو (1859-1927)([15]) ممّا سيلي ذكره.
وعن هذه العلاقة العدائية بين الكنسية والمسرح يتحدّث المخرج جلال خوري عارضاً بإيجاز: “نحن أمام تحريم حصل في القرن الرابع، بعد اعتناق الإمبراطورية الرومانية للمسيحية، عندما أقدم آباء الكنيسة على إدانة «هذا المسرح الذي يعجّ بالفحش ويحتفل بآلهة وثنيّين»، إدانة أسفرت عن منعه كلّياً، ما أدّى إلى «ثقب أسود» في تاريخ هذا الفنّ دام ستة قرون، قبل أن يتبلور، في بداية الألفية الثانية، في رعاية الكنيسة بالذات، نوع من المسرح خاصيّته دينيّة، نشأ في رحبة الكاتدرائيات ليُقَدّم، يا للمفارقة، كمزيّن ومفسّر للاهوت”([16]).
بيد أن العلاقة المتشنّجة عادت لتستفحل زمن العصر الذهبي للمسرح الفرنسي (ق17). إذ كانت الكنيسة تفرض على المسرحيين، وهُم على فراش الموت، أن يتنكّروا للمهنة التي صرفوا حياتهم وكلّ طاقاتهم في سبيلها. وأن يعلنوا في فعل توبة: “عهدي إلى الله، من كلّ قلبي، وبكامل حرّيتي، أن أمتنع عن تأدية أي دور مسرحي، ما بقيت لي حياة، حتى لو حسُن لدى رحمته اللامتناهية أن تجود عليّ بالصحّة”. وبهذه التوبة فقط كان يجوز أن تقام للمسرحي الميت مراسم الدفن المسيحية وطقوسها” 1684Lendger, op. cit, p
وموت موليير سنة 1673 سيترافق مع التعابير الأكثر إذلالاً وتحقيراً من قبل الإكليروس الباريسي، إذ رفض كهنة دير القدّيس أوستاش Eustache المضي إلى سرير موليير (1622-1673) المنازع، ومُنع عنه المأتم الديني، ومُنعت مراسم الدفن المسيحية. فدفن موليير مع المنتحرين والأطفال الموتى بلا معموديّة” Lendger, op. cit, p1685.
كبير المسرحيين الفرنسيين وواحد من أعظم المسرحيين عبر التاريخ يدفن مع المنتحرين!!
ولم يقتصر اضطهاد الكنيسة لموليير على وفاته وما تبعها، فخلال حياته وقيامه بنشاطه المسرحي كانت العلاقة متشنّجة بين الطرفين. إذ أثار عرض مسرحيّته تارتوف Tartuffe (المرائي) نقمة الإكليروس الكاثوليكي الباريسي، فأفلتَ غضبه من عقاله. فمنع رئيس أساقفة باريس: “قراءة هذه المسرحية وتلاوتها وتمثيلها، سرّاً أو علناً، تحت طائلة الوقوع في الحرم” Lendger, op. cit, p1685
وكان كلّ كبار رجال الدين تقريباً أعداءً لموليير، وكان تأثيرهم في تلك الحقبة كبيراً. ما أدّى إلى وقف عرض مسرحيّتي تارتوف ودون جوان. وما كان موليير بقادرٍ على الصمود بوجههم لولا مساندة الملك لويس الرابع عشر له([17]). إذ أصدر “الملك الشمس” في 5/2/1669 أمره برفع الحظر عن عرض مسرحيّة تارتوف. وفي اليوم عينه لُعبت هذه المسرحية على مسرح الباليه رويال Palais Royal، ولقيت إقبالاً ملحوظاً واستمرّ عرضها حتى عيد الفصح([18]).
وينبغي الانتظار أكثر من قرنٍ كامل حتى يهدأ النزاع الناشئ بين الكنيسة وأهل المسرح في أواخر ق 16.
ولم يكن حظّ المسرح مع حركة الإصلاح البروتستانتية أحسن حالاً، وفي ذلك يقول جلال خوري: “أضف إلى سلسلة التحريم التي كان الدين سبب إقرارها، كراهية البروتستانت لكلّ ما هو تصوير أو تشخيص”. (خوري، جلال، الإسلام والمسرح، م. س)
ماذا الآن عن الإسلام؟!
[1] -كمال ديب: باحث لبناني كندي ولد في لبنان 1964، وهاجر مع أهله إلى كندا وعمره 16 عاماً. حصل على ليسانس في الاقتصاد التطبيقي وبكالوريوس في اللغة الألمانية وآدابها من جامعة أوتاوا. وماجستير في الاقتصاد النظري ودبلوم دراسات عليا في التنمية الاقتصادية من جامعة أوتاوا كذلك. ودكتوراه في البرنامج الاقتصادي من الجامعة عينها. ويعمل حالياً أستاذاً في الاقتصاد في هذه الجامعة. عمل مديراً للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة الفدرالية الكندية، وفي وزارة المالية الفدرالية الكندية. من مؤلّفاته: 1-ثمن الدم والدمار: التعويضات المستحقّة للبنان جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية، بيروت، 2001. 2-ليلى بنت الكروم، رواية، 2005. 3-تاريخ سوريا المعاصر من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011، بيروت، 2011. 4-هذا الجسر العتيق: سقوط لبنان المسيحي؟ بيروت، 2013. 5-أزمة في سوريا: انفجار الداخل وعودة الصراع الدولي، بيروت، 2011-2013. 6-موجز تاريخ العراق 1915-2015. 7-أمراء الحرب وتجّار الهيكل: خبايا رجال السلطة والمال في لبنان، بيروت، 2015. 8-تاريخ لبنان الثقافي: من عصر النهضة إلى القرن الحادي والعشرين، بيروت، 2016. 9-يوسف بيدس: إمبراطورية إنترا وحيتان المال في لبنان 1949-1968، بيروت، 2017. 10-روجيه تمرز: إمبراطورية إنترا وحيتان المال في لبنان 1968-1989، بيروت، 2018. 11-لعنة قايين، بيروت، 2018. 12-رفيق الحريري: إمبراطورية إنترا وحيتان المال في لبنان 1990-2005، 2020. 13-على بوّابات الشرق: مشاهدات لبنانية، بحث سوسيولوجي، بيروت، 2003. 14-بيروت والحداثة: الهوية والثقافة من جبران إلى فيروز، بيروت، 2010.
[2] -ديب، كمال، تاريخ لبنان الثقافي من عصر النهضة إلى القرن الحادي والعشرين، بيروت، المكتبة الشرقية، ط1، 2016، 590ص.
[3] -سعيد، خالدة، الحركة المسرحية في لبنان 1960-1975: تجارب وأبعاد، بيروت، منشورات لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، ط1، 1998، 718ص من القطع الكبير.
[4] -أبو مراد، نبيل، المسرح اللبناني في القرن العشرين: تاريخ قضايا تجارب أعلام، بيروت، شركة الطبع والنشر اللبنانية، ط1، 2002، 812ص.
[5] -باشا، عبيدو، هكذا: انقلاب التغيير على أبطال التغيير في المسرح، دراسة، بيروت، دار الآداب، ط1، 2010، 766ص.
[6] -خالدة سعيد: كاتبة وناقدة وأكاديمية لبنانية من أصل سوري. تُعتبر من المساهمين الفاعلين في حركة الحداثة الأدبية العربية منذ بداياتها وذلك عبر دورها النشط في “خميس مجلة شعر” البيروتية، وكتابتها المقالات النقدية في هذه المجلة، بدءًا من العدد الثاني من صدورها في العام 1957. وقد أطلقت عليها صحيفة النهار اللبنانية لقب “أيقونة النقد العربي الحديث في بلادنا”. ووصفتها جريدة الحياة اللندنية بـ”«شاعرة» النقد العربي”.
لخالدة العديد من الكتب والترجمات والمقالات والدراسات والأبحاث في مجال النقد الأدبي، فضلاً عن ممارستها التعليم العالي في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية لحين تقاعدها. ولدت خالدة صالح (سعيد) في سوريا، درست الأدب العربي في دمشق، ومن ثمّ في الجامعة اللبنانية في بيروت، وحازت شهادة الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون في فرنسا. درّست في عدة مدارس ثانوية في لبنان، قبل أن تنتقل للتفرّغ للتعليم في الجامعة اللبنانية، وذلك بين عامي (1958 و1996). وبعد تقاعدها من التعليم، تتنقل بين قرية قصابين السورية، وبيروت، وفرنسا. هي زوجة الشاعر والمفكّر السوري أدونيس، وابنتها الرسّامة التشكيلية والكاتبة نينار، وهي شقيقة الممثلة مها الصالح والشاعرة سنية صالح زوجة الشاعر والكاتب السوري محمد الماغوط. كتبت في بداياتها بعض المقالات باسم: خزامى صبري، ويبدو أنها اختارت هذا الاسم المستعار هربًا من الشهرة والأضواء، وقناعةً منها أن مواكبة ثورة “شعر” تفترض الكثير من المراس والدربة. ومنذ العام 1959 دأبت على توقيع مقالاتها باسمها الحقيقي. لخالدة سعيد مؤلّفات عديدة في النقد الأدبي والمسرح والترجمة وقضايا المرأة، منها: 1-البحث عن الجذور: فصول في نقد الشعر الحديث، دار مجلة شعر، بيروت، 1960. 2-مغامرات وأسرار: مجموعة قصص، ترجمة كتاب من تأليف إدغار ألن بو، بيروت، دار مجلة شعر، 1962. 3-اللصوص، ترجمة رواية وليم فولكنر، بيروت، دار مجلة شعر. 4-عصر السريالية، ترجمة كتاب والاس فاولي، بيروت، منشورات نزار قبّاني، 1967. 5-حركية الإبداع، دار الفكر، ودار العودة بيروت، 1982. 6-الحركة المسرحية في لبنان 1960-1975، بيروت، لجنة المسرح العربي/مهرجانات بعلبك الدولية، 1998. وقد أمضت نحو خمسة أعوام في إعداده وتأليفه. 7-الاستعارة الكبرى: في شعرية المسرح، دار الآداب، 2007 .8-في البدء كان المثنى، دار الساقي، 2009. تناولت فيه تجارب مبدعات عربيات في ميادين متعددة، كالشعر والرواية والنقد والرسم والنحت .9-منير أبو دبس والحركة المسرحية في لبنان، دار نلسن، 2011. 10-يوتوبيا المدينة المثقفة، بيروت، دار الساقي 2012. 11-جرح المعنى: قراءة في كتاب “مفرد بصيغة الجمع” لأدونيس، بيروت، دار الساقي. 12-أفق المعنى، بيروت، دار الساقي 2017. ولها بالاشتراك مع الشاعر أدونيس، ستّة كتب حول عصر النهضة، صدرت ضمن سلسلة بعنوان: ديوان النهضة: 1-عبد الرحمن الكواكبي، دار العلم للملايين، 1982. 2-الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، دار العلم للملايين، 1983 .3-الإمام محمد عبده، دار العلم للملايين، 1983. 4-الشيخ محمد رشيد رضا، 1983. 5-الشاعر جميل صدقي الزهاوي، 1983. 6-الشاعر أحمد شوقي، 1983.
[7] -سعيد، خالدة، مقابلة مع رنا نجار، جريدة الدوحة، 18/1/2018
[8] -سعيد، خالدة، مقابلة مع محمد ناصر الدين، جريدة الأخبار، بيروت، 19/12/2020.
[9] -العيد، يمنى، خالدة كما عرفتها، مقالة في جريدة الأخبار، بيروت، 19/12/2020.
[10] -سعيد، خالدة، يوتوبيا المدينة المثقّفة، بيروت، دار الساقي، ط1، 2012
[11] -هو الفصل الثاني من هذا الكتاب وعنوانه “القرية الفاضلة في المشروع الرحباني الفيروزي”، ص63-92. وتدرس فيه سعيد المسرحية الغنائية الرحبانية، وممّا تقول: “الأخوان رحباني كتبا مسرحيّات ذات مقوّمات درامية حقيقيّة” (ص78)، ثم تعرض أبرز هذه المقوّمات وتحلّلها (ص79-84)، ممّا لا مجال هنا للخوض فيه.
[12] -عبيدو باشا: ولد في بيروت 1957. ممثّل ومخرج مسرحي، وكاتب وناقد. الأمين العام للمؤسّسة الدولية للمسرح/لبنان. وأحد مؤسّسي فرقة الحكواتي اللبنانية. أمين سرّ سابق لنقابة ممثّلي المسرح والسينما والتلفزيون. من مؤلّفاته وصدرت في بيروت، إلا إذا أشير إلى خلاف ذلك: 1-عين القطّ، مجموعة قصص خيالية للفتيان، 1987. 2-بيت النار: الزمن الضائع في المسرح اللبناني، بيروت، رياض الريّس للكتب، 1995. 3-ممالك من خشب، المسرح العربي عند مشارف الألف الثالث، 1999. 4-موت مدير مسرح: ذاكرة الأغنية السياسية، دار الآداب، 2005. 5-أقول يا سادة: تجربة الحكواتي من التقليد إلى الحداثة، 2007. 6-11 سيَر لعدد ممّن اعتبرهم “صانعي التاريخ والثقافة والفن في لبنان، دار الفارابي، 2005. 7-أكواريوم: مجموعة مقالات نقدية. 8-هُم: سيَر فنّانين، 2008. 9-هكذا: انقلاب التغيير على أبطال التغيير في المسرح، 2010. 10-تياترو العرب: المسرح العربي على مشارف الألفية الثالثة، 2014، في جزأين. 11-عرائس بلا أعراس: مسرح الطفل في لبنان، الشارقة، الهيئة العربية للمسرح، 2015. 12-مؤرّخو المسرح العربي: أي دور وأي تأثير، بالاشتراك مع محمد المديوني، الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام، 2019.
[13] -صليبا، د. لويس، المعراج في الوجدان الشعبي: أثره في نشأة الفرق والفنون والأسفار المنحولة، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط1، 2008، ف3: المعراج وآثاره في التصوير الإسلامي، ص47-93، ومن ضمن هذا الفصل مبحث بعنوان: مسألة التصوير إباحةً وتحريما: ص50-55، وآخر عنوانه: بدايات التصاوير الدينية (في المسيحية والإسلام): ص55-77
[14]– Lendger, André, Théatre et autorité religieuse, in: Poupard, Paul (dir), Dictionnaire des Religions, Paris, PUF, 2008, p1684.
[15] -أنظر نبذات عديدة عنه ودوره في عصر النهضة في: صليبا، د. لويس، الماسونية وأثرها في الأديان الإبراهيمية: دراسة في جدلية علاقتها باليهودية وموقف المسيحية والإسلام منها، جبيل/لبنان، دار ومكتبة بيبليون، ط3، 2020، فق: أسباب معاداة الماسونية في المشرق، ص67-73، و فق: أدب الجدل بين مكاريوس وشيخو، ص111-114.
[16] -خوري، جلال، الإسلام والمسرح بين التحريم وسوء الفهم، مقالة في جريدة الأخبار، بيروت، ع السبت 5/1/2013.
[17] -Lemaître, Henri, Dictionnaire Bordas de Littérature Française, Paris, Bordas, 1994, p580.
[18] -موليير، من الأعمال المختارة 1، ترجمة وتقديم محمد م. القصاص، الكويت، سلسلة من المسرح العالمي، مطبعة حكومة الكويت، يناير 1971، ص37 وص47.
 دار بيبليون
دار بيبليون