“كمال الصليبي أستاذي والتاريخ”
“كمال الصليبي أستاذي والتاريخ ذكريات 1973-2011″، تأليف محمود شُريح، مراجعة بقلم لويس صليبا، صدر عن دار نلسن/بيروت، في 96 ص.
مقالة نشرت في مجلّة الأمن-بيروت، عدد كانون الأوّل 2023
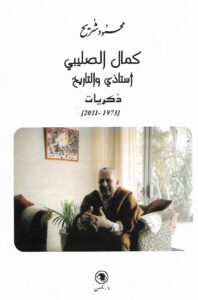
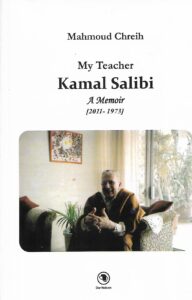
يرسم المؤلّف في كتابه “بورتريه” وملامح من سيرة وشخصية وفكر أستاذه كمال الصليبي (1929-2011)، وممّا يراه (ص14-15): “الصليبي راوية قصّة من الطراز الأوّل فالكون معقّد، لكن تاريخه بسيط، وتسعفه ذاكرة متّقدة تُلمّ بالتفاصيل والجزئيّات وتوثّق الحدث وتاريخه”.
وعن شخصيّة أستاذه وأدب حياته يقول (ص15): “كان في عيشه متزهّداً متقشّفاً. مأكله بسيط، ولباسه أنيق. لم يحبّ الظهور، ولم يرضَ بحفلِ تكريم. متواضع (…) مقلّ في حديثه”.
ويتابع راوياً (ص16): “آخر محاضرة عامّة له كانت صيف 2010 في الجامعة الأميركية عن دور المسيحيين العرب في الشرق”، فكأن هذا الموضوع جاء بمثابة وصيّته.
وعن الصليبي مدرّس التاريخ الجامعي يروي شُريح متذكّراً (ص41): “لا يجلس ولا يقف ساكناً. يحاضر وهو يذرع القاعة جيئة وذهاباً فتموجُ القاعة لحركته. يروي تاريخ لبنان الحديث قصّة متّصلة الحلقات (…) صوته يعلو وينخفض، فإذا علا انتصبت الهامات، وإذا انخفض اشرأبّت الأعناق. أدركنا مع الوقت أنّها تقنيّة لإبقائنا متيقّظين”.
وعن أهمّية تعليم التاريخ يقول الصليبي (ص70): “التدريس يساعد على تصفية الآراء وتصحيحها عبر التحاور مع عقولٍ فتيّة. وإذا أنت قبعتَ في منزلك ولم تحاضر فإنّك قد تُصدر نظريّات خياليّة. (…) الصفّ هو المختبر، هنا تجرّب مصداقية أرائك، وعبر الحوار قد يكون إسقاط بعضها لازماً”.
ولعلّ أبرز ما في هذا الكتاب حوارات المؤلّف مع أستاذه الصليبي. ومنها نقرأ (ص19): “سألته مرّة كيف يؤرّخ، فقال إنّه قبل أن يدوّن يقرأ حول الموضوع المعني، ثمّ يتصوّر الأحداث التي جرت، ويتخيّل الوقائع التي انصرمت، ثمّ يدوّن وفق فهمه لتلك الأحداث والوقائع، فيكتشف دربه الأصحّ وهو ماضٍ في تدوينه، ويعيد النظر على الدوام فيما يؤرّخه. وكان في نهاية السبعينات يحبّر مسودّات كتبه في مقهى باركلين على مقربة من مسكنه”
وتستوقفنا طريقة الصليبي هذه في التأريخ وتدوين الوقائع الماضية. وهي أوّلاً تذكّرنا بطريقة تدوين الملاحم الهندية الكبرى ولا سيما المهابهاراتا. إذ يُروى أن المؤلّف فياسا أملاها وهو يستعيد تخيّل ما وقع من أحداثٍ غابرة.
فهل هي الطريقة الأجدى لتدوين التاريخ؟! إنّها أقلّه تفسّر لماذا وكيف يكتب الصليبي مؤلّفاته من دون حواشٍ فكتابه “بيت بمنازل كثيرة” يخلو من أيّ منها!!
كبار المؤرّخين كانوا ولا يزالون يكتبون التاريخ وهم محاطين بالمصادر والمراجع بل غارقين وسطها وذلك ابتغاء للدقّة وإسناد كلّ رواية أو تفصيل إلى مصدره. أمّا الصليبي فنرى أنه يدوّن نصوصه في مقهى!! وكأنّه يكتب رواية أدبية أو سيناريو فيلم!!
ومن أبرز ما نقل شُريح من حوارات مع أستاذه المؤرّخ المقابلة الضافية التي أجراها معه ونشرتها جريدة النهار في 15/5/1983. والصليبي يستهلّ حديثه بعرض مفهومه للتفكير التاريخي فيرى (ص56) أنّه: “إعادة نظرٍ مستمرّة في المادّة التاريخية في موضوعٍ ما. في التاريخ هناك المقنِع وغير المقنع، هناك العميق والسطحي، أي هناك درجات متفاوتة من الشمول ووعي الحقائق وأخذها بالاعتبار، ولكن ليس هناك صواب أو خطأ. هذا في مجال التفكير التأريخي. أمّا في مجال التدوين فهناك الصدق أو عدم الصدق. والصدق الكامل في كتابة التاريخ يتطلّب الإحاطة والشمول: الحقيقة كلّ الحقيقة، ولا يضاف إليها التفكير”.
ويرى العديد من تلامذة الصليبي أن أبرز ما تعلّموه منه هو بالحري التفكير التاريخي إذ طالما شدّد عليه في تدريسه لهذه المادّة. يشهد د. عبدالرحيم أبو حسين: “كان أمراً مهمّاً أن نتعلّم تاريخ لبنان على يدَيه، لكن الأهمّ من ذلك بكثير أنّه علّمنا كيف نفكّر في تاريخ لبنان. كان هذا أمراً واجهه وحسمه في حياته المهنيّة، إذ واجه تناقضات الماضي، وهي تظهر في نزاعات الحاضر”. (كمال الصليبي: الإنسان والمؤرّخ، المركز العربي للأبحاث، 2016، ص17). ويتابع أبو حسنين فيؤكّد أنه تعلّم من أستاذه المؤرّخ النظرة الواقعية والإقلاع عن تقديس الشخصيّات وإنجازاتها: “لم يكن تحطيمه الأصنام موضع تقدير دائم، إذ كان وليد رفضه فكرة التاريخ بوصفه تراثاً يتّسم بالقداسة إذا كُتب على أسسٍ واهية”.
وممّا يؤثَر عن الصليبي وضعه كتاباته وأعمال سائر المؤرّخين ضمن السياق العام للكتابة التاريخية وكمجرّد حلقة من سلسلة طويلة لا تنتهي من التفكير التاريخي وتطوّره المتواصل، يقول (ص64): “من يكتب التاريخ يجب أن يكون مستعدّاً لقبول فكرة أن دراسته قد تصبح منسوخة يوماً ما، فيحلّ محلّها جديد يثبتها أو ينقضها. وعلى المؤرّخ أن يتمنّى أن تصبح كتاباته جزءاً من كتابة التاريخ العام. فالكتابة التاريخية العالمية مرحلة من عملية نموّ، من سلسلة لامتناهية في تطوّر التفكير التاريخي ونموّه”.
وطرح الصليبي الواقعي والمتقدّم هذا يقوده إلى تقرير (ص64): “إن الحقيقة التاريخية هي وليدة الزمن”. وهذا ما جعل تلميذه أبو حسنين يخلص في هذا المجال إلى: “سعى كمال الصليبي إلى تقدّم المعرفة، وليس إلى الوصول إلى الحقيقة” (كمال الصليبي: الإنسان، م. س، ص18).
وهو ما يتيح لنا القول: لم يكن الصليبي متواضعاً ومحدوداً في طموحه كمؤرّخ بل كان بالحري واقعيّاً وأكاديميّاً وغير نرجسي، وهو الذي لم يتعب من ترداد (ص44): “من يقبض نفسه جدّياً، فإنّه يعلن بداية انهياره”.
الصليبي ينظر في مرآة تعكس له صورته بحجمها الطبيعي والواقعي، فلا يغرم بها كما فعل نرسيس ولا يكبّرها كما لو كان ينظر في مجهر، بيد أنّه بالمقابل لا يزدريها ويصغّر حجمها.
وممّا استوقفنا كذلك من طروحات الصليبي نظرته المتّزنة إلى مساهمة المستشرقين في التأريخ لمنطقتنا. فهو لا يبالغ في مدح انجازاتهم من ناحية، لكنه لا يغمطهم حقّهم من ناحية أخرى. وتأتي في طليعة مساهماتهم الريادة، يقول (ص66): “لو لم يكتب المؤرّخون الغربيّون عن تاريخ العرب لما تمكّنا حالياً من الكتابة عن الموضوع”
ويليها المنهجية الأكاديمية الراهنة: “أخضع المؤرّخون الغربيّون التاريخ العربي للبحث بحسب الأساليب التحليلية والتوثيقيّة الحديثة”.
وأبرز نقائصهم أنهم بقوا غرباء عن موضوعهم وأعوزهم فهمه من الداخل (ص66): “أما نقطة الضعف فهي أنهم لم يفهموا التاريخ العربي من الداخل، ولم يستوعبوا النفسية التي تقف خلفه. نظروا إليه من الخارج. المؤرّخ المولود هنا يقف على مفاهيم أكثر، ذلك أنّه يفهم اللغة تلقائيّاً، يتقن العربية أو اللغات الشرقيّة الأمّ “عالطاير”. الكتابات الغربية أسيرة لتفسير كلمات وجمل من غير المعقول أن تتضّح في أذهان المؤرّخين الغربيين”.
وهكذا ببساطة وواقعية ينسف الصليبي، وعن حقّ، مقولة المثل العربي: “كلّ شي فرنجي بِرنجي (ممتاز)”. وغالباً ما كنّا ولا نزال نقع أسرى لها، فنرى كلّ ما يأتينا من الغرب مميّزاً وجديراً بأن يكون لنا أسوة ونموذجاً. وهذا تحديداً ما يشير إليه ويحذّر منه (ص67): “بعض المؤرّخين العرب وقعوا في خطأ الغربيين نفسه، فصاروا يفهمون العربية ممّا شرحه وعلّق عليه المستشرقون. تحوّل بعض المؤرّخين العرب إلى مستشرقين، وبدل أن يعتمدوا على بديهيّتهم في الشروح التاريخية ساروا على خطى المستشرقين، فوقعوا في أخطائهم. على المؤرّخ أن يتّكل على حدسه. المؤرّخ العربي للمثال، يفهم العلاقات القبلية تلقاء، لكن المؤرّخ الغربي يبني أحياناً نظريّات لا علاقة لها بالواقع”.
ولا نرى مناصاً لنا من الإقرار أن ملحوظة الصليبي هذه في محلّها وتعطي كلّ ذي حقّ حقّه وتحذّر من ظاهرة المحاكاة الببّغائية للمستشرقين. وهو يقرّ لأحد أساتذته بفضلٍ عميم في هذا المجال (ص72): “أستاذي نبيه أمين فارس حبّب العربية إليّ وعلّمني أن أكتب بها، وأن أستعمل المصطلح العربي التقليدي وأن أمتنع عن استعمال الحديث المفرنج الذي يأخذ به المستشرقون العرب”.
وظاهرة التفرنج هذه يرى الصليبي أنّها أبرز أسباب تخلّفنا الراهن (ص80): “وأعجب أن الجيل الحالي من الشباب العربي لا يعرف تراثه (…) ويؤسفني أن كلّ جيلٍ من طلّابي يجهل تراثنا أكثر ممّا سبقه”.
وهو يخلص إلى (ص82): “هذا العصر هو عصر إهمال وكسل وتوانٍ. هذا هو عصر الانحطاط الحقيقي”. (ص15): “إنه عصر البله والانحطاط”.
في هذا الكتب الكثير من عصارة تأمّلات كمال الصليبي، وتبصّره بأزمة يومنا على ضوء الأمس. فلله درّك أيها المؤرّخ الجريء الحكيم فقد شخّصت الداء، ووضعت الإصبع على الجرح!
 دار بيبليون
دار بيبليون
