زاوية مبدعون من لبنان/عدد تموز 2018
بقلم أ. د. لويس صليبا
الكاتب والمخرج جلال خوري: من الماركسية إلى اليوغا 
جلال خوري في دور شكسبير

المشهد الأخير في مسرحية شكسبير

جلال خوري يتوسّط زوجته ماري ونسيبه المصوّر عبدو أبي رعد
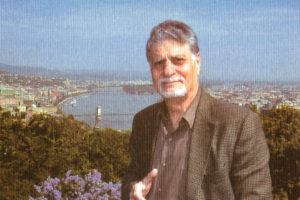





لأشهر قليلة خلت كان من المقرّر أن نفتتح زاويتنا هذه “مبدعون من لبنان” بحوار مع جلال خوري (1934-2017) الكاتب المسرحي والمخرج والممثّل وأحد أبرز أعمدة المسرح اللبناني المعاصر، ولقيَت الفكرة عنده كلّ ترحيب. ولكن جلالاً فاجأنا إذ غادرنا بلا استئذان! رحل رائد المسرح السياسي اللبناني وبقي مشروعنا، وكان لا بدّ أن يطرأ عليه تغيير ما. فعوض أن يحدّثنا جلال عن نفسه ها نحن مجبرون أن نتحدّث عنه. أن نغوص في شخصيّته وإبداعاته لنستخرج عناصر الديمومة والابتكار فيها. وليس هذا بالعمل اليسير. ولكن هذا المبدع من موطن الأرز يستحقّ عناء التفتيش والتحليل والتنقيب فهو أول مسرحيّ لبناني تُرجمت مسرحيّاته إلى لغات عالمية وعُرضت في أوروبا وغيرها، وله إلى ذلك إسهامات قيّمة في تطوّر الفكر والفنّ في لبنان. ونستذكره اليوم في ذكرى ميلاده الأولى بعد رحيله.
جلال خوري ملامح سيرة مؤلّف ومخرج
ولد جلال خوري في بلدة الصفرا/فتوح كسروان في 29/5/1934، وأسلم الروح في 2/12/2017، وبين هذين التاريخين لعب أدواراً عديدة وبارزة على المسرحين الكبير (الحياة) والصغير. وترك بصمات لا تمحى في تطوّر المسرح اللبناني وبلوغه العصر الذهبي.
عن نشأته وعائلته يقول جلال: “والدي [الياس الخوري] كان خيّاطاً شهيراً، تحوّل إلى الخياطة النسائية. عملتُ معه مدّة من الزمن لأنه مرض، ولم يكن من الممكن التخلّي عن مؤسّسة كبيرة كمؤسّسته. وإضافة إلى هذا كان أبي رسّاماً فتح ذهني على عالم التصوير وتثقّفتْ عيني وتأملتُ طويلاً في بناء اللوحة والمشهد.” (سعيد، خالدة، الحركة المسرحية في لبنان 1960-1975، بيروت، لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، ط1، 1998، ص 514).
ونشأ جلال في بيتٍ ماركسيّ، والده كان شيوعيّاً متحمّساً، ومنذ سن الخامسة عشرة اطّلع على الكتابات الماركسية وساعدته في ذلك لغته الفرنسية المتينة. أما عن المسرح فيقول جلال: “لم أختَرْ المسرح، المسرح اختارني. كنتُ أعمل صحافيّاً وناقداً فنّياً في جريدة الأوريان. فشجّعني الصحافي جورج نقّاش على التخصّص في المسرح وأمّن لي منحة من الحكومة الفرنسية لدراسته في باريس.” (مقابلة في برنامج خوابي الكلام على تلفزيون لبنان مع عبير شرارة، 23/11/2016).
سُحر جلال بأعمال المسرحي الألماني الشهير برتولد بريخت (1898-1956)، فكان لها أثر حاسم في مسيرته المسرحية ونتاجه، حتى سمّاه بعض الباحثين بريخت لبنان. ويقول جلال في ذلك (5/8/1986): “أنا كَبريختيّ كتلميذ متواضع له، حاولتُ أن أتبع تعاليمه مئة بالمئة. كان بريخت يقول: نحن نصوّر شخصيّات سلبية لإخضاعها للنقد. وأنا من هذا المنطلق عملتُ.” (سعيد، م. س، ص519).
إسرائيل تنزعج وتردّ على جلال
أمّا الأثر الثاني الكبير فكان هزيمة 5 حزيران 1967. يومها كان يتابع دراسته في المسرح في باريس. فصُدم وبحث وقرأ كثيراً عن نشوء دولة إسرائيل، واعتمد مراجع إسرائيلية، كما يؤكّد. وإثر عودته إلى لبنان كتب بالفرنسية مسرحيّته الأولى “وايزمانو بن غوري وشركاه”. وتناول فيها نشوء إسرائيل، ووضعها في إطار رمزي. ثم عهد إلى صديقه المسرحي ريمون جبارة بترجمتها إلى العربية المحكيّة. وعُرضت في مسرح بيروت في 25/10/1968، وكانت أول مسرحية تُعرض على الخشبة، وتمثّل وقائع وثائقيّة مرجعية تتّصل بالقضية الفلسطينية. انزعجت الأوساط الإسرائيلية من هذه المسرحية، فخصّصت إذاعة إسرائيل برنامجاً اسمه “حقائق وأكاذيب” بثّته في 31/12/1968 (اليوم الذي ضرب الإسرائيليّون فيه مطار بيروت) يقدّم فقراتٍ منها ويردّ عليها. يقول جلال في ذلك: “كان أشدّ ما أزعجهم هو ما ورد فيها حول إبراهام شترن مؤسّس جماعة شترن الذي دعا 1938 إلى التحالف مع جميع القوى المعادية للإنكليز بما في ذلك ألمانيا النازية، وذلك رغم أن القوانين المعادية للسامية كانت قد صدرت في ألمانيا. وكان شترن في موقفه ذاك يردّ على الكتاب الأبيض الذي أصدره الإنكليز 1938 استرضاءً للعرب خوفاً من انحيازهم للألمان. وعمدت الإذاعة الإسرائيلية إلى تكذيب ما جاء في المسرحية رغم أنني استقيتُ معلوماتي من مؤرّخ إسرائيلي موثوق ونائب لاحق هو ميكائيل باروزار.” (حديث جلال خوري لملحق النهار 18/4/1992). وهكذا ففي اليوم الذي كان فيه العالم بأسره منشغلاً بالهجوم الإسرائيلي على مطار بيروت، كانت إذاعة إسرائيل منشغلة بالردّ على جلال خوري ومسرحيّته!
“جحا في القرى الأمامية” علامة فارقة في تاريخ المسرح
ولكن ضربة المعلّم جلال الكبرى في المسرح اللبناني، والتي كانت وستبقى علامة فارقة في تاريخه، هي بلا ريب مسرحيّته “جحا في القرى الأماميّة”.
عُرضت هذه المسرحية على مسرح مهرجانات بعلبك طيلة شهري ك2 وشباط 1971. واضطّر جلال بعدها إلى نقلها إلى مسارح أخرى بسبب التزام مسرح المهرجانات ببرامج وعقود غيرها. وبلغ مجموع عروض المسرحية 172 عرضاً. فكان نجاحها ظاهرة لم يعرفها المسرح اللبناني حتى ذلك الحين، إذ لم تكن عروض أنجح المسرحيّات يومها تتخطّى الثلاثين عرضاً!
كتب جلال في مقدمة مسرحيّته هذه: “سنة 1283 مات في قونية/تركيا المدعو نصر الدين خوجة رجل ذو حكمة كبيرة دخل الأسطورة وهو حيّ لذكاء أجوبته وتصرّفاته…وجحا يعكس نوعية إنسان ذي وجهين: الفردي والشعبي، وفي نفس الوقت الانتهازي الصغير والصامد و”جحا في القرى الأمامية” هي لقاء هذه الشخصية مع واقع متأزم. لقاء الإنسان العربي ذي التركيب العقلي البائد مع عالم معاصر علميّ وعنيف مزوّد بوسائل قمع خبيثة، ولقاء التحجّر العربي بالحداثة والعقلانية الإسرائيلية.” (أبو مراد، نبيل، المسرح اللبناني في القرن العشرين، بيروت، ط1، 2002، ص547).
جمع جحا الحطّاب في شخصه النقيضين، فهو فاسد من جهة ويُرشي رجال الأمن اللبناني ليسمحوا له بإقامة المشاحر وقطع الأشجار. وهو بالمقابل يرفض رفضاً قاطعاً التعاون مع الإسرائيليين وإعطاءهم أية معلومات، ولا سيما عندما قبضوا عليه وعذّبوه! وتبقى هذه المعادلة التي طرحها جلال 1971 قائمة حتى اليوم نموذجاً نمطيّاً للبناني: ذكاء ووطنية صرفة وفسادٌ في آن! فهل كان ذلك سبباً أساسيّاً في نجاح المسرحيّة: شخصية تعكس الوعي الجماعي الذي كان ولا يزال سائداً؟!
وعن نجاح مسرحية جحا المنقطع النظير يقول الممثّل رفعت طربيه: “في هذه المسرحية التقى الشخصان اللذان يجب أن يلتقيا لتنجح أي مسرحية، المؤلّف/المخرج المبدع جلال خوري، والممثل البارع نبيه أبو الحسن.”
ويقول عبيدو باشا (جريدة الحياة 3/12/2017): “أُعطي جلال خوري حقّ افتتاح سفارة المسرح الملحمي ومسرح التغريب على الأراضي اللبنانية. فمنذ جحا في القرى الأمامية ساهمت المسرحية بقلب الأوضاع، بحيث لم يعد المسرح في وضعية دفاعية أمام الجمهور.”
جلال خوري والمسرح الصوفي
نكتفي بهذا القدر عن جلال خوري رائد المسرح السياسي اللبناني، وبريخت لبنان: الكاتب والمخرج الماركسي/البريختي. وفي الأبحاث العديدة التي كُتبت في هذا المجال، ومنها أطروحتين جامعيّتين، زيادات عديدة لكلّ مستزيد. وننتقل الآن إلى عرض وتحليل المرحلة الثانية من مسرحه: المسرح الصوفي، أو مسرح اليوغيّ جلال خوري. وبالطبع يصعب الفصل فصلاً تمامّاً بين المرحلتين إن من حيث الزمن، أو من حيث تداخل الأثرين، أو الفئتين في المسرحيّات الجلاليّة.
ولكنّ ما سرّ هذا الأثر الجديد والذي لا يقلّ عن أثر بريخت في المسرح الجلاليّ؟ لِمَ وكيف تمّت هذه النقلة من الجدلية المادّية إلى التصوّف واليوغا، على ما بين العالَمين من تضادّ؟ وهل من نقلة حقّاً أو تحوّل ما في مسيرة هذا المسرحيّ المبدع؟!
لعلّ هذا الأثر، أو هذه القطبة المخفية تُختصر بعبارة التأمل التجاوزيّ وباسم روبير كفوري. ونحن في مقولتنا هذه نستند أساساً إلى معرفتنا الشخصية بجلال خوري والتي تعود إلى سنة 1983، وإلى حواراتنا العديدة معه. وكذلك إلى شهادة زوجته السيدة ماري زعرور خوري في مقابلتنا معها يوم الإثنين 28/5/2018.
في أواخر السبعينات (1978-1979) دخل جلال خوري في عالم آخر غريب عليه، فقد تعلّم التأمل التجاوزي على يد أستاذ مرجع في الدراسات الهندية واللغة السنسكريتية واليوغا هو المستهند روبير كفوري. وكان الرجلان على معرفة وثيقة سابقة، فكلاهما ماركسيّان وفي الحزب الشيوعيّ، وكلاهما فنّانان، فروبير كان عازف Violencelle. وقد أكّدت لنا السيدة ماري زوجة جلال هذه المعلومات، وأضافت أنهما: هي وهو تعلّما التأمل التجاوزي في يوم واحد في الأشرفية/بيروت على يد روبير، كما تابعا معاً دروس التقنيات المتقدّمة من التأمل Siddhis 1981-1982، بإشرافه.
وكان جلال عندما عرفتُه 1983 يمارس بانتظام التأمل وتقنيّاته المتقدّمة، ويتردّد باستمرار على مركز التأمل في الأشرفية/الحكمة، ويرافق كفوري في العديد من محاضراته وندواته، ويعاونه في العديد من نشاطاته. وفي فرصة عيد الميلاد 1983 سافر ضمن الوفد اللبناني للمشاركة في تجمع ومؤتمر دولي للتأمل التجاوزي في فيرفيلد/أيوا في الولايات المتّحدة. وقد ضمّ هذا المؤتمر سبعة آلاف خبير في الحقل الموحّد والتأمل. وكان الوفد اللبناني برئاسة د. أنطوان أبو ناضر الذي قيّض له لاحقاً أن يصير الرئيس الأعلى لحركة التأمل التجاوزي في العالم، وخليفة مؤسّسها الحكيم مهاريشي ماهش يوغي. وأذكرُ تماماً، أنه عند عودة جلال من ذاك المؤتمر في ك2/1984 التقينا به، في جلسة ترحيبية، وأطلعنا بالتفصيل على ماجرياته وفعاليّاته ونشاطه هو فيه. وكان لحضوره ومشاركته في هذا المؤتمر والتجمّع العالمي الضخم أثر بالغٌ فيه.
والخلاصة فأثر روبير كفوري والتأمل التجاوزي عموماً كان فاعلاً في شخصية جلال وفكره، أتاح له نقلة ما من المادّية الديالكتيكية إلى التصوّف والروحانية، ولا سيما روحانية الشرق الأقصى. وجلال خوري الذي عرفتُه كان يوغيّاً حتى العظم، يعلّم ويشرف على ممارسة الهاتا يوغا، ويواظب على ممارسة التأمل.
وقد حار الباحثون في مسرح جلال في أسباب هذا التحوّل وخلفيّاته، وفسّروه بطرق شتّى غاب عن أكثرها الجوهر. فقال بول شاوول في مقالة في جريدة المستقبل 4/12/2017: “تحوّل جلال عن إرثه اليساري ربّما إلى نقيضه، ومن هنا نفهم تغيّر أفكاره ومفهومه للمسرح واختياره مواضيع تختلف بمضامينها”.
وفي الحقيقة لا نفهم من قول شاوول شيئاً عن أسباب هذا التحوّل!
وقال عبيدو باشا (جريدة الحياة، 3/12/2017): “ثم اندفع جلال بعد أن تقطّعت حبال حنجرة بريخت في لبنان والعالم العربي إلى الصوفية. جلال المؤمن بالطبّ غير التقليدي، ومدمن اليوغا…” !
وقال صديقه الممثل رفعت طربيه (مقابلة على MTV إثر وفاة جلال): “اتّهم أنه ترك اليسار. دخل جلال في عالم اليوغا كي يدخل إلى عالمه الداخلي. وألّف ثلاث مسرحيّات لها علاقة مباشرة باليوغا”.
ويبقى محور البحث الأساسي أن نُظهر الأثر الهندويّ/اليوغي في مؤلّفات جلال نفسه. وليس الأمر بعسير على العارف بالفلسفة الهندية. فنصوصه تعبق وتفوح بأريج بخور خشب الصندل الهندي الذي كان يعشقه ويوصي المسافرين إلى شبه القارّة أن يأتوه به!
ولن يتّسع المجال لنعرض ونستعرض كل مسرحيّات الحقبة الثانية من الإبداع الجلاليّ، لذا نقتصر على واحدة منها، بل وحتى على أبرز المعالم اليوغيّة فيها، وعسانا نعود لاحقاً إليها، إنها “رحلة مُحتار إلى شري نغار”: استحضارية لأربعة مممثّلين ومنشدة. وقد عُرضت على مسرح مونو/بيروت في شباط 2010.
رحلة مُحتار بين الأديان واليوغا
يفتتح جلال مسرحيّته بآية من أقدم كتاب في العالم: ريك ڤيدا. وهي تحديداً الآية التي كان الحكيم مهاريشي يردّدها على مسامع مريديه وتختصر تعليمه: {المعرفة مجسّمة [مبنية] في الوعي}. وتعني أن المعرفة تختلف باختلاف مستويات وعي الإنسان: من معرفة اكتسابية إلى تفكّرية وعيانيّة، فاختبارية/تبصّرية. وسنرى أن هذه الآية مفتاح لفهم كامل المسرحية والتي هي بمثابة قصّة تلقينية Initiatique.
أبطال المسرحية، ولا سيما البطل الأساسي وزوجته، لا يحملان اسماً، وذلك على الأرجح ليكونا ممثلين للإنسان المطلق من دون أي حدود يرسمها اسم معيّن أو ثقافة معيّنة. أما القصّة فقصّة، راهب مسيحيّ سابق متزوّج وامرأته حامل. أما الإشكالية أو العقدة، فتكمن في مسألة حيّرته وسلبت لبّه. وقد أثارت الكثير من الجدل ولا تزال. وهي ما حُكي عن قبر للمسيح في شري نغار عاصمة ولاية كشمير في الهند. قرأ “المُحتار” كلّ ما كُتب عنها، وتابع مختلف البرامج الوثائقية الخاصّة بها، “من لمّن سمعت فيها هالقصّة خضّتني” يقول (ص19). وما كانت النتيجة سوى المزيد من التساؤلات! “عم دوّر اقلع سوسي ناخرة راسي وريّح بالي” (ص20). فشاء أن يسافر إلى شري نغار ليحضر بشخصه، ويعاين بنفسه هالة ومناخ وروحية المكان! (ص17)، كما قال لامرأته، في محاولة لإقناعها بجدوى مشروعه. ولكن هذه الأخيرة تقف سدّاً منيعاً دون سفرة الحجّ هذه: كيف يسافر وهي حامل؟! وإلى منطقة خطرة، ومسرح للمعارك بين الهند وجارتها باكستان؟! وتنتهي المشادّة بأن تهدّده بأنه إذا أصرّ وغادر المنزل مسافراً، فستغادره هي بدورها!
وهنا ينتقل المشهد لنرى هذا المُحتار في أمر قبر المسيح في شري نغار وقد وصله وبدأ حواراً تساؤليّاً شيّقاً مع مرشد سياحيّ هندي فيه. وليست المسألة بهذه البساطة. فلكي نفهم هذه الحيرة الوجودية للمُحتار/الحاجّ، فعلينا أن ندرك أنه إذا ثبُت أن هذا الضريح هو حقّاً قبر المسيح فهذا ينسف عقائد المسيحية الرئيسية في الفداء والصلب والقيامة من أساسها، ويطيح بالتالي بها. والضريح هذا يقف في الحقيقة على تخوم الديانات العالمية الخمس الكبرى كلّها: فهو مقامٌ إسلامي في مدينة تسكنها غالبيّة مسلمة، وصاحب المقام المزعوم هو مؤسّس المسيحيّة، والمدينة كانت في السابق مقرّاً لجالية يهودية، أو للقبيلة اليهودية المفقودة، ومن هنا الزعم بحضور المسيح وعيشه فيها. وعلى مسافة دقائق من الضريح تقوم آثار دير بوذيّ يُزعم أن المسيح أقام فيه، وشارك في المجمع البوذي الكبير الذي عُقد سنة 80م. أما الحضور الهندوسيّ فواضح ووازن، فشري نغار مدينة مختلطة إسلامية-هندوسية، ومحاطة ببلدات هندوسية. والمقام يزوره الهندوس ويكرّمون صاحبه، كما يزوره المسلمون، وكذلك السوّاح اليوم من مختلف أرجاء العالم. حتى غدا مَعْلماً سياحيّاً أساسياً في الهند.
ولكن السائح/الحاجّ المُحتار الآتي من أقاصي الأرض كي يُلقي نظرةً على داخل المقام تسمح له أن يلتمس بالحدس وبالإلهام حقيقة سرّ المكان (ص56) يُصاب بخيبة أمل كُبرى! فالدخول إلى حرم الضريح ممنوع. فلماذا إذاً قطع كلّ هذه المسافات، وتحمّل كل هذه المشقّات؟!
ولكن، وكما كلّ الأمور في الهند، فالأمل بالدخول غير مقطوع. والقرار يعود إلى حارسه “بشارات سليم” وهو من نسل صاحب المقام! فإذا نجح الحاجّ المُحتار بإقناعه كان له ما يريد، ودخل. وفي انتظار وصول الحارس يدور بين المُحتار والمرشد السياحيّ حوارٌ فكريّ وصوفيّ رشيق وعميق. ثمّ يحضر الحارس ومعه زوجته، وهي نسخة طبق الأصل عن زوجة الحاجّ: حبلى وقلقة بشأن مصير من تحمل في بطنها. وكاتب المسرحيّة يوصي (ص13): “أن تؤدّي نفس الممثّلة دوري المرأتين”.
ولكن، وعوض أن يفتح الناطور باب الضريح للحاجّ المُحتار، يكتفي بأن يُنشده قصيدة/أغنية تلخّص حكاية حال هذا الحاجّ: “كان في رجّال نُصّو محتال، ونُصّو قدّيس، عندو سؤال نُصّو عالبال ونُصّو تدليس” (ص53). وهكذا لم تنفع كلّ محاولاته، لا بالرشوة، ولا بغيرها في الدخول. فيجلس محتاراً مستسلماً.
هنا، وعلى صدح صوت المنشدة يتحوّل المشهد ليعود حيث كان الرجل المُحتار في البداية أي في منزله (ص60). فتدخل امرأته لتزفّ له خبر موافقتها على مشروع سفره إلى شري نغار! ويظهر بعد ذلك مباشرة الناطور والمرشد السياحيّ مرّة أخرى فيناديه الناطور معلناً أنه مستعدّ أن يفتح له باب المقام. فيصرخ الرجل جواباً على موافقتيّ الزوجة والناطور في آن: ما من ضرورة بعد للسفر، ولا للدخول إلى حرم المقام: “ما بقى في لزوم…إلّي بدّي شوفو شفتو، والّي بدّي أعرفو عرفتو” (ص62). فالرحلة الداخلية قد تمّت. والكشف الذي حصل يُغني عن أي حجّ أو معاينة!
قصة تلقينية يوغيّة
والبحث عن المؤثرات الهندية واليوغية في مسرحية “رحلة مُحتار” يكاد يكون أمراً عبثياً لا لزوم له! ذلك لأنها، ومن بابها إلى محرابها، قصّة تلقينية يوغيّة صرف، كما أشرنا. ففي المقدّمة، وإثر ذكر آية ريك ڤيدا المفتاحيّة الآنفة، يحدّثنا الكاتب عن المسرح الهنديّ (ص7): “مسارح الهند غالباً ما هي دراما كونيّة، يظهر فيها، في أُطر وأساليب تحكمها الرموز، آلهة تتجسّد كلّما اهتزّ نظام الدنيا، واضمحلّت القيَم، وحُرّفت الشرائع، وذلك لمناهضة الشرّ، ونُصرة الخير، وبَعثه من جديد.”
يبدو من كلام الكاتب هنا أنّه لم يحدّد خياره المسرحيّ وحسب، بل هو يستعيد على طريقته وبأسلوبه آية الكيتا الشهيرة، والتي يُعلن فيها كريشنا: {كلّما ضعُفت الفضيلة، وهيمن الإثم، ألدُ ذاتي بذاتي من أجل حماية الأبرار، وإهلاك الأشرار. ومن أجل تثبيت الناموس، أتجسّد عصراً بعد عصر.} (كيتا 4/7-8). ولا يغربنّ عن بالنا أنه يتناول في مسرحيّته هذه حكاية تجسّد إلهيّ معيّن وحالة “مسيحيين ضايعين بين كريشنا ويسوع” (ص28).
والرحلة التي نشهدها في هذا العمل رحلة جوّانية يدخل فيها المُحتار إلى أعماق ذاته، ولا يتحرّك لا أفقياً ولا جغرافيّاً. وينبّهنا الكاتب منذ المقدّمة قائلاً (ص7): “رحلة مُحتار إلى شري نغار قد تخرج عن المألوف، أو على الأقلّ تطمح إلى ذلك، بغية الغوص في منعطفات الإدراك والبصيرة، في سعي حلولي لتجاوز القائم والمتعارف عليه، إن على صعيد الشكل، أو الإدراك، أو المفاهيم.”
الرحلة تجاوزيةٌ هي كما أن التأمّل “تجاوزي”. وقبل أن يقدّم نص المسرحية، يمهّد له الكاتب بهذه الجملة (ص15): “هذه حكاية رجلٍ تبصّر محاوراً وجعله يتفوّه بما كان يستشعر به هو بشكل غامض”. فالمرشد السياحي ليس سوى الحاجّ/المُحتار ذاته. وهذا الأخير هو من وضع في فمه كلّ ما نطق به في حوار تارة، وجدال وسجال طوراً، بينه وبين نفسه. فما قاله المرشد ليس سوى أفكار وتساؤلات وإجابات كانت تخطر للمُحتار، وتعبّر عن الجانب الآخر من شخصيّته وفكره، فتجسّدت أقوالاً في فم المرشد. وهذا ما يقوله المُحتار إثر نهاية الرؤيا الأولى (ص60): “وبشغف ابتكرت محاور، ما بعرف إذا استوحيتو من أبحاثي، استذكرتو من أعماقي. محاور ظريف حدّثتو وخلّيتو يقول حِكم أمثال وعِبَر بشكل غامض كانت ببالي عم تجول”.
فالرحلة داخلية، والحوار كذلك. وكلّ الحركة هي مجرّد عمل استبطاني يغوص فيه المُحتار داخل ذاته: “ما بتحرّك من بيتي، ببقى ساكن، واثق…وناطر يحضر عليّي الجواب بدون ما أقهر نفسي” (ص36). والمعرفة الحقيقية هي التي تنبع من الداخل. ويعبّر عن كلّ ذلك النشيد الأول في المسرحية (ص22): “إنتَ الواقف عَ بابك وقلبك محتار عاجز تحسم خيارك وتغادر هالدّار وفّر تعب ع حالك ليش هالمشوار بيكفي تسكن خيالك وبقصد جبّار تبحث بعمق ذاتك بنبع الأفكار الدنيه بتركع قدّامك ما عندها خيار إلا تكشف أمامك كلّ الأسرار”.
يستخدم الشاعر هنا تعابير التأمل التجاوزي ومصطلحاته عينها: نبع الأفكار عبارة مفتاحية في تقنية التأمل، وتعني حالة الوعي الصافي، قعر المحيط الساكن تماماً، والذي منه تنبع كلّ الأفكار. ومن يصل إلى هذه الحالة، وهي الحالة الرابعة من الوعي: أي الحالة التي تلي الحالات الثلاث المألوفة: النوم، والحلم، واليقظة، وتتجاوزها كلّها في آن. ومن يخبر هذه الحالة الرابعة يصل إلى المعرفة الكلّية، ولا يحتاج بعدها أن يسعى إلى أي معرفة في الخارج. وفي الكيتا (4/54): {حقّاً ما من شيء يطهّر في هذا العالم كالمعرفة. ومن بلغ كماله في اليوغا يجد المعرفة في ذاته، من تلقاء نفسه، على مرّ الزمان}.
وهذا ما حصل تحديداً للمُحتار في تأمّله وتبصّره، فلم يعد من جدوى ولا ضرورة إثر ذلك لا للسفر، ولا حتى للدخول في حرم الضريح! وهذا ما يقوله الكاتب على طريقته، ويضعه على لسان المرشد (ص35): “المعرفة معرفة الكائن الساكن بالأعماق، والباقي وهم عابر”. وهنا يستحضر تحديداً مقولة الأدفيتا فيدانتا أن كلّ ما قبل الاستنارة وهمٌ يستيقظ المتحقّق منه كمن يخرج من حلم. وفي الكيتا (2/52): {عندما يتخطّى عقلك ضباب الوهم تصير غير مبالٍ بما سمعتَ، أو ما ستسمع}. وهذا كلّه يقوله الكاتب لاحقاً على لسان المرشد (ص58): “لمّن بتوصل للجوهر، الوهم هو الّي واقع تحت النظر”.
وفي النشيد الأخير (ص60): “ريّح فكرك من جفاف النصوص، إعفي نفسك من ضجيج الطقوس، مارس بالوحدة الصفاء الذهني، بتدخل برحاب العقل الكوني وبتفهم إنّو اللي شاغل بالك ساكن وناطر تذكرو بذاتك” لكأن الشاعر يردّد على طريقته وبأسلوبه الغنائي آية الكيتا (2/46): {كلّ ما في النصوص المقدّسة عقيم لعارف برهمن [المطلق] عقم بئر في أرض تغمرها المياه}
فمن خبِر الوعي الصافي لا حاجة له إلى النصوص، فقد بلغ المعرفةالحقّة، المعرفة الاختبارية الاستبصارية، وتخطّى درجات المعرفة الأولى ومستوياتها: الاكتسابية والتفكّرية! وفي ذلك يقول المُحتار (ص61): “عم اتساءل إذا الإنسان بوعيو بعض الأحيان قادر عبر الطريقة يتجاوز حدّ الظاهر، ويستذكر الحقيقة”. وهي الحالة التي سبق للمرشد للتوّ أن عبّر عنها كما يلي (ص59): “بحاول اتجاوز الكلمة…الشكل ، اللون…واختبر بنفسي الحالي اللي بتوحّد الإنسان بالكون” إنها تعابير التأمّل التجاوزي ومصطلحاته إيّاها: تجاوز الأفكار والكلمات، وتجاوز المانترا أو الآلة الفكرية، لاختبار الوعي الصافي، المطلق الكامن في الداخل، كما {ملكوت الله في داخلكم} (لوقا 17/22)، فتتوحّد الذات الفردية الأتمان، بالذات الكلّية البرهمن. المعرفة مبنية في الوعي تقول آية الريك ڤيدا الآنفة الذكر، والمُحتار بلغ أسمى درجاتها: المعرفة الاختباريّة الاستبصاريّة.
وما هذا سوى محاولة وخطوة تمهيدية لدرس النصّ الجلاليّ وتحليله على ضوء المؤثرات الهندية، والمقولات اليوغية التي غرف منها، وسبر أغوارها تفكّراً وتبصّرا واختباراً. فصارت جزءاً من جلال خوري الإنسان والمبدع، وصار هو جزءاً منها لا يتجزّأ.
وننهي بكلمة لجلال ختم بها برنامج خوابي الزمن السالف الذكر: “الدنيا بألف خير. وأنا مؤمن أن الإنسانية ماضية نحو العصر الذهبي. وما نراه اليوم من مآسي ليس سوى آلام المخاض الذي يسبق الولادة. أنا متفائل، وأعتذر لأني متفائل.”
ومثلك أيها المبدع اليوغيّ المسرحيّ…سنبقى متفائلين، وكما يقول المثل الشعبي، وتؤكّده تعاليم اليوغا: “تفاءلوا بالخير تجدوه”!
 دار بيبليون
دار بيبليون
